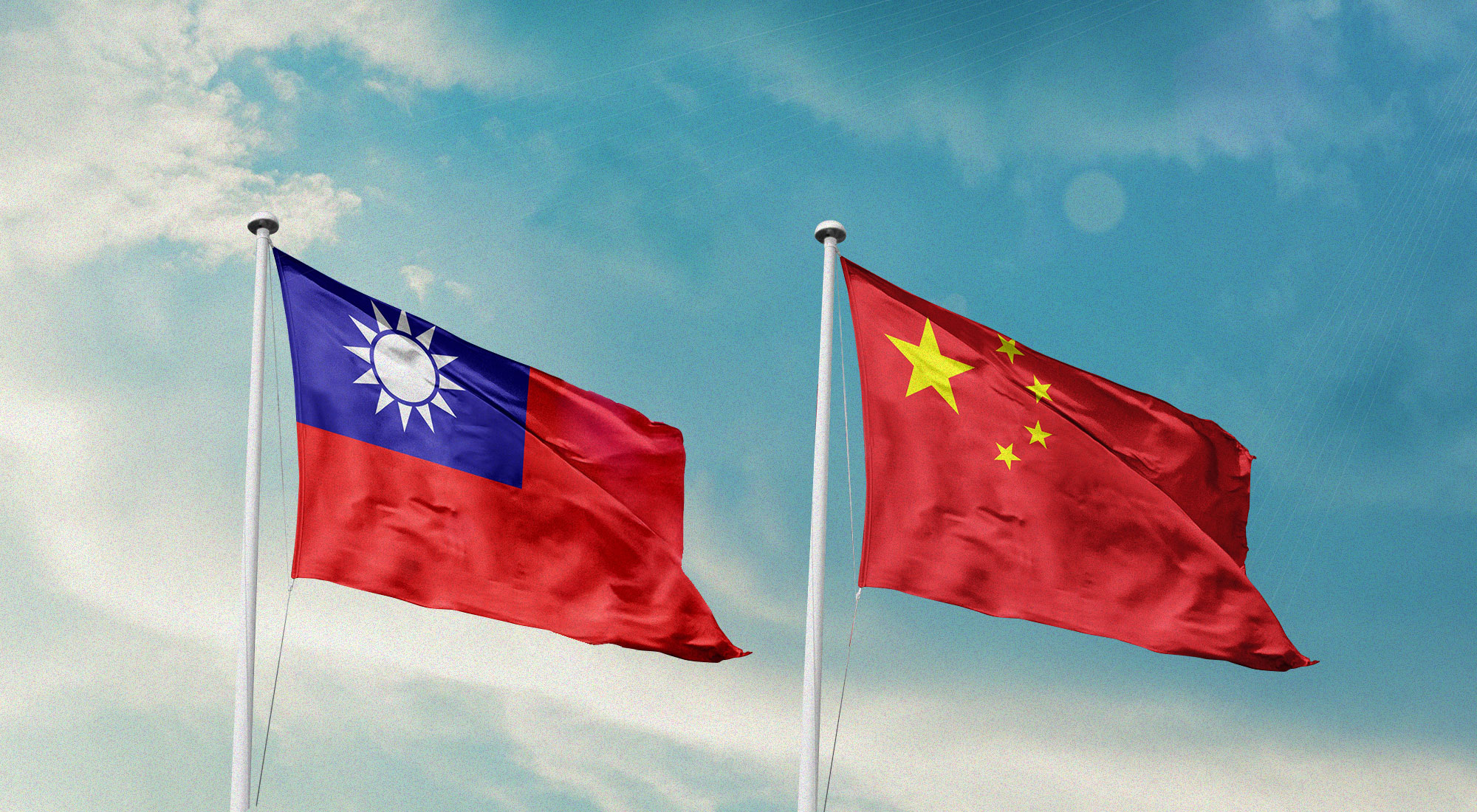أولًا: المقدمة:
يمثل النزاع الصيني–التايواني، الممتد منذ عام 1949، إحدى أكثر بؤر التوتر حساسية في النظام الدولي؛ إذ يتجاوز كونه صراعًا على السيادة بين طرفين ليتحول إلى اختبار استراتيجي لقدرة العالم على إدارة التوازن بين القوى الكبرى. فبعد انتصار الحزب الشيوعي، بقيادة ماو تسي تونغ، في الحرب الأهلية، وانسحاب القوميين، بقيادة تشيانغ كاي شيك، إلى جزيرة تايوان، ظل الطرفان في حالة مواجهة سياسية وعسكرية، حيث تعدّ بكين الجزيرة “مقاطعة انفصالية” وإعادتها “مهمة تاريخية” لا غنى عنها لـ”تجديد شباب الأمة الصينية”،[1] بينما ترى تايوان نفسها دولة ذات سيادة، ودستور منتخب، وقوات مسلحة تقدر بـ300 ألف جندي، واقتصاد تكنولوجي متقدم يجعلها ركيزة حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.
وبرغم أن الأمم المتحدة حولت اعترافها الرسمي من تايبيه إلى بكين عام 1971، لتتقلص الدول التي تعترف بها إلى نحو 15 فقط، فإن معظم القوى الكبرى تتبنى سياسة “الغموض الاستراتيجي”، محافِظةً على علاقات غير رسمية مع الجزيرة، ودعمها في مجالَي الدفاع والتكنولوجيا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي صعّدت مستوى الدعم العسكري والسياسي، خاصة بعد زيارة نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس 2022؛ ما أثار ردًّا صينيًّا قويًّا بمناورات عسكرية تحاكي حصار الجزيرة.
تكتسب تايوان أهميتها الاستراتيجية من موقعها على مضيق يفصلها عن البرّ الصيني، ومن كونها منتجًا رئيسيًّا لأشباه الموصلات؛ ما يجعلها عنصرًا محوريًّا في الاقتصاد العالمي. لكن هذه الأهمية الاقتصادية تتداخل مع أبعاد جيوسياسية أكبر، إذ يتزامن التصعيد الصيني مع احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين في آسيا والمحيط الهادي، ومع أزمات أخرى، مثل الحرب في أوكرانيا، وتصاعد النزاعات في بحر الصين الجنوبي، وسباق التسلح التكنولوجي؛ ما يرفع من احتمالات تداخل ساحات الصراع وتحولها إلى مواجهات أوسع.
تهدف هذه الورقة إلى تحليل دوافع التصعيد الصيني تجاه تايوان في ضوء هذه التوترات العالمية، وفهم العوامل الداخلية والخارجية التي تدفع بكين إلى التشدد في خطابها وإجراءاتها، مع استعراض السيناريوهات المحتملة لمسارات المواجهة، سواء عبر إعادة التوحيد السلمي، أو التصعيد العسكري المباشر، أو الحروب الاقتصادية والدبلوماسية غير المباشرة، أو الإبقاء على الوضع الراهن كحل مؤقت. كما تسعى إلى ربط هذا الملف بموازين القوى الدولية، وتوضيح كيف يمكن أن يؤثر مساره في الأمن والاقتصاد العالميين خلال العقد المقبل.
ثانيًا: فهم التوترات بين الصين وتايوان:
يعود النزاع الصيني–التايواني إلى عام 1949، حين انسحبت حكومة حزب الكومينتانغ القومية إلى جزيرة تايوان بعد هزيمتها أمام الشيوعيين في الحرب الأهلية الصينية؛ ما أوجد حالة انقسام سياسي وإقليمي لم تُحسم حتى اليوم. فمنذ ذلك التاريخ، تعتبر بكين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وتتعامل مع أي محاولة لاستقلالها الكامل بوصفها تهديدًا لسيادتها ووحدتها الوطنية، فيما تتمسك تايبيه بهويتها السياسية المستقلة ونظامها الديمقراطي، الذي يعد من أكثر أنظمة آسيا استقرارًا وتعددية.
في السياق الراهن، تكتسب تايوان أهمية جيوسياسية واقتصادية فائقة؛ فهي ليست مجرد جزيرة، بل مركز حيوي في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في صناعة أشباه الموصلات التي تعتمد عليها صناعات استراتيجية من الهواتف الذكية إلى المعدات العسكرية. كما أن موقعها في قلب منطقة المحيطين الهندي والهادي يجعلها عقدة استراتيجية لطرق التجارة البحرية وخطوط الاتصال العالمية؛ ما يضعها في صلب التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين.[2]
تتجلى حساسية الملف في الدعم الأمريكي المتنامي لتايوان، سواء عبر صفقات تسليح متقدمة، أو تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، مقابل التحركات العسكرية الصينية الكثيفة حول الجزيرة، من طلعات جوية واختراقات متكررة لمنطقة الدفاع الجوي، إلى مناورات بحرية تحاكي فرض حصار شامل. وقد أسهمت التصريحات الأمريكية، التي تؤكد “الالتزام الثابت” بأمن تايوان، إلى جانب استراتيجية بكين القائمة على الضغط المستمر دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في رفع حدة التوتر الإقليمي والدولي على حد سواء.
وبذلك، تحوّل مضيق تايوان إلى إحدى أكثر بؤر الصراع حساسية في النظام العالمي المعاصر، حيث تتداخل فيه اعتبارات السيادة الوطنية مع صراع النفوذ بين القوى الكبرى، ويصبح أي تصعيد -حتى لو كان محدودًا– قادرًا على إحداث تداعيات اقتصادية وأمنية عالمية، بما يعيد رسم ملامح ميزان القوى في آسيا والمحيط الهادي. [3]
ثالثًا: دوافع التصعيد الصيني
1. الدوافع السياسية:
أولًا – تعزيز شرعية الحزب الشيوعي داخليًّا
تعد قضية تايوان أداة سياسية مركزية للحزب الشيوعي الصيني في ترسيخ شرعيته أمام الشعب، خصوصًا في ظل ما تشهده البلاد من تباطؤ اقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وتصاعد الانتقادات الدولية لسياساته. من خلال التركيز على “الوحدة الوطنية” و”استعادة الأراضي المفقودة”، يصور الحزب نفسه حاميًا لمصالح الأمة، وقادرًا على مواجهة التحديات الخارجية. كما يسمح هذا الخطاب بتحويل الانتباه من الأزمات الداخلية إلى التهديدات الخارجية؛ ما يخلق حالة تعبئة وطنية تعزز من تماسك المجتمع، وتضع أي معارضة داخلية في موقف دفاعي، باعتبارها معارضة للأهداف الوطنية الكبرى.
ثانيًا– رفض النزعات الانفصالية و”إجماع 1992“
يمثل “إجماع 1992” -القائل بوجود صين واحدة مع اختلاف في تفسيرها- مرجعية أساسية لموقف بكين من تايوان.[4] ومع رفض الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايبيه لهذا الإجماع، وقيادته توجهات لتعزيز هوية سياسية مستقلة، ترى بكين في ذلك تهديدًا وجوديًّا للأمن القومي الصيني. إن نجاح تايوان في تكريس استقلالها الفعلي، حتى دون إعلان رسمي، قد يشجع مناطق أخرى ذات نزعات انفصالية، مثل هونغ كونغ أو التبت أو شينجيانغ، على اتخاذ خطوات مشابهة. لذلك، تعتمد الصين على مزيج من الضغوط الاقتصادية، والعزلة الدبلوماسية، والتحركات العسكرية المتصاعدة؛ لمنع هذا السيناريو والحفاظ على وحدة أراضيها.
ثالثًا– توحيد الداخل وصرف النظر عن الأزمات
توفر قضية تايوان لبكين فرصة لتوحيد الصفوف الداخلية، وتخفيف حدة الانقسامات السياسية والاجتماعية. ففي أوقات الأزمات الاقتصادية، أو الاحتجاجات الشعبية، تصبح “استعادة تايوان” رمزًا للقومية الصينية، وأداة لإعادة توجيه النقاش العام نحو “التهديدات الخارجية” بدلًا من التركيز على الأوضاع المعيشية أو الحقوق المدنية. كما يتيح هذا الملف للحزب الشيوعي التحكم في الإيقاع الإعلامي والسياسي داخل البلاد، عبر ضخ روايات وطنية ترفع الروح المعنوية، وتعيد إنتاج مشاعر الفخر القومي. بهذه الطريقة، يتحول التصعيد تجاه تايوان إلى وسيلة لتعزيز السيطرة السياسية والالتفاف الشعبي حول القيادة المركزية[5].
الدوافع العسكرية:
أولًا– تحديث الجيش الصيني وتكثيف التدريبات حول الجزيرة
شهد الجيش الصيني، خلال العقد الأخير، عملية تحديث واسعة النطاق شملت تطوير قدراته البرمائية، وتزويده بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وتعزيز أسطولَيه البحري والجوي. وركزت بكين على إعداد قوات قادرة على تنفيذ عمليات مشتركة ضد تايوان، بما في ذلك إنزال بحري واسع النطاق وفرض حصار جوي–بحري. وقد انعكس ذلك في الزيادة الهائلة لعدد التوغلات في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، من أقل من 100 اختراق عام 2016 إلى أكثر من 1700 في عام 2023، إضافة إلى تدريبات شاملة تحاكي سيناريوهات غزو وحصار؛ ما يبعث رسالة واضحة، مفادها جاهزية الصين لعمل عسكري، إذا لزم الأمر.[6]
ثانيًا – عسكرة بحر الصين الجنوبي والشرقي
تنتهج الصين سياسة متصاعدة لعسكرة البحار المحيطة بها، خاصة بحر الصين الجنوبي والشرقي، باعتبارهما ساحات استراتيجية لردع التحركات التايوانية والأمريكية. وإلى جانب قواتها النظامية، تستخدم بكين ميليشيات بحرية تعرف باسم “الرجال الزرق الصغار”، وهي سفن صيد مدنية مسلحة تُستخدم لمضايقة السفن التايوانية، وإرباك عملياتها البحرية. كما عززت وجودها في الجزر والشعاب المرجانية عبر بناء قواعد عسكرية ونشر أنظمة دفاعية متطورة؛ ما يمنحها قدرة أكبر على مراقبة الطرق البحرية، وخنق خطوط الإمداد إلى تايوان في أي مواجهة محتملة، فضلًا عن توسيع نفوذها البحري الإقليمي.[7]
2. الدوافع الاقتصادية والتكنولوجية
أولًا: أهمية تايوان في سلسلة التوريد العالمية خاصة أشباه الموصلات تلعب تايوان دورًا محوريًّا في الاقتصاد العالمي من خلال سيطرتها على صناعة أشباه الموصلات، التي تُعد العمود الفقري لمعظم الابتكارات التكنولوجية المعاصرة، بدءًا من الهواتف الذكية والحواسيب، مرورًا بالسيارات الكهربائية، وصولًا إلى الأنظمة العسكرية المتقدمة. وتُعد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) أكبر مصنع في العالم من نوع foundry، حيث تنتج ما يزيد على 60% من أشباه الموصلات المتطورة عالميًّا. هذا التفوق التايواني يضعها في قلب شبكة الإمداد العالمية ويجعلها لاعبًا لا غنى عنه في الاقتصاد الرقمي الحديث. وتعتمد الصين نفسها على واردات ضخمة من هذه الرقائق لتغذية صناعاتها، سواء في الإلكترونيات الاستهلاكية، أو في البنية التحتية التكنولوجية. لكن هذه الأهمية تُشكل سيفًا ذا حدين: فمن جهة، تجعل السيطرة على تايوان هدفًا استراتيجيًّا للصين لتعزيز الاكتفاء الذاتي. ومن جهة أخرى، تجعل أي نزاع مسلح محفوفًا بمخاطر اقتصادية عالمية، إذ سيؤدي تعطل الإنتاج إلى شلل في قطاعات حيوية على مستوى العالم.
ثانيًا: رغبة الصين في السيطرة على الموارد التكنولوجية والقدرات التصنيعية المتقدمة لا تقتصر القيمة الاستراتيجية لتايوان على مواردها المادية، بل تمتد لتشمل منظومتها المعرفية والبشرية العالية الكفاءة، حيث تمتلك الجزيرة قاعدة علمية وصناعية متقدمة تشمل مراكز بحث وتطوير، وخبرات هندسية متخصصة في مجالات الإلكترونيات الدقيقة، وتصميم المعالجات، وأنظمة التصنيع الآلي. بالنسبة للصين، فإن ضم تايوان أو فرض السيطرة عليها سيعني دمج هذه القدرات مباشرة في منظومتها الصناعية؛ وهو ما يعزز من مكانتها في سلاسل القيمة العالمية، ويمكّنها من تقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية، خصوصًا في ظل القيود والحظر التكنولوجي الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها. كما سيتيح للصين القفز خطوات واسعة في سباق الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة والتطبيقات العسكرية العالية التقنية، وهو ما يمنحها تفوقًا استراتيجيًّا في مواجهة القوى المنافسة.
ثالثًا: الأهمية الجيو-اقتصادية لموقع تايوان في تأمين طرق التجارة البحرية وحماية المصالح الصينية في المحيط الهادي
تتمتع تايوان بموقع جغرافي بالغ الحساسية عند تقاطع طرق التجارة البحرية الرئيسية في غرب المحيط الهادي، إذ تقع على ما يُعرف بـ”سلسلة الجزر الأولى”، وهي خط دفاع بحري يمتد من اليابان، مرورًا بتايوان، وصولًا إلى الفلبين. تمنح السيطرة على تايوان الصين قدرة أكبر على مراقبة وتأمين طرق الشحن التي تمر عبر بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، وهما من أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، حيث تمر عبرهما سلع وخامات أساسية، مثل النفط والغاز والمنتجات الصناعية. ومن منظور استراتيجي، فإن بسط النفوذ على تايوان سيعزز من قدرة الصين على حماية مصالحها الاقتصادية في مواجهة النفوذين الأمريكي والياباني، ويوفر لها منصة متقدمة لردع أي تحركات عسكرية أو اقتصادية مضادة في المنطقة. إن هذا البعد الجيو-اقتصادي يجعل من تايوان ليست مجرد قضية “وطنية” بالنسبة لبكين، بل ورقة حاسمة في إعادة تشكيل ميزان القوى في المحيط الهادي.
رابعًا: التفاعلات الدولية
موقف الولايات المتحدة:
تُعد الولايات المتحدة لاعبًا محوريًّا في ملف تايوان، حيث تتبنى سياسة “الغموض الاستراتيجي” التي تعترف بمبدأ “الصين الواحدة” من دون الاعتراف رسميًّا بسيادة بكين على الجزيرة. وفي الوقت ذاته، تعارض إعلان استقلال تايوان رسميًّا. تمنح هذه المقاربة واشنطن هامشًا واسعًا لدعم تايوان سياسيًّا وعسكريًّا من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع الصين.
يتجسد هذا الدعم في صفقات الأسلحة المتطورة وتعميق التعاون الأمني، خاصة خلال السنوات الأخيرة، إذ شهدت السياسة الأمريكية بعض التحولات الملحوظة، مثل إزالة عبارة “عدم دعم استقلال تايوان” من وثائق وزارة الخارجية في عهد إدارة ترامب، وهو ما عكس استعدادًا أكبر لاستخدام الملف كورقة ضغط استراتيجية.
العلاقات الأمريكية–الصينية حول تايوان تتسم بحساسية فائقة، إذ تحرص واشنطن على لعب دور الوسيط الحذر؛ فهي تدعو تايوان إلى تجنب الخطوات الاستفزازية نحو الاستقلال، وفي الوقت ذاته ترد على التصعيد العسكري الصيني بتعزيز دعمها للجزيرة. ومن المرجح أن يتأثر الموقف الأمريكي بمسار المفاوضات التجارية مع بكين، فقد تتجه واشنطن لتخفيف التزاماتها إذا تحقق تقدم في هذه المفاوضات، أو تستخدم “ورقة تايوان” للضغط في حال تعثرها.
وفي إطار السعي لاحتواء التوتر، قد تعود الولايات المتحدة إلى نهج سابق يقوم على مراقبة تحركات تايوان والتنسيق مع الصين، بما يعكس رغبتها في الحفاظ على توازن دقيق بين دعم تايبيه وضمان استقرار علاقاتها مع بكين.[8]
موقف الصين:
تتمسك جمهورية الصين الشعبية برفض قاطع لأي تدخل خارجي في قضية تايوان، معتبرة إياها شأنًا داخليًا بحتًا لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه. وترى بكين أن أي محاولة من الولايات المتحدة أو القوى الغربية للتأثير في مسار القضية تمثل انتهاكًا مباشرًا لسيادتها ووحدة أراضيها. وانطلاقًا من هذا الموقف، تعمل الصين على تكريس نفوذها على تايوان عبر مزيج من الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية، مستندة بالأساس إلى مبدأ “الصين الواحدة” الذي تصوره باعتباره معيارًا مقبولًا دوليًّا يفرض الاعتراف بتايوان كجزء أصيل من أراضيها.
تعتمد بكين على هذا المبدأ لتأكيد أن القانون الدولي لا ينطبق على تايوان ككيان مستقل، بل باعتبارها إقليمًا تابعًا لجمهورية الصين الشعبية، وهو ما يبرر – من وجهة نظرها – استبعاد القضية من أي أطر للنقاش الدولي. وقد نجحت هذه السياسة في تحقيق اختراقات ملموسة، إذ تمكنت الصين من كسب اعتراف دولي واسع بمبدأ “الصين الواحدة”، ما أدى إلى تقليص حضور تايوان على الساحة الدولية وحرمانها من عضوية منظمات دولية رئيسية، فضلًا عن تقليص عدد حلفائها الدبلوماسيين.
من منظور بكين، فإن زيادة عزلة تايوان دوليًّا تُضعف قدرتها على المقاومة وتدفعها تدريجيًّا نحو إعادة الاندماج مع البر الرئيسي. ولتحقيق ذلك، تبذل الصين جهودًا حثيثة لمنع أي اعتراف رسمي أو دعم سياسي للجزيرة من قبل الدول والمنظمات الدولية. وفي هذا الإطار، توجه بكين تحذيرات متكررة، خاصة إلى الولايات المتحدة، التي تواصل تزويد تايوان بالدعم العسكري والدبلوماسي. وترى الصين أن أي خطوة للاعتراف الرسمي أو تقديم الدعم العلني لتايوان تمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ “الصين الواحدة” وتجاوزًا لخطوطها الحمراء.
تعكس هذه المقاربة ثقة متزايدة من جانب الصين في قدرتها على فرض رؤيتها داخل النظام الدولي؛ خصوصًا مع ما تعدّه تراجعًا نسبيًّا في النفوذ الأمريكي. وقد أسهم ذلك في تصعيد التوترات في مضيق تايوان، وجعل القضية محورًا أساسيًّا في ديناميات التنافس بين القوتين العظميين في آسيا والمحيط الهادي.[9]
مواقف الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة
بدأ الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بتعزيز موقفه تجاه تايوان عبر سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي تحمل طابع الدعم الحذر. فقد شهد أكتوبر 2019 زيارات لمسؤولين تايوانيين إلى عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد، في خطوة تعكس مساندة مبدئية للجزيرة من دون الانخراط في استفزاز مباشر للصين. ومن الأمثلة البارزة على ذلك توقيع مذكرات تفاهم في العاصمة التشيكية براغ بين تايوان ودول أوروبية في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني والتكنولوجيا الخضراء، إلى جانب عقد لقاءات غير رسمية مع صانعي القرار في بروكسل.
كما اتخذت بعض الدول الأوروبية مواقف أكثر انفتاحًا، مثل ليتوانيا التي سمحت لتايوان بإنشاء مكتب تمثيل رسمي باستخدام اسمها الكامل، في تجاوز للمسمى التقليدي “مكتب تمثيل تايبيه”. هذه الخطوة أثارت ردود فعل حادة من بكين، لكنها عكست توجهًا متناميًا داخل الاتحاد لدعم تايوان في إطار دبلوماسي متحفظ يوازن بين تعزيز الروابط مع الجزيرة وتجنب التصعيد المباشر مع الصين. (Benner, 2021)
دور المنظمات الدولية:
تعيش تايوان في وضع فريد ومعقد داخل النظام الدولي، فهي جهة فاعلة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى، لكنها محرومة من التمثيل في معظم المنظمات الدولية نتيجة الضغوط التي تمارسها الصين. وقد نجحت بكين في تكريس هذا الإقصاء عبر استخدام نفوذها الدبلوماسي لإجهاض أي محاولة لضم تايوان كعضو كامل أو حتى كمراقب في هذه المنظمات، الأمر الذي أسفر أيضًا عن فقدان الجزيرة لعدد من حلفائها الدبلوماسيين على مدى السنوات الماضية.
هذا الوضع يعكس صراعًا مفتوحًا على الشرعية الدولية بين بكين وتايبيه، إذ تسعى الصين إلى تثبيت مبدأ “الصين الواحدة” كإطار قانوني وسياسي ملزم، بينما تجد تايوان نفسها مقيدة بغياب الاعتراف الرسمي بها كدولة ذات سيادة. ويزيد من تعقيد المشهد أن القانون الدولي لم ينجح في توفير إطار واضح يتيح مشاركة تايوان بصفة مراقب أو كيان مستقل، ما يكرّس حالة من الغموض القانوني حول وضعها. هذا الغموض لا يقتصر على البعد القانوني فحسب، بل يمتد ليشكل تحديًا سياسيًّا واستراتيجيًّا، إذ يضع تايوان في موقع استثنائي داخل النظام الدولي، حيث الاعتراف الضمني بأهميتها يقابله إقصاء رسمي من مؤسساته.[10]
خامسًا: سيناريوهات المواجهة المستقبلية
برغم تصاعد حدة الخطاب السياسي والعسكري بين الصين وتايوان في السنوات الأخيرة، لا يزال سيناريو استمرار الوضع القائم (Status Quo) هو الأرجح في المدى القريب؛ حيث تفضل الأطراف الرئيسية، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة، تجنّب الانزلاق إلى مواجهة مباشرة قد تُشعل صراعًا إقليميًّا أو حتى عالميًّا. ومع ذلك، فإن استدامة الوضع القائم تبقى هشّة؛ ولاسيما في ظل تنامي النزعة القومية داخل الصين، والدعم الغربي المتزايد لتايوان، والتغيرات المتسارعة في بنية النظام الدولي.
في هذا السياق، يصبح من الضروري استعراض السيناريوهات المحتملة للمواجهة المستقبلية بين الصين وتايوان، وفهم الدوافع الكامنة وراء التصعيد، بالإضافة إلى تحليل مسارات التصادم الممكنة، سواء كانت عسكرية، أوسيبرانية، أو اقتصادية، أو دبلوماسية. كما يُطرح التساؤل حول مدى قدرة النظام الدولي على احتواء هذه الأزمة، ومدى استعداد الأطراف المعنية للتعايش مع واقع قد يتحول في أية لحظة من توتر محسوب إلى صراع مفتوح.
السيناريو الأول: ضم الصين لحدود تايوان
يقوم هذا السيناريو على إقدام الصين على استعراض قوتها ميدانيًّا عبر ضم إحدى الجزر البحرية الواقعة تحت سيطرة تايوان، كخطوة تدريجية لاختبار ردود الفعل الإقليمية والدولية قبل أي تحرك أوسع ضد الجزيرة الرئيسية. وتبرز أمام بكين أربعة خيارات رئيسية:
- جزيرة تايبينغ : (Taiping) تقع ضمن مجموعة جزر سبراتلي (Spratly Group) في بحر الصين الجنوبي، وتتميز بموقعها المتوسط بين جنوب فيتنام والفلبين. وبرغم بعدها الجغرافي عن تايوان وقربها من مناطق النزاع البحري الإقليمي، فإن السيطرة عليها تمنح بكين موطئ قدم إضافي في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، لكنها قد تثير اعتراضات دولية واسعة بسبب النزاعات المتعددة في المنطقة.
- جزر براتاس (Pratas) أو دونغشا (Dongsha): تقع في موقع أقرب جغرافيًّا لكل من الصين وتايوان، وتمثل أهمية استراتيجية خاصة لبكين نظرًا إلى قربها من منافذها على المحيط الهادي. وبرغم كونها غير مأهولة بالسكان الدائمين، فإن تايوان نشرت منذ أغسطس 2020 مئات الجنود هناك لتعزيز الدفاع عنها؛ وخاصة بعد تزايد النشاط العسكري الصيني المتمثل في الطلعات الجوية والتدريبات في محيطها.
- جزر بينغهو (Penghu) أو بيسكادوريس (Pescadores): مجموعة جزر تقع إلى الجنوب الغربي من تايوان، وتمثّل موقعًا مهمًّا في حال أرادت الصين تعزيز سيطرتها على الممرات البحرية المؤدية إلى الجزيرة الرئيسية، لكن السيطرة عليها قد تُعدّ خطوة تصعيدية كبيرة بالنظر إلى قربها من قلب الأراضي التايوانية.
- جزيرة كينمن (Kinmen): تقع على مقربة مباشرة من السواحل الصينية، مقابل مدينتي شيامن (Xiamen) وماتسو (Matsu)، ما يجعلها هدفًا سهل الوصول نسبيًّا، لكن الاستيلاء عليها قد يشعل رد فعل عسكري واسع من تايبيه وحلفائها.
وبرغم أن جزيرة تايبينغ تتميز بأهمية جيوسياسية في بحر الصين الجنوبي، وأن جزر براتاس تخلو من السكان، فإن المعطيات الحالية تشير إلى أن جزر براتاس تمثل الخيار الأكثر إغراءً لبكين إذا قررت اختبار قدرة الدفاعات التايوانية، وذلك بسبب قربها الجغرافي، وضعف التحصين المدني فيها، وأهميتها في الممرات البحرية. ويبدو أن تايبيه تدرك هذا الاحتمال جيدًا، حيث تعمل حاليًّا على تعزيز وجودها العسكري في الجزيرة لردع أي تحرك صيني محتمل.[11]
السيناريو الثاني: فرض الحظر الجوي والبحري على تايوان
يقوم هذا السيناريو على إقدام الصين على فرض سيطرة عملية ومباشرة على المجالين الجوي والبحري لتايوان، بما يحوّل مطار تايبيه الدولي وميناء كاوهسيونغ من بوابتين دوليتين مستقلتين إلى نقاط عبور خاضعة للرقابة الصينية. وفي إطار هذا النهج، يمكن لبكين أن تدير عمليات تفتيش بحرية وجوية على السفن والطائرات المتجهة إلى الجزيرة، أو توجهها إلى موانئ ومطارات صينية قريبة مثل فوتشو (Fuzhou) أو قوانغتشو (Guangzhou) للطائرات، وشيامن (Xiamen) أو شانتو (Shantou) للسفن، لاستكمال إجراءات التخليص الجمركي والفحص الأمني.
تمتلك الصين المقومات اللازمة لتنفيذ هذا السيناريو، إذ تجمع بين قدرات متقدمة في المراقبة الجوية والبحرية، وأساطيل ضخمة من البحرية وخفر السواحل، إضافة إلى ميليشيات بحرية يمكن توظيفها في عمليات الحصار والاعتراض. وقد عززت بكين الإطار القانوني لهذه السياسة عبر إقرار قانون خفر السواحل الجديد في 22 يناير 2021، الذي يمنح السلطات الصينية الحق في استخدام “جميع الوسائل الضرورية” ضد السفن الأجنبية، بما في ذلك الصعود على متنها وتفتيشها في المياه التي تطالب الصين بالسيادة عليها، فضلًا عن إنشاء مناطق حظر مؤقتة “عند الحاجة” لمنع دخول السفن الأخرى.[12]
وتستند بكين في تبرير هذا الإجراء إلى حجتين رئيسيتين:
- ترسيخ السيادة: ترى الصين أن فرض الحظر البحري والجوي يكرس سيادتها على تايوان، وخاصة أن أغلب دول العالم تعترف بمبدأ “الصين الواحدة”، ما يمنحها – من وجهة نظرها – شرعية قانونية وسياسية لتنفيذ هذا الإجراء، مع الإبقاء مؤقتًا على إدارة تايوان لشؤونها الداخلية.
- الرد على التهديدات الأمنية: ترى بكين أن هذه الخطوة تمثل ردًّا مشروعًا على ما تصفه بالتحركات الاستفزازية من جانب تايوان وحلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، من خلال صفقات الأسلحة والتعاون الدفاعي الذي ترى فيه تهديدًا مباشرًا لقدراتها العسكرية ومصالحها التجارية.
بهذا، يجمع هذا السيناريو بين الضغط العسكري والاقتصادي والدبلوماسي، مع محاولة صوغه في إطار “إجراء سيادي” مشروع وفق الرؤية الصينية، ما يجعله خيارًا أقل حدة من الغزو المباشر لكنه أكثر فاعلية في فرض أمر واقع جديد على الجزيرة.
السيناريو الثالث: الضم الكامل لتايوان
يتمثل هذا السيناريو في إقدام الصين على تنفيذ عملية شاملة لضم تايوان بالكامل، عبر أحد مسارين رئيسيين:
المسار الأول – الحصار والهجوم البرمائي الواسع: يبدأ بفرض حصار تقليدي على الجزيرة لشلّ خطوط الإمداد وقطع التواصل الخارجي، يعقبه هجوم برمائي واسع النطاق مدعوم بعمليات إنزال بحري، يستهدف ما يقارب اثنتي عشرة منطقة ساحلية في الشمال والغرب، وهي المناطق الأقرب إلى مضيق تايوان والمشرفة عليه. يعتمد هذا المسار على توظيف أسطول متكامل من السفن العسكرية، مع دعم جوي لتأمين عمليات الإنزال والسيطرة على الشواطئ.
المسار الثاني – الهجوم السريع والمباغت: يقوم على تنفيذ ضربات عالية الكثافة والسرعة باستخدام طائرات الهليكوبتر، مدعومة بقوات خاصة تنفذ عمليات نوعية للسيطرة على مواقع استراتيجية ومنشآت حيوية، على غرار التكتيكات الألمانية في الهجوم على النرويج (أبريل 1940) وجزيرة كريت (مايو 1941). يهدف هذا المسار إلى حسم الموقف خلال فترة زمنية قصيرة قبل أن تتمكن تايوان أو حلفاؤها من تنظيم رد فعال.
وبرغم ما قد تمنحه هذه الأساليب من عنصر المفاجأة، يرى معظم المحللين العسكريين أن هذا السيناريو محفوف بالمخاطر وصعب التنفيذ. فتايوان تمتلك مزايا دفاعية طبيعية، أبرزها تضاريسها الجبلية المعقدة التي تحد من فاعلية الهجمات البرمائية، إضافة إلى الأحوال الجوية المتقلبة في مضيق تايوان، التي تشكل عائقًا كبيرًا أمام العمليات العسكرية المعقدة في معظم أشهر السنة.
سادسًا: الانعكاسات المحتملة على النظام الدولي
تشير المؤشرات إلى أن اندلاع صراع مسلح بين الصين وتايوان سيكون له تداعيات واسعة النطاق على النظام الدولي، تتجاوز بكثير النطاق الإقليمي في شرق آسيا. فمثل هذا النزاع لا يمثل مجرد خلاف بين دولتين، بل يمثّل اختبارًا حقيقيًا لتوازن القوى العالمي، ويهدد بإعادة تشكيل النظام الدولي سياسيًّا، واقتصاديًّا، وأمنيًّا، بطريقة قد تكون أكثر تأثيرًا من الحرب الروسية–الأوكرانية.
من الناحية الجيواستراتيجية، فإن انخراط قوى كبرى مثل الولايات المتحدة – وربما حلفاء مثل اليابان وأستراليا – في النزاع سيقود إلى تصعيد دولي قد يُقارب في طبيعته الحروب الكبرى، ويعيد مشهد الحرب الباردة بنسخة أكثر تعقيدًا. كما ستمثل أي محاولة لفرض حصار على تايوان، أو السيطرة على مضيق تايوان، تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة العالمية، إذ تمر عبره نحو 50% من حركة التجارة البحرية في المنطقة، وتشمل بضائع إلكترونية وصناعية حيوية لسلاسل الإمداد الدولية.[13]
اقتصاديًّا، ستتأثر أسواق المال، وتتعطل سلاسل الإمداد العالمية؛ وخصوصًا في مجالات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، حيث تُعد تايوان مركزًا عالميًّا لإنتاجها. وسينعكس هذا بشكل كبير على الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، مثل ألمانيا، والولايات المتحدة، ودول جنوب شرق آسيا، بما فيها إندونيسيا، التي تعتمد بدرجة كبيرة على التجارة مع الصين والولايات المتحدة.
كما ستبرز تحديات إنسانية ولوجستية في حال حدوث صراع مفتوح، تشمل حركة النزوح، وإجلاء الجاليات الأجنبية، وتعقيد العمليات الإنسانية. ففي حالة تايوان، يقدر عدد العمال والمواطنين الأجانب فيها بمئات الآلاف، ما يخلق عبئًا إضافيًّا على الدول المعنية في حال اندلاع حرب.
سياسيًّا، سيؤدي التصعيد إلى انقسام حاد في المواقف الدولية، واختبار لمدى التزام حلفاء الولايات المتحدة تجاه استراتيجيتها في المحيطين الهندي والهادي. كما سيفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم أولوياته الاستراتيجية، في ظل التوترات الممتدة من أوروبا الشرقية إلى شرق آسيا.
وبناءً على ما سبق، فإن أي تصعيد في مضيق تايوان لا يمكن اعتباره شأنًا محليًّا أو إقليميًّا فقط، بل هو أزمة ذات طابع دولي بامتياز، قادرة على تغيير معادلات القوة، وإعادة صوغ أولويات الأمن الجماعي، والاقتصاد العالمي، وحتى مستقبل النظام الدولي ذاته.
الخاتمة
تُبرز هذه الدراسة حجم التعقيد الجيوسياسي الذي تمثله التوترات بين الصين وتايوان، بوصفها إحدى أبرز القضايا التي لا تقتصر تداعياتها على شرق آسيا فحسب، بل تمتد لتؤثر في هيكل النظام الدولي بأسره. فالصين تنطلق في تصعيدها من مزيج معقد من الدوافع السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، في إطار سعيها لتأكيد مبدأ “الصين الواحدة” وترسيخ سيادتها الوطنية. في المقابل، تتمسك تايوان بهويتها الديمقراطية ومكانتها كقوة اقتصادية وتكنولوجية فاعلة، ما يجعلها أحرص على الحفاظ على كيانها السياسي واستقلال قرارها السيادي.
وفي ظل بيئة دولية تتسم بالتنافس الحاد وعدم اليقين، يظل مستقبل هذا الصراع مفتوحًا أمام مجموعة من السيناريوهات، تتراوح ما بين التصعيد العسكري المباشر، أو استمرار حالة “الغموض الاستراتيجي” القائمة، أو حتى إمكانية التوصل إلى تسويات سلمية قائمة على تفاهمات دولية وإقليمية أكثر نضجًا. ويزداد المشهد تعقيدًا بفعل التفاوت في مواقف الفاعلين الدوليين؛ خاصة بين الدعم الأمريكي الواضح لتايوان، والمواقف الأوروبية المترددة، وحسابات دول الإقليم.
ختامًا، فإن استقرار هذه الأزمة لا يعتمد على ميزان القوى بين بكين وتايبيه فقط، بل على قدرة المجتمع الدولي على تجنّب الانزلاق نحو صراع مفتوح أيضًا، وتعزيز مسارات الحلول الدبلوماسية التي تراعي مصالح جميع الأطراف.
[1] “شي يدعو لتسريع التطور العسكري والتكنولوجي لـ “تجديد شباب الأمة’”، الشرق الأوسط، 16 أكتوبر 2022 : https://aawsat.com/home/article/3933691/%D8%B4%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9%C2%BB
[2] “مُعضلة الرقاقات الإلكترونية.. لماذا ستدافع واشنطن عن تايوان كأنها ولاية أميركية؟ “الجزيرة نت، 20 أكتوبر 2022.
[3] S. Muhamad, The China-Taiwan Conflict and Its Implications: A Brief Study of Actual and Strategic Issues, INFO Singkat, No. 16, August 2022: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat—16-II-P3DI-Agustus-2022-183-EN.pdf
[4] ما هي سياسة الصين الواحدة؟ بي بي سي عربية، 14 ديسمبر 2016 : https://www.bbc.com/arabic/in-depth-38312654
[5] ¹ Tarik Solmaz, China’s Hybrid Warfare Against Taiwan: Motives, Methods, and Future Trajectory, International Law and Security, 2024.
[6] عبدالرحمن المرسي، “تعرف على خطة الصين لإسقاط تايوان دون رصاصة”، الجزيرة نت، 13 مايو 2025: https://www.aljazeera.net/politics/2025/5/13/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
[7] Tarik Solmaz, China’s Hybrid Warfare Against Taiwan: Motives, Methods, and Future Trajectory, International Law and Security, 2024.
[8] ¹ Z. Du, “US Narratives versus Reality on Taiwan,” E-International Relations, May 13, 2025, https://www.e-ir.info/2025/05/13/us-narratives-versus-reality-on-taiwan/.
[9] D. Campagnola, Understanding the Status Quo between Taiwan and China: International Law, the Power Transition Theory and Case Studies, Taiwan Politics, 2024, https://doi.org/10.58570/001c.124430.
[10] Conflict,” EST – European Student Think Tank, March 25, 2022, https://esthinktank.com/2022/03/25/the-european-unions-position-towards-the-china-taiwan-conflict/.
[11] المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية (ICSS). “جيوسياسية وأمن بحر الصين الجنوبي.. مطالب ونزاعات لا تنتهي” مركز الدراسات الاستراتيجية الدولي22 أغسطس 2023: https://icss.ae/studies/view/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A..-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-
[12] أحمد مرجان، “اليابان تنتقد قانون خفر السواحل الصيني الجديد.” الأناضول (النسخة العربية)، 9 فبراير 2021: https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/2139106
[13] أرقام. “تايوان.. الرقم الذي لا يمكن إغفاله بمشهد الاقتصاد العالمي.” أرقام 15 ديسمبر :2022 https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1609324