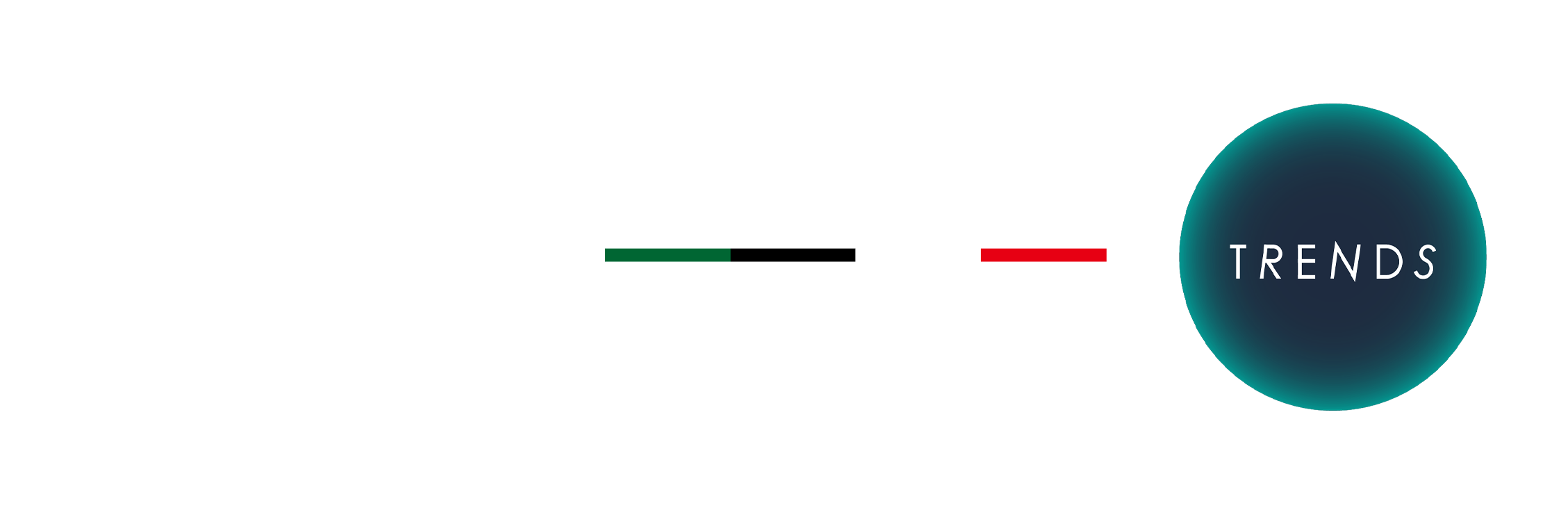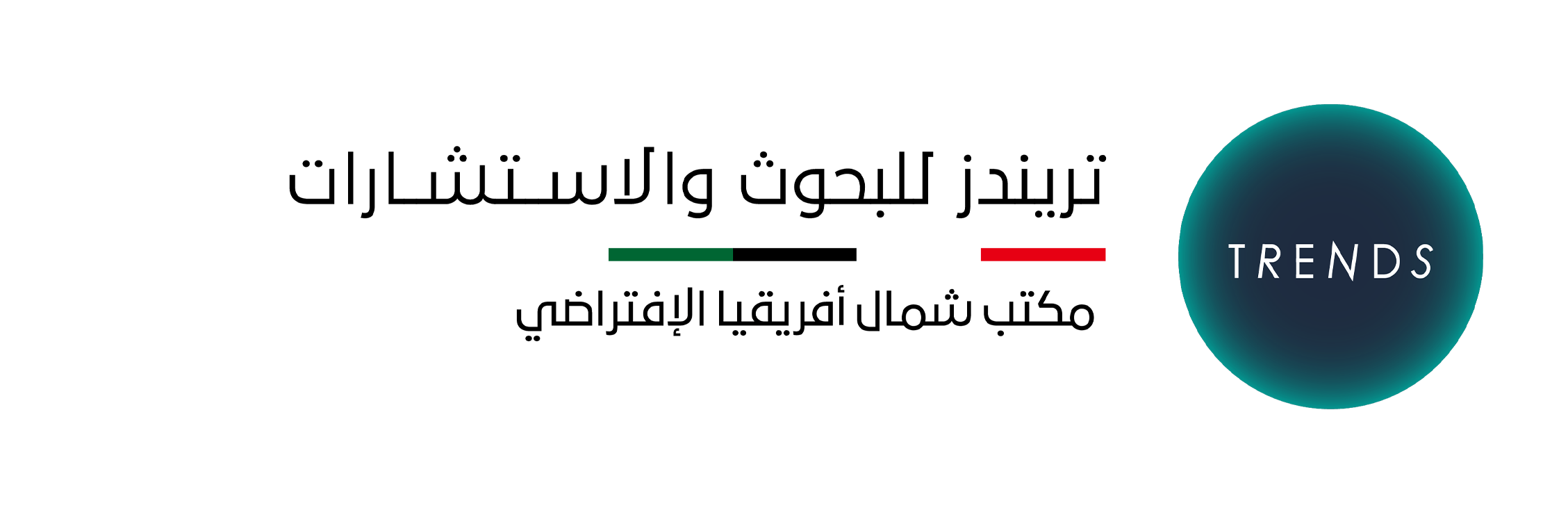في الوقت الذي تتكاثف فيه جهود كثير من دول العالم، على طريق تعبئة الإمكانات وتنسيق المواقف وتعزيز جهود التعاون؛ انسجامًا مع التحولات الدولية الكبرى الراهنة، وبخاصة مع تصاعد حدّة التهديدات العابرة للحدود في أبعادها العسكرية وغير العسكرية، والتحديات الاقتصادية التي تجعل من التكتل وتشبيك المصالح الاقتصادية وإرساء مقاربات جماعية لمواجهة مختلف المخاطر أمرًا ضروريًّا – في الوقت الذي حدث فيه كل ما سبق، مازال الجمود هو سيد الموقف في المنطقة المغاربية التي تعيش على إيقاع هدر الفرص.
وعلى الرغم من المحطات الكبرى التي مرّ بها العالم منذ نهاية الحرب الباردة، سواء تعلق الأمر بتفكّك الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية، واندلاع حرب الخليج الثانية، وما رافق ذلك من توجّه عدد من الدول نحو دمقرطة الحياة السياسية، وإعمال إصلاحات تدعم الانفتاح على الاقتصاد الدولي، إضافة إلى تعزيز خيارات التكتل والتعاون الاقتصادي، ثم تفجُّر أحداث 11 سبتمبر في عام 2001، واندلاع الحراك في عدد من دول المنطقة، وتصاعد الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتردّي النظام الإقليمي العربي بكل مكوناته، وتمدد جائحة كورونا وما خلّفته من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية، وتفجر الحرب الروسية-الأوكرانية، ثم المواجهة العسكرية الإيرانية-الإسرائيلية، وما تلا ذلك من ترتيبات لإعادة النظر في التحالفات والتموقعات بين القوى الدولية الكبرى في سياق السعي للاستئثار بمكانة وازنة في النظام الدولي- برغم كل ما سبق، فإن البلدان المغاربية لم تكن في الموعد، وظلت على هامش كل هذه المتغيرات.
تعد المنطقة المغاربية من الأقاليم الدولية الأقل ارتباطًا تجاريًّا واقتصاديًّا، رغم الإمكانات البشرية والتاريخية والحضارية والطبيعية والجغرافية المتوافرة، وهي بذلك لم تستفد من مختلف هذه المقومات التي تجسّد في مجملها مشتركًا ثريًّا، تم تحويله من فرص إلى خلافات، على عكس دول أخرى استطاعت أن تحوّل صراعاتها إلى فرص حقيقية تخدم التنمية والممارسات الديمقراطية، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من البلدان الأوروبية.
ثمة كثير من الأسئلة التي تفرض نفسها في خضم التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، في ظل الرغبة الجامحة لعدد من القوى الدولية الكبرى -مثل روسيا والصين- في الاستئثار بأدوار أهمّ وأكثر حضورًا ضمن ميزان النظام الدولي، الذي بدأت ملامحه في التشكل، وهي تتمحور حول مدى قدرة البلدان المغاربية على الاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة في مجال التكتل، وعلى طيّ خلافاتها وتلبية رغبات شعوبها في التواصل، بما يخدم تحقيق التنمية والسلام المستدام.
أولًا: المنطقة المغاربية في عالم متغير
لم تمنع الإشكالات والأزمات المختلفة، التي واجهت عددًا من الدول المتجاورة في أوروبا وآسيا وأمريكا، تطوير علاقاتها وتشبيك مصالحها في إطار تكتلات قوية، بعدما راهنت على المستقبل وطوت كل الخلافات التي تكرّس الأحقاد والعداوات، اقتناعًا منها بأهمية الجوار وفرصه الكفيلة بتحقيق رهانات مشتركة، ووعيًا كذلك بأن نهاية كل حرب هي بداية للعودة إلى جحيم الحروب وأجواء الانتقام من جديد؛ ما جعل الحرص على تشبيك المصالح ونبذ الخلافات رهانًا أساسيًّا لتحصين المستقبل.
وفي مقابل ذلك، وبرغم الإمكانات المشتركة المتاحة، والمحطات القاسية التي مرت بها البلدان المغاربية، فإنها لم تتخذ مبادرات حاسمة على قدر من الجرأة؛ لطي الخلافات التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق التنمية والأمن في المنطقة، منذ إبرام اتفاقية مراكش عام 1989 التي أُنشِئ بموجبها اتحاد المغرب العربي الذي لم يراوح مكانه بعد؛ ما يجعل مستقبل هذه البلدان محفوفًا بكثير من المخاطر ومشوبًا بعدد من الأسئلة الحارقة.
قبل أكثر من قرن من الزمن، اعتبر المستشار الألماني ومؤسس “الرايخ الثاني” “بسمارك” أن الجغرافيا هي العنصر الثابت في السياسة؛ ذلك أن الجوار في العلاقات الدولية لم يكن قط اختيارًا، بقدر ما هو قَدَر يَفرض التعاملَ معه بمنطق كسب المصالح المشتركة ومواجهة التحديات، مع استحضار المستقبل في هذا الصدد.
يمكن للجوار الجغرافي أن يدفع الدول المعنية به إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل المصالح المشتركة، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين من جهة، وفي المقابل يمكن أن يكون عاملًا حاسمًا في خلق حالة من عدم الثقة، وما يتصل بذلك من صراعات سياسية، ونزاعات حدودية، وحروب عسكرية واقتصادية، وتنافس وهدر للإمكانات والطاقات من جهة أخرى.
بعدما عانت البلدان الأوروبية متاهات الحروب المتعاقبة، اقتنعت في آخر المطاف بأن الجوار يتطلب إرساء سياسات جديدة تقوم على تعبئة الإمكانات وتعزيز التعاون والتنسيق في إطار حسن الجوار، بما يسمح بتعزيز السلام وتحصين الأجيال القادمة، وهو ما جعلها تنشئ بشكل تدريجي أحد أهم التكتلات الاقتصادية على المستوى العالمي في إطار من الشراكات وتعزيز الممارسات الفضلى.
وعلى عكس ذلك، ظل الإقليم العربي بشكل عام، والمغاربي على وجه الخصوص، مسرحًا للصراعات البينية والحروب الإقليمية؛ ما خلّف الكثير من الخسائر البشرية والاقتصادية والاستراتيجية.
وعلى الرغم من الروابط الاجتماعية والدينية والثقافية والتاريخية التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري، فإن ظروف إغلاق الحدود ثم قطع العلاقات بين البلدين كرّست مناخًا من الشك والتشاؤم إزاء مستقبل العلاقات بين الجارَين، بل ومستقبل المنطقة المغاربية برمتها، بالنظر إلى الوزن الإقليمي للبلدين داخل الاتحاد المغاربي الذي تأسس في نهاية الثمانينيات، وهو البناء الذي لم ينطلق بالصورة المطلوبة، رغم الطموحات والانتظارات الكبرى التي رافقت إحداثه، والإمكانات الكبرى المتاحة لبلدانه، سواء على مستوى الموقع الاستراتيجي أو فيما يتعلق بالإمكانات البشرية والطبيعية والاقتصادية.
ويمكن القول إن هذه القطيعة تأتي على رأس العوامل التي تكرّس هذا الوضع، الذي يُضاف إلى مختلف الأزمات والتحديات والمخاطر الحقيقية التي تواجه النظام الإقليمي بكل مكوناته الاقتصادية والثقافية والأمنية.
كما أن الدول الكبرى، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، لا تحبّذ قيام هذا الاتحاد، وترى فيه ما قد يضر بمصالحها في المنطقة، حيث تفضل الدول الأوروبية التعامل مع دول المغرب العربي عبر اتفاقيات ثنائية، وذلك منذ زمن السوق الأوروبية المشتركة إلى الاتحاد الأوروبي حاليًّا[1].
تتجسّد تكلفة جمود الاتحاد المغاربي في مجموعة من الانعكاسات التي يمكن إجمالها في الخسائر الاقتصادية الناجمة عن غياب تعاون تجاري بين بلدان المنطقة. كما لا تخفى المخاطر التي يطرحها نشاط وتمدد الجماعات الإرهابية، وتصاعد وتيرة الهجرة غير الشرعية بجوار المنطقة، إضافة إلى تصاعد الأطماع الدولية والإقليمية في الإمكانات الاقتصادية والثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم المغاربي، وكذلك اختلال موازين المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي بصدد عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية، ثم تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من دول الساحل المجاورة للمنطقة.
يمرّ العالم في الفترة الراهنة بتحولات مفصلية، تحيل في مجملها إلى تدافع بين القوى الدولية الكبرى بشكل ناعم أو خشن، وإلى عقد تحالفات جديدة تعزز مكانة عدد من القوى داخل النظام الدولي؛ ما يفرض في مجمله على البلدان المغاربية اتخاذ الحذر واليقظة، والتموقع كطرف فاعل ومؤثر في إطار تحركات جماعية، بدل تكرار أخطاء الماضي التي جعلت المنطقة المغاربية ضحية لنظام ما بعد الحرب الباردة وللتحولات التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر، وتحولات “الربيع العربي”.
وفي هذا الصدد، يتساءل أحد الباحثين: هل يمكن لدول المغرب العربي أن تتحول من الحلقة الأضعف في المعادلة الإقليمية والدولية إلى طرف فاعل في مواجهة تحالف ثلاثي القوى: الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والقوى الصاعدة؟ ويجيب “إنه، وبالنظر إلى الواقع الجيوسياسي العام في المنطقة، ليس بمقدورها تجاوز تناقضاتها واختلافاتها، رغم امتلاكها لكل الوسائل لإحداث تحرك موحَّد، بالنظر إلى تصرفاها المتشتتة والأنانية التي تطغى على النهج السيادي لديها..”[2].
وانطلاقًا من هذه المعطيات، يمكن القول إن استمرار القطيعة بين الجارين هو خيار غير استراتيجي، يُضيع على البلدين وعلى المنطقة المغاربية برمتها الكثير من الفرص التي يمكن أن تدعم حضورها ووزنها في خضم هذه التبدلات الدولية الوازنة.
إن الجوار الجغرافي على موقع استراتيجي مهم، والمقترن بمناخ دولي مملوء بالتحديات والمخاطر، وبجمود الاتحاد المغاربي، يضع البلدين معًا أمام محك حقيقي يفرض اتخاذ قرارات جريئة ومنفتحة على المستقبل تقطع مع سنوات الهدر، وتسمح بطيّ الخلافات والانكباب على إرساء علاقات مبنية على الحوار وتشبيك العلاقات في إطار من التعاون وحسن الجوار.
ثانيًا: المشترك المغاربي والدّرس الأوروبي
لم يكن أحد يتوقع، قبل أكثر من نصف قرن، أن أوروبا التي ظلت تعيش على إيقاع الحروب والصراعات الطاحنة على امتداد سنوات عديدة ستؤسس لتجربة واعدة في التنسيق والتكتل، تتوارى خلفها النزاعات والخلافات الضيقة، لتفتح الباب على مستقبل مشرق تصنعه الشعوب يحيل إلى التطور والتنمية.
لاشك في أن مرارة الظروف التي مرّت بها أوروبا، وما رافق ذلك من مآسٍ إنسانية وبيئية واقتصادية، كان لها الأثر الكبير في استجلاء الدروس والعبر من مجمل الحروب المدمرة التي لم ينتصر فيها أحد أصلًا، على اعتبار أن الحروب دمرت كامل أوروبا.
وبرغم التنوع والاختلاف الذي يميز القارة الأوروبية دينيًّا وثقافيًّا ولغويًّا، ورغم محطّات الحروب التي تميز تاريخها، فإنها استطاعت أن تبني تجربة متميزة على الصعيد العالمي في مجال التكتل الذي تجسده تجربة الاتحاد الأوروبي. فهذا الأخير انطلق متدرّجًا ومتواضعًا في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ ليؤسس لمفهوم جديد للتعاون والتنسيق وللأمن الإقليمي في صورته المنفتحة، قبل أن يتحوّل الأمر مع توالي المكتسبات إلى رهان الوحدة الأوروبية التي عززتها الكثير من الاتفاقيات والتشريعات والتدابير الداعمة للعمل المشترك على مختلف الواجهات.
وقد كان لتشبيك المصالح الاقتصادية والعلاقات التجارية والثقافية والسياسية أثر كبير في تحصين دول القارة وشعوبها ضد أي عودة إلى سنوات الاقتتال أو إحياء العداوات التي طبعت صفحات ماضية من تاريخها (مثلًا: مشكلة الألزاس واللورين بين ألمانيا وفرنسا). وتُبرز التجربة الأوروبية أنه كلما تم تشبيك المصالح الاقتصادية وتعميق الشراكات المختلفة، تزايدت الرغبة والقناعة في حسم الخلافات المتراكمة بشكل نهائي وفي أجواء من حسن النية، حيث تعد هذه المصالح بمثابة ضمانة حقيقية تحول دون التورّط في اتخاذ قرارات مزاجية وغير مدروسة.
لم يكن قرار تعزيز التعاون والتنسيق داخل الفضاء الأوروبي مركزيًّا وفوقيًّا، بل هو نتاج لمجموعة من الأفكار التي طرحها كثير من الفلاسفة والفقهاء والمفكرين، وحتى بعض النخب السياسية والمدنية، التي دعت إلى وقف متاهات الصراعات والخلافات التي زجت بالبلدان الأوروبية في حروب مدمرة، وإلى تحويل هذه الترسبات القاسية إلى فرص لتحقيق مكتسبات جماعية تدعم تحقيق الاستقرار والسلام المستدام داخل القارة الأوروبية، وهو ما دفع صانعي القرار في عدد من بلدان القارة إلى الاستجابة إلى هذه الدعوات اقتناعًا بأهميتها وانسجامًا مع الطفرة الإصلاحية التي شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما كان له الأثر في تحقيق مجموعة من المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية داخل القارة، وزيادة القناعة بأن أي تفريط في المكتسبات التي تحققت على امتداد عدة عقود في هذا الخصوص سيكون له أثر بالغ في العودة إلى أجواء الاقتتال.
وبالعودة إلى المنطقة المغاربية، ظل هاجس بناء تكتل إقليمي بالمنطقة حلمًا راود قادة حركات التحرر الوطني المغاربية، وهو ما عكسه حجم التنسيق والتعاون فيما بينهم لمواجهة الاستعمار، وكذا اللقاءات المتتالية التي جمعتهم في إطار نقاشات لتحقيق هذا المطلب.
وتأكيدًا لانصهار الحركات الوطنية في دول المغرب العربي، انعقد مؤتمر ضم الأحزاب الرئيسية الثلاثة: الاستقلال المغربي، والحزب الدستوري الجديد في تونس، وحزب الشعب الجزائري ما بين 15 و22 فبراير عام 1947[3].
ولذلك، فإن “الفكرة المغاربية بالمعنى المعاصر للكلمة كانت وليدة حركات الكفاح الوطني ضد المستعمر خلال النصف الثاني من القرن العشرين. وقد بلغت كامل نضجها مع تأسيس مكتب المغرب العربي سنة 1947 برئاسة الأمير محمد بن عبدالكريم الخطابي، وعضوية زعماء الحركة الوطنية التونسية والجزائرية والمغربية”[4] كإطار لتنسيق الجهود بين هذه الحركات.
وتعززت هذه المبادرات باللقاء المهم الذي انعقد بمدينة طنجة (شمال المغرب) سنة 1958، وجمع عددًا من الأحزاب الوطنية المغاربية (جبهة التحرير الوطني الجزائري، والحزب الحرّ الدستوري من تونس، وحزب الاستقلال من المغرب)، حيث شكل مناسبة لرسم الأسس والمبادئ الأولى لبناء اتحاد المغرب العربي، وهو ما مهد الطريق لإحداث اللجنة الاستشارية للمغرب العربي سنة 1964 التي حرصت على إعداد تصور عام للشروط المواتية لتعزيز التنسيق والتعاون بين البلدان المغاربية الخمسة في مختلف المجالات.
وقد تُوجّت هذه المبادرات بإبرام معاهدة اتحاد المغرب العربي في مراكش بتاريخ 17 فبراير من عام 1989. وتمكّن الاتحاد، على امتداد سنوات، من تشكيل إطاره التنظيمي والمؤسساتي، بعد تنصيب الأمانة العامة الموجودة بمدينة الرباط، ومجلس الشورى ومقره العاصمة الجزائرية، والهيئة القضائية، التي توجد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إضافة إلى الجامعة المغاربية والأكاديمية المغاربية للعلوم في العاصمة الليبية طرابلس، إضافة إلى المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الموجود في تونس العاصمة، وقد خلّفت هذه الخطوات ارتياحًا واسعًا في أوساط الشعوب المغاربية.
وقد تطورت “فكرة إنشاء الاتحاد المغاربي مع الأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة، ولاسيما بعد التصالح المغربي-الجزائري والتآخي التونسي-الليبي، وما نتج عنه من تطبيع العلاقات المغاربية”[5]. غير أنه، وخلافًا للخطوات الوازنة التي اتُّخذت في إطار المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي لاحقًا، ظل أداء الاتحاد المغاربي باهتًا، ودون التطلعات والتحديات التي تحيط بالمنطقة في علاقة ذلك بكسب رهانات التنمية وتحقيق الأمن الإنساني.
ثالثًا: الهدر المغاربي المتجدّد
تشير الممارسة إلى أن هناك هدرًا كبيرًا للفرص ولمختلف المقومات والعناصر المشتركة الداعمة لبناء تكتل مغاربي وازن، بما يكرس حالة الانتظار ويكلّف المنطقة المزيد من الخسائر.
فعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود عاشت شعوب المنطقة على واقع استمرار الخلافات السياسية التي أسهمت في إذكائها بعض القنوات الإعلامية والنخب السياسية بمواقفها غير المحسوبة، ضدًّا على كل المبادرات والاتفاقيات المبرمة في إطار اتحاد المغرب العربي، وهو ما أدى إلى تأجيل الحلم المغاربي مرة أخرى.
تمتد الدول المغاربية في موقع استراتيجي مهم يفصل بين قارتين، ويطل من ناحية على المحيط الأطلسي وعلى البحر الأبيض المتوسط من ناحية أخرى، وهي تحتضن ثروات طبيعية تتنوع بين المنتجات الفلاحية كالخضروات والفواكه والحبوب، والموارد المعدنية كالفضة والذهب والحديد والنحاس والزنك والفوسفات، والثروات السمكية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة كالغاز الطبيعي والنفط، وهو ما يوفر أساسًا لتحقيق تكامل اقتصادي واكتفاء غذائي في عالم يزخر بالتهديدات العابرة للحدود.
كما أن “الأقطار المغاربية متجاورة وموحدة جغرافيًّا، حيث إن أراضيها متصلة بعضها ببعض دون أي فاصل طبيعي؛ ما يساعد على تحقيق وحدتها وتكاملها الاقتصادي والاجتماعي والبشري”[6].
ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن هناك أرضية متينة لبناء اتحاد مغاربي قوي، تعززها المقومات البشرية والموروث الثقافي والحضاري والمشترك الاجتماعي والتاريخي، بالإضافة إلى التحديات المتزايدة التي تواجه بلدان المنطقة مجتمعة.
إن جغرافية المغرب العربي السیاسیة والطبیعیة والسكانیة والاقتصادیة تؤهله لأن یكون فضاءً إقليميًّا ودولیًّا ذا شأن في مجال رسم السیاسة والعلاقات الدولية، وفي مجال حفظ السلم والأمن الدولیَّین..، وفي التأثیر الأكبر في محیطه العربي والأفریقي والمتوسطي[7].
لقد أضحى تفعيل البناء المغاربي ضرورة ملحة لمواجهة الإشكالات الداخلية والخارجية التي تحيط بهذه البلدان، غير أن كسب هذا الخيار يتطلب قرارات حاسمة تأخذ في الاعتبار القواسم المشتركة بين شعوب المنطقة، وما يواجهها من إشكالات مخيفة حذّر منها كثير من الخبراء والباحثين والفاعلين السياسيين، فعلى المستوى الاقتصادي تشير المعطيات الإحصائية إلى أن البلدان المغاربية تخسر ما يناهز %2 من معدل نموها سنويًّا؛ نتيجة الجمود الذي يطبع العلاقات التجارية والاقتصادية البينية وعدم إحداث مشاريع مشتركة في هذا الصدد.
فيما لايزال النمو الاقتصادي بطيئًا في دول المغرب العربي؛ ما يحد من فرص العمل المتاحة للمهاجرين المحتملين. فغالبًا ما يفضل المهاجرون المغاربيون تجربة حظهم في أسواق أكثر نضجًا، وخاصة الأسواق الأوروبية[8].
وعلى المستويين الاجتماعي والسياسي يخلّف الركود القائم حالة من الشك والإحباط في أوساط شعوب المنطقة، ويقيّد طموحاتهم في التواصل والتنقل والبحث عن فرص للعمل والاستثمار والتجارة، وعلى المستوى الاستراتيجي يكرس الوضع الراهن حالة من الهشاشة الأمنية التي تحد من حضور ووزن البلدان المغاربية في علاقاتها وشراكاتها الإقليمية والدولية. فإذا كان الاتحاد الأوروبي يمتلك أهدافًا محددة وشروطًا واضحة، فإن البلدان المغاربية تتصرف بمنطق أحادي، في غياب رؤية مشتركة في هذا الإطار، بل ويطبعه التنافس أحيانًا؛ الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الاتحاد الأوروبي لإبرام شراكات ثنائية تقوم على التعامل مع كل دولة على حدة، وهي العلاقة التي يظل فيها الطرف الأوروبي هو الرابح دائمًا.
وعلى المستويات الأمنية، فالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيش على إيقاعها بعض الدول المغاربية تجعلها مهدَّدة بتصاعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جهة بصفتها بلدانًا مصدَّرة أو دولَ عبور، ومهدَّدة أيضًا بالتطرف والإرهاب اللذين ينتعشان في هذه الأوضاع. كما لا تخفى الهشاشة التي تعرفها دول منطقة الساحل الأفريقي المجاورة، والتي تسهم بدورها في انتعاش وتمدد الظاهرتين وتأثيرهما على المحيط المغاربي. وهي العوامل التي تتطلب بلورة خطط استراتيجية جماعية لمواجهتها بشكل شمولي.
فالإرهاب عادة ما ينتشر في بؤر التوتر والمناطق الملتهبة التي يسودها الصراع، كما أن القوى الأجنبية غالبًا ما تستثمر حالة التشرذم والفُرقة بين الدول؛ لتنفيذ استراتيجيتها ومشاريعها التي تكرّس التبعية، وتحويل الموازين التفاوضية بشأن عدد من القضايا والشراكات الاقتصادية والسياسية والأمنية لصالحها.
إن الوضع المتأزم الذي تعيشه المنطقة مع استمرار أجواء الجمود، هو عامل ينضاف إلى عوامل أخرى تغذي أزمة النظام الإقليمي العربي، الذي تدهور بشكل كبير خلال العقود الأخيرة؛ ما أتاح لأطراف إقليمية كتركيا وإيران وإسرائيل التدخل بأشكال مختلفة في شؤون دول المنطقة.
إن ما يعمق هذه الوضعية غير السليمة للمنطقة المغاربية هو السجالات الضيقة التي يقودها بعض المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك من يستفيدون من هذا الجمود على مستوى تصريف الأزمات والمشكلات، بالإضافة إلى صمت النخب المثقفة والقوى السياسية الحية في المنطقة وعدم انخراطها في خلق نقاشات عمومية تبرز حجم الخسائر التي تدفعها المنطقة وشعوبها بفعل التنكر للمشترك المغاربي وعدم استثمار الإمكانات المتاحة للاستئثار بمكانة وازنة بين الأمم.
تمر المنطقة المغاربية بمرحلة مفصلية، تحيل إما إلى استمرار النكسات وتكريس الصراعات التي قد تتحول مستقبلًا إلى نزاعات عسكرية غير محسوبة العواقب من جهة، وإما خلق فضاء للتعاون وتعزيز الاندماج الكفيلين بتحقيق التنمية والتقدم من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، فإن دول المنطقة، التي يُفترض أن تتخذ قرارات تاريخية تعيد الأمور إلى الطريق السليم، وهي مهمة تتقاسمها معها أيضًا مختلف القوى المجتمعية من نخب مختلفة وأحزاب سياسية وجامعات ومراكز علمية، وهيئات مدنية وإعلام، تتحمل مسؤولية كبيرة باتجاه رفض الخيارات القطرية بإبراز المشترك المغاربي، ودعم كل المبادرات البناءة الداعمة لهذا التوجه، وتجاوز النقاشات السياسوية الضيقة التي تكرّس الهدر.
ويرى البعض أن “المواطنة المغربية هي اليوم حتمية اقتصادية؛ إذ إن الرفاه الذي تتعلق به جموع “سكان” المغرب ممكن في حال تحقيق اندماج اقتصادي، يخلق سوقًا استهلاكية تتجاوز الـ100 مليون نسمة، ويسمح بتركيز أقطاب صناعية ومشاريع عملاقة”[9].
معلومات عامة عن البلدان المغاربية[10]

رابعًا: الاتحاد المغاربي وسؤال الإصلاح
تشير مختلف التقارير والدراسات إلى أن العوامل التي تقف خلف جمود الاتحاد المغاربي متعددة؛ فعلاوة على عامل الإرث الاستعماري الذي تمخضت عنه مشاكل حدودية بين دول الاتحاد؛ ثم غياب مشروع اقتصادي مغاربي واضح المعالم، دخلت بعض دول المنطقة في أزمات سياسية داخلية أثرت في استقرارها (الجزائر في بداية التسعينيات من القرن المنصرم، وموريتانيا إبان حدوث عدد من الانقلابات السياسية)، ويتمركز على رأس هذه العوامل غياب إطار قانوني ومؤسساتي منفتح ومحوكم يؤطر عمل الاتحاد.
استطاعت كثير من دول العالم أن تحقق مكتسبات اقتصادية واجتماعية وسياسية في إطار تكتلات قوية، في كل من أوروبا (الاتحاد الأوروبي) وأمريكا (الأنديز) وآسيا (النمور الآسيوية) بصورة تبرز أهمية التعاون في إطار تنظيمات إقليمية مبنية على أسس قانونية متينة تتيح لها اتخاذ مبادرات مهمة، في إطار من احترام السيادة وحسن الجوار.
إن الديمقراطية في ارتباطها بتداول السلطة بصورة سلمية ومشروعة، واعتماد الشفافية والتعددية السياسية، وكذلك المشاركة السياسية التي تسمح للمواطنين نساءً ورجالًا بتدبير شؤونهم، والتأثير في مختلف القرارات والسياسات ذات الطابع العام عبر استشارات انتخابية حرة ونزيهة، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان وتدبير الاختلاف والتنوع داخل المجتمع بصورة سليمة وبنّاءة[11] – كل ذلك وفر المناخ المناسب والسليم أمام البلدان الأوروبية لنبذ خلافاتها التاريخية المتراكمة، والتنازل عن جزء من سيادتها لتجعل من الاتحاد الأوروبي نموذجًا حقيقيًّا في الاندماج والوحدة.
يُعدُّ الاتحاد الأوروبي ثمرة ممارسات ديمقراطية، فقبل تأسيس منظمة الأمم المتحدة تبين أن الفاشية والنازية بتوجهاتهما الاستبدادية والتوسعية، قادتا العالم نحو حروب طاحنة كانت كلفتها خطيرة على كل المستويات. وقد حاولت الدول الأوروبية أن تستفيد من هذه المحطات الصعبة، لتراهن على المدخل الديمقراطي الذي أسهم في تحقيق التنمية، والإسهام في بناء أحد أهم التكتلات الاقتصادية الإقليمية على المستوى العالمي، الذي دعّم من جانبه هذه التوجهات الديمقراطية.
إن “توافر الإرادة السياسية يُعد الشرط الضروري والحاسم لقيام اتحادات إقليمية، والاتحاد الأوروبي أحسن مثال على ذلك، حيث إن تقارب أنظمة الحكم القائمة فيه على أسس الديمقراطية ووعيها بالمصير المشترك، مكّن هذه البلدان من تجاوز القضايا الخلافية فيما بينها”[12].
تبرز مسيرة الاتحاد الأوروبي أنه استفاد بشكل كبير في تطوره من التحولات الديمقراطية التي عرفتها القارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، قبل أن يسهم بدوره في تعزيز الإصلاحات الديمقراطية بعدة مناطق في أوروبا الغربية والشرقية، خصوصًا وأن الانضمام إليه يظل مشروطًا باعتماد مجموعة من الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والسياسية، واحترام الحريات وحقوق الإنسان..
وتعد التشاركية سمة بارزة في أداء الاتحاد الأوروبي، فإلى جانب المفوضية الأوروبية، يستأثر البرلمان الأوروبي بصلاحيات وازنة، علاوة على وجود المحكمة الأوروبية كجهاز قانوني يدعم هذه التجربة، فيما يحرص النظام الأساسي الأوروبي على إشراك جماعات المصالح ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي الجماعات الترابية في صناعة القرار الأوروبي.
وفي مقابل ذلك، يبقى اتحاد المغرب العربي مركزيًّا، ويفتقد النجاعة؛ نتيجة اعتماده آلية التصويت التي تقوم على الإجماع، وعدم تبنيه المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات إلى جانب مجلس الرئاسة. وهذا أمر طبيعي إذا استحضرنا أن “مؤسسات الاتحاد لم تكن مؤسسات منبثقة عن تجربة ديمقراطية، كما هو الشأن في تجارب أخرى، كل ما يرتبط بها هو تزكية من أنظمة سياسية وليس من إرادة شعبية عن طريق الانتخاب”[13].
تحتكر مؤسسة الرئاسة في البلدان المغاربية سلطة اتخاذ القرار، فالرئيس أو الملك وكيفما كان المصدر الذي يستمد منه سلطته وبالتالي شرعيته، يبقى هو المؤسسة المحورية التي تقوم عليها الأنظمة المغاربية[14]. ويبدو أن هذه المركزية في اتخاذ القرار هي نفسها التي حرص مؤسسو الاتحاد على تكريسها ضمن معاهدة مراكش المنشئة له، فالمادة السادسة منها تؤكد على أن: “لمجلس الرئاسة وحده سلطة اتخاذ القرار، وتصدُر قراراته بإجماع أعضائه”.
وأمام اعتماد آلية الإجماع[15] في اتخاذ القرارات الحاسمة، وتركيز مختلف الصلاحيات الحاسمة في يد مجلس الرئاسة، الذي كثيرًا ما فشل في عقد قمته السنوية، وعدم تمكين باقي الأجهزة الأخرى من قبيل مجلس وزراء الخارجية أو مجلس الشورى.. من صلاحيات حقيقية، يبقى الاتحاد جامدًا يعكس رتابة المشهد السياسي في عدد من دول الاتحاد نفسها.
وبناء على هذه المعطيات، فإن “المشروع التكاملي المغاربي يبقى أسير الإدراك الرسمي للقيادات السياسية التي يبدو أن اهتماماتها وأولوياتها مرتبطة بالظاهرة القطرية”[16].
يشكل تعزيز الإصلاحات السياسية في البلدان المغاربية بوابة لزحزحة الوضع المغاربي المتأزم بشكل عام وتفعيل عمل الاتحاد. كما أن اعتماد المقاربة التشاركية، و”دمقرطة” أجهزة هذا الأخير بتمكينها من صلاحيات وازنة، واعتماد التصويت بالأغلبية بدل الإجماع، كلها أمور كفيلة بإخراج هذا التكتل من طابعه الفوقي، والسير به نحو مصاف التكتلات الإقليمية القوية.
يفرض ذلك الأمر تفادي النقائص التي تشوب النصوص القانونية المؤطّرة لعمل هياكل الاتحاد ومؤسساته التقريرية والتشريعية والتنفيذية، وإعطاء أولوية للنصوص التي تسهّل التنمية الاقتصادية والبشرية على الصعيد المغاربي[17].
وأخيرًا، ستشكل “دمقرطة” عمل الاتحاد قاعدة متينة توفر شروط التحرك والمبادرة، وتحفز على خلق أجواء من الحوار البنّاء بين النخب المغاربية، والتواصل بين شعوب المنطقة، على طريق الانكباب بكل مسؤولية على معالجة الخلافات القائمة بشكل مستدام، وعلى تشبيك العلاقات البينية.
خامسًا: بين الخطابات الشعبوية ومسؤولية النخب المثقفة
كلما تعقدّت الأزمات، واشتدّ حرج بعض صناع القرار أمام الرأي العام، زادت إمكانية افتعال أزمات وهمية؛ لتصريف نظيرتها الحقيقية. وتزداد خطورة هذه الآلية مع تطور تكنولوجيا الاتصال الحديثة، وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي.
إن اقتران هذه الشبكات ببعض المؤثرين، الذين يفتقرون إلى مستويات تعليمية تؤهلهم للخوض في نقاشات سياسية وثقافية عميقة تهم المنطقة، جعلهم يتورطون في نشر الكثير من التفاهات والشائعات والمعلومات الخاطئة التي تكرس السطحية والرداءة، والجري وراء الفضائح وافتعالها، بل والمساس بحقوق الإنسان، والتحريض على العنف والكراهية أحيانًا.
وهكذا، أتاحت هذه الشبكات، خلال السنوات الأخيرة، انتشار خطابات تكرّس العداء والقطيعة بين البلدان المغاربية، وتُذْكي الصراعات والأحقاد بين شعوب يجمعها مشترك إنساني وحضاري. والغريب في الأمر هو الاهتمام والتشجيع اللذان يحظى بهما رواد ترويج هذه الخطابات، مقابل تهميش الكثير من المبادرات الراقية التي تطلقها بعض النخب وفعاليات المجتمع المدني التي تدعو إلى طي الخلافات، وإلى اتخاذ قرارات تعكس توجهات شعوب المغرب الكبير، حيث يتم الترويج لعدد من المضامين السطحية وتحويلها إلى قضايا رأي عام، على حساب ملفات مهمة وحارقة تؤرق بال فئات واسعة من المجتمع. وتحت ضغط هذه النقاشات التافهة، “حوصر الكل بخطابات الكراهية والعداء، ونسي الجميع مشروع اتحاد المغرب العربي، وأصبحنا سُجناء ما يُعْرَف بالديكتاتورية الخفيّة للعالم الرقمي ومحرّكاته”[18].
لا يمكن إنكار الكثير من المبادرات المغاربية البنّاءة التي تظهر بين الفينة والأخرى؛ ففي مقابل هذه الحروب الإعلامية التي تركز على نقاط الخلاف، برزت خطابات وتوجهات بنّاءة في مختلف المجالات الفنية والرياضية والثقافية والاجتماعية والفكرية، لم يكتب لها الترويج والمواكَبة، فيما انتقدت شخصيات مغاربية عديدة القرارات غير الشعبية التي اتخذتها بعض دول المنطقة، ودعت إلى تعزيز العلاقات بين البلدان الخمس (المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا). وعلى امتداد هذه الأخيرة، تنتشر أيضًا مراكز علمية ومنظمات مدنية تشتغل على قضايا مغاربية في الظل. غير أن تصاعد الخطابات التافهة في مقابل هذه المبادرات، يعكس – مع الأسف- الواقع الذي تشهده عدد من دول المنطقة من حيث تراجع مكانة الفكر والمعرفة.
إن تشجيع الأصوات الشعبوية، والمراهنة عليها في تصريف الأزمات التي تعرفها دول المنطقة، وتهميش الأصوات العاقلة يمثل مجازفة يمكن أن تدمّر صمامات الأمان داخل المجتمعات المغاربية، وتورّث العداء والأحقاد للأجيال القادمة.
فالوضع المغاربي الراهن، بإكراهاته وإخفاقاته، من حيث ضعف التعاون الاقتصادي، وتنامي خطابات القطيعة، والتقليل من أهمية البناء المغاربي، يسائل الجميع، ويفرض وقفة تأمل، حيث تبرز مسؤولية النخب المغاربية بكل أصنافها في هذا الخصوص. فالظرفية بحاجة ملحة إلى أصوات عاقلة ومسؤولة توقف نزيف الهدر الحاصل، وتجهر برفض هذا الواقع المرّ الذي لا يعكس طموحات شعوب المنطقة.
إن دور المثقف المغاربي في هذه المرحلة الحرجة ليس هو الانتظار أو التعايش مع هذا الوضع غير السليم، أو تبرير ما تقبل عليه السلطات في المنطقة من سياسات وخطوات، بل التفاعل بشكل إيجابي مع الواقع، ومواكبة التحديات التي يفرضها المحيطان الإقليمي والدولي، وإنتاج الفكر الذي يدعم تطوير المجتمعات، ويسهم في تنوير العقول، وإشعار صناع القرار بحجم الروابط التي تجسد المشترك المغاربي، والخسائر التي تنجم عن تجميد أو تأجيل تفعيل المشروع المغاربي، وطرح رؤى استراتيجية لبعث الحياة في البناء المغاربي، وإقناع صناع القرار بجدوى هذا المشروع الكفيل بطي الخلافات، وترسيخ السلام، وتحقيق النمو وتوفير فرص الشغل للشباب.
إن النخب في العالم العربي، بشكل عام، كما يرى البعض، “تعيش في مأزق يدفعها إلى الاستسلام للخوف من البطش في غياب الديمقراطية، ووجود نظم قمعية مستبدة”[19]. لكن، وأمام الخطابات التصعيدية التي تذكيها بعض الأصوات الشعبوية، يتحمل المثقف المغاربي مسؤولياته في إرساء نقاشات نقدية بنّاءة، تقوم على نبذ خطابات التحريض والقطرية الضيقة، وتعيد الاعتبار للثقافة والمعرفة كرافد أساسي لتحقيق تنمية مستدامة محورها الإنسان المغاربي، ولإرساء سياسة خارجية أكثر عقلنة وانفتاحًا على المستقبل. فالمعارك الحقيقية، وما أحوج المنطقة المغاربية إليها، هي تلك التي تستهدف الاستبداد والفقر والتخلف والتطرف والجهل والفساد، عبر تعزيز العدالة ونهج الحوكمة، وتشجيع البحث العلمي، وتحقيق الرفاه للمواطن، وتوطين التكنولوجيا، وليس تلك المتصلة بتكريس الصراعات وتوريث الأحقاد.
لا يمكن كسب هذه الرهانات إلا بفتح المجال أمام النخب الحقيقية، وأمام القنوات والمؤسسات الوسيطة من أحزاب ونقابات وإعلام ومؤسسات تعليمية؛ للاستئثار بأدوارها ومسؤولياتها المجتمعية في إطار من الحرية، وبالاستثمار في حقل الثقافة كخيار استراتيجي مربح بكل المقاييس.
خاتمة
يشهد العالم مجموعة من التحولات العميقة التي تؤكد أن المستقبل بتحدياته ومخاطره لا يتسع للدولة القطرية بمفردها، بل يتطلب التعاون والتنسيق وتكثيف الجهود في إطار تكتلات كبرى قادرة على تحقيق الأمن بمفهومه الإنساني الواسع والمستدام. وتملك الدول المغاربية كل المقومات والشروط التي تجعلها قادرة على الاستئثار بمكانة وازنة على المستويين الإقليمي والدولي.
إن تحويل هذه المقومات إلى عنصر قوة يدعم تحقيق التنمية والأمن والاستقرار، في إطار تكتل مغاربي واعد، يتطلب وجود إرادة سياسية، ورؤية بعيدة النظر، منفتحة على المستقبل وعلى مصالح شعوب المنطقة في أبعادها الاستراتيجية.
كما أن قَدَر الجوار المغاربي، المقترن بمقومات بشرية واجتماعية واقتصادية وطبيعية، يقتضي اتخاذ خطوات مدروسة، تتجاوز الحسابات الضيقة والمرحلية، عبر تعزيز الاستثمارات البينية وتشبيك المصالح، بصورة تتيح لشعوب المنطقة العيش في سلام وتواصل، بعيدًا عن الأحقاد، بدلًا من تحويل المشترك إلى مظاهر لتكريس الفرقة والصراعات.
إن كسب هذا الرهان هو مهمة جماعية تتحملها الدول الخمس، من خلال مؤسساتها وهيئاتها الحكومية، إلى جانب عدد من الفاعلين من أحزاب سياسية، ونخب مثقفة، وهيئات مدنية، ومؤسسات تعليمية، ومراكز بحثية، وقنوات إعلامية، تسهم في دعم التواصل بين الشعوب المغاربية، وفي تنظيم لقاءات علمية، ونشر دراسات وأبحاث وتقارير تبرز تكلفة جمود الاتحاد المغاربي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
[1] – عبدالعزيز شرابي: اتحاد المغرب العربي، الأوضاع الراهنة والتحديات المستقبلية، مجلة الاقتصاد والمجتمع، العدد 5 لعام 2008، ص16.
[2] – زاوي رابح: المغرب العربي وإشكالية التحول من موضوع إلى فاعل إقليمي ودولي، الموقع الإلكتروني لمركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، على الموقع الرابط (تمت الزيارة بتاريخ 31 أغسطس 2025): https://2h.ae/uxHb
[3] – اتحاد المغرب العربي.. الوحدة التاريخية والجغرافية، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، الإمارات العربية المتحدة يونيو 2001، ص95.
[4] – خالد شوكات: البعد المغاربي في الدساتير التونسية.. بين طموح النخبة والتزام الدولة، ضمن “ثلاثون سنة على قيام الاتحاد المغاربي.. الرهان والتحديات”، (مؤلَّف جماعي)، منشورات منظمة العمل المغاربي، تنسيق د.إدريس لكريني، المطبعة والوراقة الوطنية، المغرب، الطبعة الأولى 2019، ص64.
[5] – شيبوط سليمان: لحظات تاريخية مختصرة حول المسيرة العربية الوحدوية لدول المغرب العربي، مجلة الجامعة المغاربية، السنة السابعة، العدد الثالث عشر، ليبيا 2013، ص23.
[6] – خالد خميس: نحو استراتيجية شاملة لتحقيق تنمية اجتماعية في دول اتحاد المغرب العربي، مجلة الجامعة المغاربية، السنة الثالثة، العدد الخامس، ليبيا 2008، ص53.
[7] – سلیمان الساسي شحومي وعلي قابوسة: اتحاد المغرب العربي .. مسیرة ثلاثین عامًا بین الواقع والطموح، المجلة الجزائریة للاقتصاد السیاسي، (2020/01) المجلد (02) العدد1، يناير 2020، ص13.
[8] – انظر:
Fonds Monétaire international, Département Moyen-Orient et Asie centrale: L’intégration économique du Maghreb, une source de croissance inexploitée, NO 19/01, P18
[9] – المهدي بن عبدالجواد: من الوحدة المغربية.. إلى المواطنة المغربية، مجلة المصير، السنة السادسة، العدد 22، ربيع 2023، المعهد العربي للديمقراطية، تونس، ص9.
[10] – الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي (تاريخ الزيارة 30 أكتوبر 2025):
https://maghrebarabe.org/wp-content/uploads/2024/12/1-Informations-2023.pdf
[11] – لمزيد من التفاصيل في هذا الخصوص، يراجع، إدريس لكريني: تدبير أزمات التحول الديمقراطي.. مقاربة للحراك العربي في ضوء التجارب الدولية، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، المغرب 2020.
[12] – سعيدة العثماني: من الاتحاد المغربي العربي إلى اتحاد المغرب الكبير: أي تحولات لأي ضرورات؟، ضمن “ثلاثون سنة على قيام الاتحاد المغاربي.. الرهان والتحديات”، مرجع سابق، ص23.
[13] – محمد جويلي: برج بابل اللامغرب: كُلفةُ سنوات الهدر، صحيفة المغرب، تونس، بتاريخ 31 أغسطس 2021.
[14] – د. فتح الله الغازي: الأنظمة الدستورية والسياسية للدول المغاربية.. مقاربة نقدية، ضمن الإصلاحات الدستورية والسياسية في المغرب العربي، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 15، كلية الحقوق مراكش، الطبعة الأولى 2000، ص12.
[15] – تعتمد الكثير من التكتلات الإقليمية والدولية كالاتحاد الأوروبي على التصويت بالأغلبية عند اتخاذ القرارات.
[16] – د. الحسين بوقارة: إشكاليات مسار التكامل في المغرب العربي، مطبعة دار هومة، الجزائر 2010، ص113
[17] – د. محمود حسن: أي منظومة قانونية لاستكمال البناء المغاربي؟ ضمن: ثلاثون سنة على قيام الاتحاد المغاربي.. الرهان والتحديات، مرجع سابق، ص84
[18] – كمال عبداللطيف: المغرب والجزائر.. والكراهية في الفضاء الرقمي، صحيفة العربي الجديد، بتاريخ 2 فبراير 2023.
[19] – محمد نبيل الشيمي: النخبة وتأثيرها في تكوين واستقرار المجتمعات وتشكيل نسق الحكم والفكر، المركز الديمقراطي العربي، بتاريخ 27 يناير 2016، على الرابط (تمت الزيارة بتاريخ 30 أغسطس 2025): https://democraticac.de/?p=26489