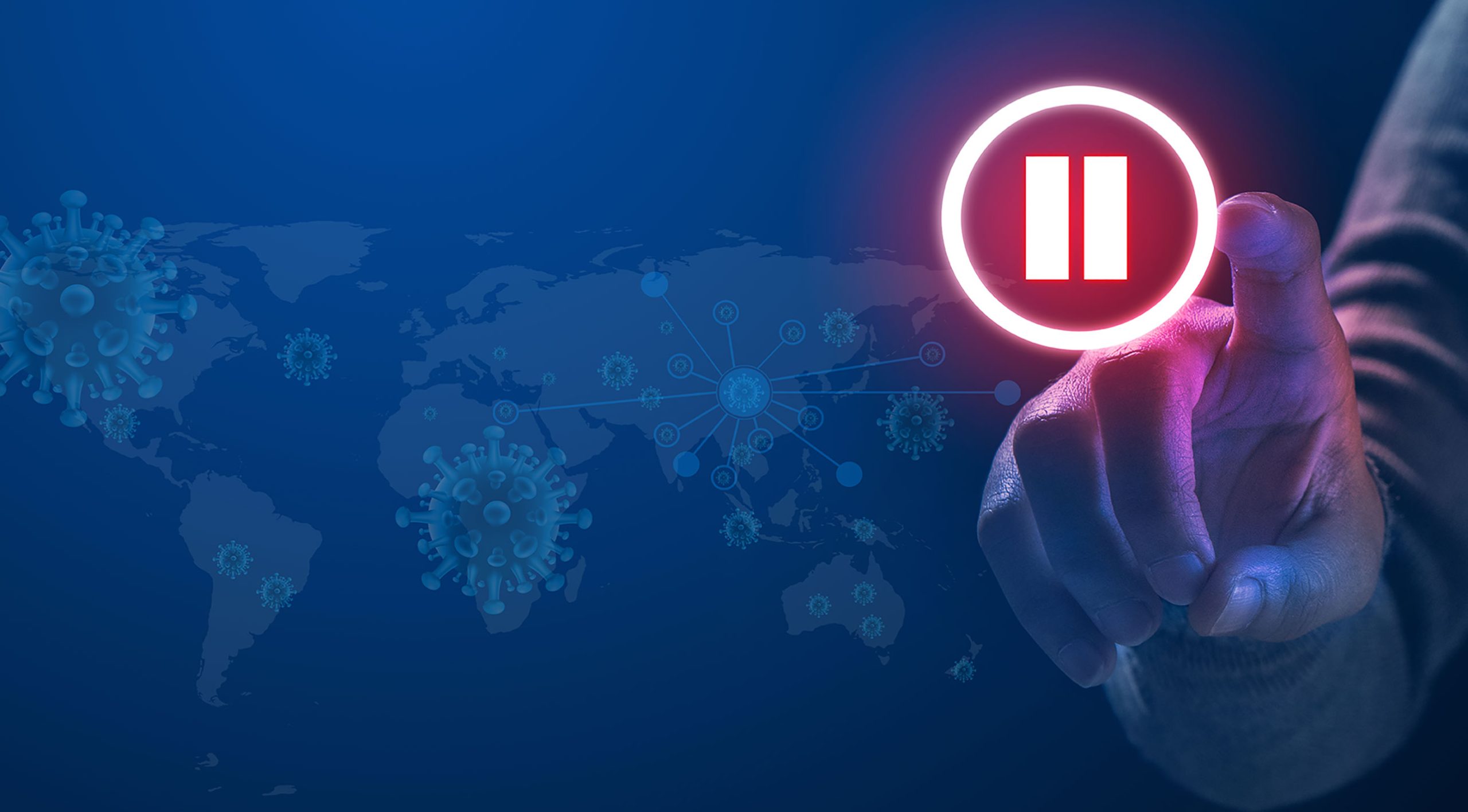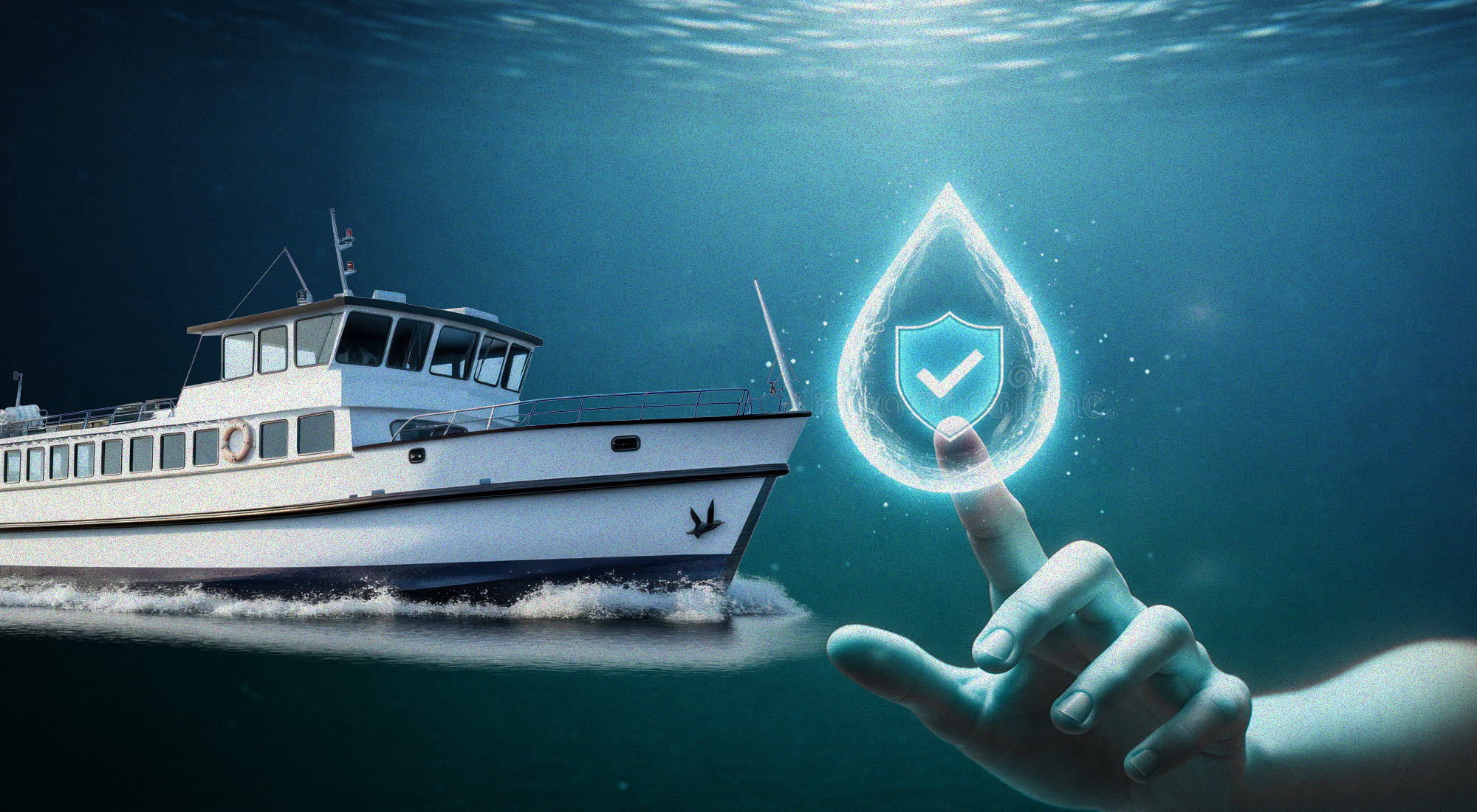باتت الذكرى السنوية لتفشي كوفيد-19 على الأبواب، فيما لا يزال اللقاح الناجع على مسافة عدة شهور على أقل تقدير، ومع ذلك ما تزال هناك أسئلة كثيرة عالقة تدور حول كيف وصلنا إلى هذه النقطة. لقد تجاوزت حصيلة المصابين عالمياً حاجز 45 مليون إصابة وأكثر من 1.2 مليون وفاة؛ وفي ظل هذه التطورات والظروف الاستثنائية فرضت بعض القضايا نفسها بحدة، ولعل أبرزها ما يرتبط بمسألة دور القيادة السياسية للدول.
لم تكتف أزمة كورونا، الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ببعثرة وإعادة خلط جميع الأوراق في حياة كل واحد منا وجعلنا مشتتين بين المخاوف الصحية والاقتصادية، بل دفعت بنا أيضًا إلى معترك تساؤلات حول سلوك السياسيين الذين ائتمناهم على سلامتنا. وبعد كل ما حصل، وعندما أصبح مستقبل الأفراد والمجتمعات في الميزان، فإن هذه الأزمة الكبرى تُعتبر اختباراً حقيقياً للقيادات الجيدة (والرديئة).
لقد كشف التفاوت في معايير الجودة التي طبقتها الدول المختلفة في إدارتها للجائحة – في غضون شهور – وجود علاقة ارتباط قوية بين عوامل أساسية محددة من بينها: النوع الاجتماعي (الجندر)، ونظم الحوكمة، ومدى اهتمام القادة بقضايا عامة الشعب، وشخصية الأفراد الذين يشغلون مناصب مهمة وطرق تفكيرهم وخلفياتهم، وكل هذه العوامل والمحددات حسمت مستويات ودرجات نجاح الدول في كبح انتشار جائحة كوفيد-19.
في الوقت الراهن، ما تزال، الأولوية – بحكم غياب لقاح فعال – مركزة على احتواء التفشي الوبائي. وتستلزم هذه المهمة قيادات تستطيع إدارة ذلك التوازن الصعب بين حاجة تقييد تواصل البشر، وخطر الإضرار الدائم بالاقتصاد، وإيذاء العلاقات الاجتماعية، والتأثير على الصحة النفسية للناس. والواضح أن عدد القادة الذين أداروا الأزمة بكفاءة، ومهارة، وذكاء عاطفي هم قلة قليلة.
رغم بساطتها الظاهرية، فإن “القيادة” تتسم بكونها مفهوم زئبقي. فقد تم تعريفها مثلا، باعتبارها “فن تعبئة الآخرين وترغيبهم في الصراع من أجل طموحات وتطلعات مشتركة”. وشدد آخرون – في هذا – على أهمية الشخصية الفردية للقائد، وقدرته على فهم ما يحرك الناس، وإنجازاتهم، وإخفاقاتهم. فيما ركز آخرون على العلاقة بين القادة والأتباع التي يميل ميزان القوة فيها لصالح القادة، ويختار الأتباع أو يجبروا على وضع سعادتهم، وحياتهم – في حالات كثيرة – بين أيدي قادتهم.
عند تقييم جودة القيادة، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار جوانب إدارة العمليات، والأهداف، وسيكولوجيا العلاقة بين الحاكم والمحكوم. فالقيادة السياسية تختلف عن معظم أشكال القيادة الأخرى، لأنها تتعامل مع عدد من القضايا التي تتسم بضبابيتها وطبيعتها غير المحسومة، وتتفاوت بين قضايا عادية روتينية وقضايا مصيرية تتعلق بالحياة والموت، وتكون دائماً على مرأى ومسمع المتخصصين والعامة.
يوجد في الدولة الديموقراطية ملايين من “المشغلين” الذين يقررون دوريًا، في وقت الانتخابات، ما إذا كانوا سيحتفظون بـ “عقدهم” مع القيادة الحالية أو يستبدلونها لتحل محلها قيادة أخرى. ولكن، إذا كانت السلطة في أيدي الأتباع في يوم الانتخابات لتحديد مدة بقاء الحكومة، فإن كفة الميزان تميل بقوة لصالح القادة الذين يكونون في كل الأحوال مجبرين على مراقبة المزاج الشعبي باستمرار حتى وإن كان الهدف فقط هو التلاعب بالرأي العام أو استغلاله.
يمكن تصنيف القيادة وفق التقسيمات التالية: ديموقراطية في مقابل دكتاتورية، وإدارية في مقابل أيديولوجية ملهمة، وقيادة تركز على إنجاز المهمة في مقابل تلك التي تهتم بتطوير مهارات الناس، وقيادة معاملاتية في مقابل القيادة التحويلية. إن هذه الأنماط ليست حصرية، وأي قائد أو قيادة يمكن أن يختار العمل بواسطة مجموعة من هذه الخصائص. وعلاوة على هذا، هناك جدل لا يعرف نهاية حول ما إذا كانت الخصائص القيادية فطرية أم مكتسبة، مع وجود الكثير من المناهج والدورات، وما لا يُحصى من الكتب حول تطوير الذات تتناول هذا الموضوع.
ومع أن العديد من مهارات القيادة مثل: تحديد أهداف واضحة، والتخطيط، والعمل بروح الفريق، ومهارات التفاوض، وصناعة القرارات المركزة والفعّالة، أو حتى الإصغاء المتيقظ، يمكن أن تُكتسب من خلال التعلّم والتجربة (الخبرة)، فإن هناك مهارات أخرى مثل الكاريزما (الجاذبية)، والحزم (حسم المواقف)، والمخاطرة، والتعاطف، يمكن تحسينها لدى الأشخاص الذين يمتلكون هذه السمات أصلاً.
هناك مبالغة في التبسيط عند إجراء مقارنة بين القيادات العالمية الحالية من خلال ربطهم ببساطة بإحصائيات حول مدى شدة تفشي الجائحة في بلدانهم؛ ومع ذلك فإن هذه المسألة توفر مؤشراً جيداً جداً. يُنظر إلى الجائحة عادة باعتبارها وضع يتضمن عناصر مفاجئة، وتهديداً للمصالح الحيوية. وهي تتيح لصانعي القرار القليل من الوقت لتشكيل رأي، وصناعة قرار، والتصرف على أساسه. ومعظم الحالات المشابهة تتضمن قرارات حياة أو موت.
كانت إحدى الأزمات التي حظيت بدراسات مكثفة ومرهقة في التاريخ الحديث، أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، عندما قام الاتحاد السوفييتي بنصب قواعد صواريخ نووية على مسافة تبعد عن البر الأمريكي بـ 90 ميلاً فقط، أي أن صواريخ الاتحاد السوفييتي كانت على عتبة غريمه الرئيسي في الحرب الباردة. وبين اكتشاف القواعد الصاروخية السوفييتية، ووقت التركيب المحتمل للصواريخ لم يكن هناك سوى وقت قصير جداً متاح أمام إدارة الرئيس كينيدي.
فرض ضيق الوقت على إدارة الرئيس كينيدي التعامل مع هذا التهديد الجاثم على عتبة بيتها بأسلوب لا يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة يمكن أن تؤدي إلى إبادة الجنس البشري. وقد اتسم التعامل مع الأزمة بالتعقل من قبل الطرفين، الرئيس جون كينيدي عن الجانب الأمريكي، ورئيس الوزراء نيكيتا خروتشوف عن الجانب السوفييتي، وحظيت جهودهما بالترحيب والثناء. كما وُصفت التسوية بأنها رائعة في تجنّب كارثة لا يمكن تخيل فداحتها.
وقد سلك كينيدي بهدف معالجة هذه الأزمة مساراً غير تقليدي وجمع فريقاً خاصاً لدراسة كيفية التعامل معها، وأتاح له حرية استنباط مجموعة من الخيارات، وإجراء تحليل دقيق لمزايا ومخاطر كل خيار منها. والنقطة الجوهرية، أن فريق كينيدي أبقى جميع الخيارات مفتوحة، واستمرت عمليات الاستخبارات في رصد أي تطورات. وقرر الفريق، في نهاية المطاف، محاصرة كوبا ومنع السفن الروسية من دخول الموانئ الكوبية، وكان هذا الخيار هو الأقل صدامية، وأوصل لموسكو تصميم واشنطن على تجنب تهديد الأسلحة النووية المنصوبة قرب شواطئها.
إن مستوى خطورة الأزمة التي رافقت الجائحة العالمية الحالية يفرض مجموعة جديدة من التحديات، لأن العدو في هذه الأزمة غير تقليدي وغير مرئي. وفي مجال الصحة فإن “سباق التسلح” حالياً يسبق كثيراً الأجوبة والحلول التي وضعتها معظم الدول في ترساناتها الطبية. ولكننا شهدنا كيف أن قيادات معينة تعرفت على الخطر الذي يشكله هذا الفيروس القاتل في مرحلة مبكرة. وكانت تلك القيادات مستعدة لأن تتحرك بسرعة وتتخذ إجراءات لا تحظى بقبول شعبي ولكنها ضرورية، مثل إغلاق حدودها مع الدول المجاورة، وفرض إغلاق شامل (للأسواق والمحلات والمدارس….).
ونتيجة لتلك الإجراءات الحازمة، نجحت تلك الدول القليلة في احتواء انتشار الفيروس بشكل أفضل من الدول الأخرى التي بدلاً من مواجهة الأزمة بالاعتماد على نموذج واضح لصناعة القرار والتصرف بناء على النصائح العلمية، فقد استهترت بالوضع وانغمست في تفاؤل لا أساس له ولا مبرر. وأمثال هؤلاء القادة أظهروا قلقاً أكبر بشأن التأثير الفوري على اقتصادهم، والأشياء التي يمكن أن تزعج جماهير الناخبين، أو الأحزاب السياسية، أو شرائح معينة من وسائل الإعلام.
كما ظل هؤلاء، في الوقت ذاته، في حالة إنكار كامل لحقيقة أن العالم يواجه الآن مأزقاً خطيراً جداً وغير مسبوق. ليس هناك أي دولة حتى الآن استطاعت أن تهزم هذه الجائحة الرهيبة، ولتحقيق الانتصار الحقيقي على الفيروس فإن الأمر يتطلب إيجاد لقاح فعّال يكون متاحاً للجميع. ولكن بعض الدول كانت محظوظة بدرجة كافية لأن تنعم بوجود قيادة تمتلك الكفاءة والشجاعة والمؤهلات اللازمة حيث نجحت في السيطرة على انتشار الجائحة، بدلاً من الاستسلام لسيطرة الفيروس.
هناك ما يشجع على القول إن الحكومة الأكثر استبدادية يمكن أن تكون مؤهلة ومستعدة أكثر من سواها لاحتواء تهديد مشابه لجائحة فيروس كورونا؛ لأنه يُتوقع من كل فرد من الشعب أن يطيع أوامر الحكومة، ويمكث في البيت، ويتجنب التواصل مع الآخرين. وكانت الصين المثال الأبرز على ذلك، حيث انطلقت الجائحة من الصين، ولكن بكين طبقت إجراءات سريعة وحازمة، واستطاعت تقليل عدد المصابين بالفيروس.
وقد وصل عدد المصابين بـفيروس كوفيد-19 في الصين إلى مستواه الحالي بواقع 20 إصابة جديدة يومياً بسبب هذه الإجراءات، وهذا العدد يُعتبر ضئيلاً جداً عندما نأخذ في الاعتبار ضخامة إجمالي سكان هذه البلد ذي الكثافة السكانية العالية. وتبقى الصين مجرد مثال واحد، ولكن هناك بعض الدول الديموقراطية تكيّفت مع الأزمة الصحية الحالية بشكل جيد، وتعاملت مع الوضع دون فرض قيود على معظم الحقوق المدنية وحقوق الإنسان.
الأمر المثير للاهتمام، أن هذه الدول التي نجحت في احتواء الجائحة – في معظمها – تعمل تحت قيادة نساء. وهناك تحليل لأوضاع 194 دولة، في تقرير منشور من قبل مركز البحث الاقتصادي والمنتدى الاقتصادي العالمي أوضح أن الدول التي تقودها نساء حققت نتائج “أفضل منهجياً وجوهرياً” في مواجهة جائحة كوفيد-19 من خلال الرد السريع والإغلاق المبكر. وهذه الدول عانت حالات وفيات بلغت – في المعدل العام – نصف عدد الوفيات التي تكبدتها الدول التي يقودها رجال.
في الوقت الحالي، ما يزال نجاح القيادة الجيدة في معالجة أزمة فيروس كورونا مسألة نسبية، وما يزال هناك رحلة طويلة لاجتثاث الفيروس أو على الأقل تقليص تأثيراته على حياتنا اليومية. ومع ذلك، فقد ظهرت في بقعة الضوء أنجيلا ميركل الألمانية، وجاسيندا أرديرن النيوزيلاندية، وتساي إينغ-وين التايوانية، وميتي فريدريكسين الدانماركية، وسانا مارين الفنلندية، بسبب مواقفهن الحازمة، والتعامل بذكاء عاطفي مع شعوبهن لمواجهة الجائحة.
وقد أظهرت دراسة من إعداد سوبريا جاريكيباتي (جامعة ليفربول) وأوما كامبهامباتي (جامعة ردينغ) أن مهارات صناعة القرار مسألة أساسية وضرورية للتعامل مع الأزمة الصحية، مثل البراغماتية، والنزعة إلى الخير، وهذه المزايا تبدو أكثر شيوعاً بين النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية. وعلاوة على هذا، فإن خصائص المرونة، والبراغماتية، والتعاطف، والثقة، والغيرية/الإيثار، والحس السليم الجماعي، والتواضع مزايا مطلوبة في ظرف شديد التعقيد كما هي الحال في جائحة فيروس كورونا. وحسب نتائج هذا البحث فإن هذه المزايا شائعة بين النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية، وبفضل هذه المزايا تحقق نجاحهن.
هنا لا نقصد القول إن القادة الذكور يفتقرون إلى هذه المواصفات والمهارات. ولكن المجتمعات التي تنتخب نساءً لمناصب قيادية توفر فرصاً متساوية لجميع الناس أكثر من سواها، وهذا يتيح المجال لمنظور أوسع لشؤون حياة الشعب، بما في ذلك التصرف في أوقات الأزمات. وهذا المنظور يتيح تمثيلاً أفضل للمجتمع في مراكز السلطة؛ وهذه الميزة مفقودة في معظم الدول الأخرى.
إن الفوز الساحق لجاسيندا أرديرن في الانتخابات العامة الأخيرة في نيوزيلاندا يشهد على تأييد الناخبين للطريقة التي تتبناها في إدارة البلاد. وخلال ثلاثة أعوام هي فترة وجودها في المنصب (رئيسة الوزراء)، واجهت عدداً من الأزمات أكثر مما يواجهه بعض القادة طوال حياتهم. واجهت جاسيندا:
- أزمة الهجوم الإرهابي المروع على مساجد في مدينة كرايستتشيرش؛
- وأزمة اندلاع بركان في وهاكاري؛
- ثم أزمة جائحة فيروس كوفيد-19.
وكان منهج جاسيندا مدروساً ومبنياً على نصائح خبراء متخصصين، ولكن في الوقت ذاته كان منهجاً مرنًا بالطبيعة والفطرة، وهذا يثبت أن هاتين الميزتين لا تتعارضان في ما بينهما، بل يجب أن تسيرا معاً يداً بيد.
إن زيارة جاسيندا للمساجد المدمرة واحتضان عائلات الضحايا تم تدعيمها في الواقع العملي بخطوات لاحقة منها: إصدار حظر فوري على حيازة الأسلحة النارية شبه الأوتوماتيكية. كما تم إغلاق حدود البلاد بناء على نصيحة من العلماء في الأيام الأولى لاندلاع جائحة كوفيد-19، عندما كان عدد المصابين بالفيروس ضئيلاً جداً. وترافق ذلك مع إعلان اسم كل مواطن نيوزيلاندي وقع ضحية للفيروس بناء على مفهوم يؤكد أن الضحية هو أكثر من مجرد رقم في إحصاء.
بصورة مشابهة، وللسنة الثالثة على التوالي، وجد استطلاع الرأي العالمي (جالوب Gallup) الذي شمل 135 دولة، أن ألمانيا هي الدولة التي تحظى بأكبر إعجاب وتقدير بفضل قيادتها العالمية. ويُعزى هذا التقدير، في معظمه، إلى المستشارة أنجيلا ميركل، التي ما تزال على رأس السلطة منذ 15 عاماً. وقد برز أسلوب ميركل في القيادة، الذي يميل إلى كونه أسلوب تقليدي، في عالم يعاني من وباء القادة الوطنيين الشعبويين الذين يركزون اهتمامهم على تسجيل نقاط رخيصة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أكثر من الاعتناء برفاهية شعوبهم وتوفير حياة كريمة لهم.
لقد رفضت ميركل المناخ الثقافي والأخلاقي والفكري السائد بين القادة الذين يصلون إلى السلطة ويحتفظون بها بالمكر، وزرع الانشقاق، والوحشية، والسطحية في خطابهم الموجه إلى الشريحة الأدنى التي تحمل سمات مشتركة لأغلبية الناس. أثبتت ميركل أنها نقيض أولئك الرجال، من خلال منهجها المستقيم والتحليلي، وهذا المنهج أصيل في خلفيتها العلمية؛ وليس وسيلة لاجتذاب أو إرضاء قاعدة تأييد شعبي أسطوري. وهي مستعدة لممارسة القيادة المتميزة والمقدمة، وتتجنب الارتجالية في معالجة القضايا الصعبة، وهي تسلك الدرب الذي تؤمن بأنه الصحيح لمصلحة بلادها والعالم أجمع.
سواء كان ذلك يقود للأفضل أو الأسوأ، فإن هذه الجائحة كشفت قيادات وأظهرت مهاراتها وكفاءاتها، أو افتقارها لهذه المهارات والكفاءات. ولم يتضح بعد ما إذا كان الجواب على السؤال العظيم سيكون أقرب إلى نقطة الحسم – عندما يعود العالم إلى درجة معينة من الحالة الطبيعية – لكي نعرف ما هي المزايا والمهارات التي تصنع قائداً جيداً وقيادة جيدة. ولكن فيروس كوفيد-19، الذي قلب حياتنا رأساً على عقب، قدّم لنا عدة مفاتيح مفيدة لفك رموز اللغز ومعرفة ما هو مزيج الخصائص والمهارات الذي ينتج قائداً جيداً وناجحاً.