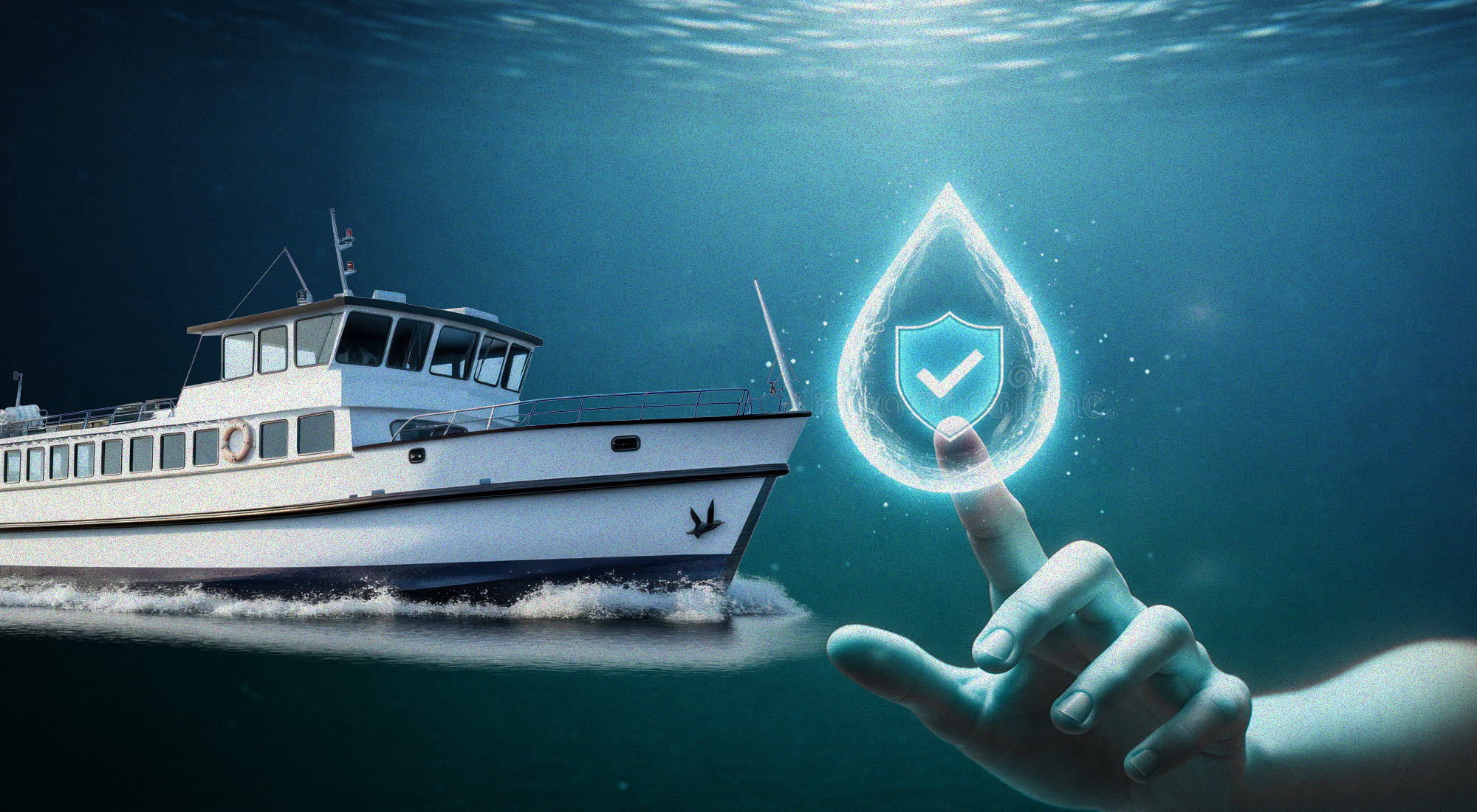على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، لولا جائحة “كوفيد-19” التي ضربت العالم على مستويات عدة، لكان الخطاب العالمي تهيمن عليه، لأسباب وجيهة، مسألة كيفية احتواء الكارثة المحتملة التي يهدد تغيرُ المناخ العالمي بجلبها. وبعد ظهور بطلة شابة وغير متوقعة، هي المراهقة السويدية “غريتا ثنبرغ”، لقيادة الهجوم، ليس ضد المشككين في تغير المناخ والرافضين له فقط، بل وبقوة أكبر ضد السلوك غير المبالي بتغير المناخ أيضاً، بدأت حركة عالمية للتصدي للاحترار العالمي [ويقال الاحتباس الحراري أيضاً] تكتسب زخماً كبيراً. ولا تستقي هذه الحركة إلهامها من الشباب الذين يريدون إسماع أصواتهم والتحرك فحسب، بل ومن البالغين أيضاً.
ومما لا شك فيه أن عزم “ثنبرغ” وفصاحتها وشجاعتها أمور أسرت قلب العالم، بيد أن توقيت ظهورها على الساحة العالمية، بالتزامن مع تزايد الأدلة العلمية المقترنة بالتجارب المجتمعية المتزايدة بشأن أثر الاحترار العالمي، هو ما ساعد على تهميش أي شك في كون تغير المناخ حقيقة قائمة من صنع الإنسان وتشكل تهديداً لمستقبل الأرض ومعه البشرية كما نعرفها، وهو ما ساعد على القضاء على ذلك الشك بالكامل أيضاً.
وفي نهاية شهر أكتوبر، سوف تستضيف المملكة المتحدة الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، وهو مؤتمر قمة وصفه كثيرون بأنه الفرصة الأخيرة لاحتواء التغير المناخي وإنقاذ العالم. وقد مرَّ نحو 50 عاماً على أول قمة بيئية دولية، وهي تحديداً مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الذي عُقد في عام 1972 في استوكهولم، وأعقبه بعد ذلك بسبعة أعوام المؤتمر العالمي الأول بشأن المناخ، في جنيف. وقد كانت تلك الـ 50 عاماً مهدورة من حيث تغيير عاداتنا وأساليب حياتنا المضرة بيئياً وتفادي الأزمة التي نعيشها اليوم. والنتيجة أن اتخاذ تدابير جذرية أصبح اليوم أمراً حتمياً ويتطلب منا تغييراً يكاد يكون فورياً في سلوكياتنا وأنشطتنا اليومية.
وقد حذرت قمة مناخية تلو الأخرى – بدءاً من قمة ريو في عام 1992، ومروراً ببروتوكول كيوتو لعام 1997، وانتهاءً باتفاق باريس لعام 2015 – صراحةً من أن انبعاثات غازات الدفيئة في صعود سريع، وهي تتسبب في تغيرات في مناخ كوكبنا ستفضي إلى نتائج متزايدة الضرر. وعلى الرغم من ذلك، اختار العالم النمو الاقتصادي، ولكنه كان النوع القديم من النمو غير المستدام. وفي هذه المرحلة من مراحل التاريخ، بلغت البشرية نقطة في علاقاتها مع الطبيعة حيث لم يعد مجال لأي شكل من أشكال الإنكار لتغير المناخ أو تأجيله، والكارثة آتية لا محالة ما لم يتخذ قادة العالم خطوات حاسمة للتصدي لهذه الحالة الطارئة وحشد بلدانهم لوقف الاحترار الحراري البشري المنشأ.
وكما لو كان الأمر مقصوداً، فقد قررت الطبيعة أن تَعرض الآثار الشديدة لتغير المناخ في أجزاء مختلفة من العالم هذا الصيف. فقد أدت موجات حرارة غير مسبوقة ومميتة في شمال شرق أمريكا إلى تحطيم الرقم القياسي لدرجة الحرارة في كندا بواقع خمس درجات مئوية، وفي الولايات المتحدة، فاقت درجة الحرارة في ولايتيْ واشنطن وأوريغون متوسطها بنحو سبع درجات مئوية، ما تسبب في حرائق هائلة في الغابات ومصرع أكثر من 600 شخص. وأدت فيضانات هائلة في الصين وغرب أوروبا إلى مزيد من الدمار بعد عواصف ممطرة حطمت الأرقام القياسية، وهطول أمطار موسمية مروعة في الهند، جميعها خلَّفت المئات من الأرواح وقدراً هائلاً من الدمار. وإضافةً إلى ذلك، تضاعف منذ ثمانينيات القرن العشرين عدد الأيام الشديدة الحرارة في العام حيث تبلغ درجة الحرارة 50 درجة مئوية، مع العلم أن الجزء الأكبر من هذه الأيام تشهده منطقة الشرق الأوسط.
وفي الواقع، إن إنكار تغير المناخ يخص فئة محدودة، وإن كانت فئة ذائعة الصيت. ووفقاً للجمعية الأمريكية لتقدم العلم (AAAS)، “خلص ما نسبته 97 في المئة من علماء المناخ إلى أن تغير المناخ البشري المنشأ واقع ملموس”، ما يقود إلى تغيرات مفاجئة وغير قابلة للتنبؤ بها وربما لا رجعة فيها في نظامنا المناخي، مع ما لذلك من آثار بالغة الضرر. وقبل عامين، وقَّع 11258 عالماً من 153 بلداً رسالةً يعبِّرون فيها عن التزامهم الأخلاقي بتحذير البشرية من الخطر الكارثي لتغير المناخ والتنبيه إلى ضرورة إعلان حالة الطوارئ. ولم يُخْفِ هؤلاء العلماء المرموقون رأيهم بأن أزمة المناخ وثيقة الصلة بـ”الاستهلاك المفرط لنمط الحياة القائم على البذخ”. وإذا ما أريد وضع خطة عمل جادة للتصدي لتغير المناخ وعواقبه، فإن البلدان الغنية، المسؤولة أساساً عن الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة، هي من تقع عليه مسؤولية تغيير عاداته المتصلة بالإنتاج والاستهلاك التي تلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالبيئة.
وعلى مدار القرن الماضي، ونتيجة لإحراق الوقود الأحفوري والاضطلاع بالعديد من الأنشطة البشرية الأخرى – منها أساساً المستويات المفرطة في استهلاك الغذاء والمياه – شهدت معدلات تركيز غازات الدفيئة، بما فيها ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز – ارتفاعاً هائلاً. وحسبما أفادت به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، يجب أن تتراجع غازات الدفيئة إلى مستوى الصفر في تاريخ لا يتعدى عام 2070، ويفضَّل قبل ذلك، كي تصبح الفرصة سانحة لخفض الاحترار العالمي بواقع أكثر من درجتين مئويتين (وإن كان الهدف المثالي هو التخفيض بأكثر من 1.5 درجة)، مقارنةً بمستواه ما قبل الثورة الصناعية، كما اتُّفق عليه في اتفاق باريس لعام 2015 الملزم قانونياً الذي اعتمده 196 بلداً.
وعلى الرغم من السلامة العلمية التي تتسم بها توصيات الخبراء، فهي مدمِّرة من الناحية السياسية. فعلى سبيل المثال، هي لا تدعونا إلى تحقيق الاستقرار في عدد سكان العالم فحسب، بل وإلى خفض هذا العدد. وثمة خطوات أخرى مطلوب منا اتخاذها – من قبيل استخدام أنواع الطاقة الأكثر مراعاة للاعتبارات البيئية، وتغيير نمطنا في الاستهلاك الغذائي، والعادات التصنيعية والاستهلاكية، واستعادة النظم الإيكولوجية للأرض – يُحتمل أن تلقى مقاومة من أصحاب المصالح الاقتصادية المكتسبة، وإن أُحرز تقدم كبير بشأن هذه المسائل في بعض أجزاء من العالم. بيد أن هذا التقدم يظل غير كافٍ، سواء من حيث وتيرته أو من حيث عدد البلدان التي تعتمد تلك التغييرات. ولكن ما البديل؟ تقطع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقريرها لهذا العام بأن “التأثير البشري أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي والمحيطات واليابسة. وطرأت تغيرات واسعة النطاق وسريعة في الغلاف الجوي والمحيطات والغلافيْن الجليدي والحيوي”، وتشير الأدلة إلى أن الاحترار العالمي يسير في اتجاه تصاعدي منذ منتصف القرن التاسع عشر. ولهذا نتائجه المباشرة وغير المباشرة على السواء، ليس على مستوى ارتفاع درجات الحرارة فقط، وارتفاع منسوب مياه البحار، وارتفاع درجات حرارة المحيطات، وانكماش الأنهار الجليدية، وتزايد التهطال [ويقال الهطل والهطول والتساقط] الغزير على النحو الذي شهدناه هذا العام، بل من حيث تزايد الجفاف وموجات الحر الشديد أيضاً.
ونتيجة لذلك، ثمة خطر بأن يرتفع منسوب مياه البحر إلى مدى تصبح معه مناطق ومدن كبرى بالكامل مغمورة بالمياه. والتصدي للاحترار العالمي لا يتعلق بالتخلص من مضايقة، بل بتفادي خطر وجودي. ذلك أن نحو 1.2 مليار من سكان العالم قد يعانون حالات الإجهاد الحراري [ضربة الشمس] بحلول نهاية هذا القرن إذا لم تُوقَف المستويات الحالية للاحترار العالمي، وذلك وفق ما جاء في دراسة أعدتها جامعة “روتجرز” ونُشرت العام الماضي. وأبرزت الدراسة كيف أن الاحتباس الحراري “يلحق الضرر بصحة الإنسان والزراعة والاقتصاد والبيئة من منظور أوسع”. وبصورة أعم، سيؤثر سلباً على إمداداتنا من الغذاء في وقت يضطر فيه المزارعون للتعامل مع أحوال جوية قاسية وغير قابلة للتنبؤ بها، ما يؤدي إلى الجفاف والفيضانات وانحسار الأراضي الخصبة.
وقادة العالم الذين يحضرون الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف تقع على عاتقهم مهمة هائلة، على اعتبار أن ثمة حاجة لاتخاذ تدابير فورية وجذرية. ومع ذلك، يبدو أن الأمر أقل صعوبة مما كان عليه طوال فترة طويلة نظراً لانتشار الوعي بمدى شدة الموقف. فقد أصبح هناك إقرار أكثر من أي وقت مضى بأننا بلغنا اللحظات الأخيرة حيث لا يعود أمامنا خيار سوى التحرك، وبسرعة. ومن غرائب السياسة في عصرنا الحديث أن احتمال وضع خطة عمل تتناسب مع جسامة الموقف وتضم خطوات حسنة التوقيت وقابلة للتنفيذ يزداد عندما يصل الموقف إلى نقطة حرجة. في الوقت الحالي، تُعتبر الغايات التي يروجها “ألوك شارما”، رئيس الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، مبهمة للغاية وغير ملزمة بحيث إنها تكاد لا تسوغ البصمة الكربونية لعشرات الرحلات الجوية التي استخدمها لزيارة البلدان المشاركة في القمة. بيد أنه بغض النظر عن الجوانب الفنية المفرطة من قبيل تلك الواردة في اتفاق باريس، يُنتظر أن يحتل التحول إلى السيارات الكهربائية، وحماية الغابات، والتخلي التدريجي عن توليد الطاقة باستخدام الفحم، وتنويع الموارد لدى الفئات الأكثر تضرراً بتغير المناخ، مكاناً بارزاً على جدول أعمال الاجتماع.
وقد عبَّرت غريتا ثنبرغ عن الفجوة بين خطاب قادة العالم بشأن الاحترار العالمي وكيفية تحول هذا الخطاب إلى تحركات ملموسة في كلمتها الأخيرة – وكانت سديدة كعادة كل كلماتها – التي ألقتها خلال قمة “شباب من أجل المناخ” في ميلانو، حيث اتهمت أولئك القادة بـ”إغراق آمالنا وطموحاتنا في وعودهم الفارغة”. ذلك أن تحقيق الغايتين اللتين حددتهما الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف والمتمثلتين في خفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية إلى مستوى الصفر بحلول منتصف القرن، والحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة على المدى الطويل بواقع 1.5 درجة مئوية فوق مستواه ما قبل الثورة الصناعية، يتطلبان توصُّل الساسة المجتمعين في غلاسغو إلى توافق في الآراء، وبالأخص ضمان أن يقبل المساهمون الرئيسيون في انبعاثات غازات الدفيئة بأن الجزء الأكبر من مسؤولية تنفيذ التغييرات المطلوبة يقع على عاتقهم هم قبل غيرهم.
ويعني ذلك التصديَّ لبعض المصالح الاقتصادية القوية والراسخة في بلدانهم، بما في ذلك العديد من الشركات المتعددة الجنسيات، سواء في قطاع الطاقة أو إنتاج الغذاء أو صناعة السيارات، حيث ينبغي أن تُعطى الأولوية للانتقال صوب التنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال، يضع تزايد سكان العالم والتحضر وتغير العادات الغذائية بسبب النمو الاقتصادي ضغوطاً على ما تسميه الأمم المتحدة “الترابط بين المياه والطاقة والغذاء”. ذلك أن الطلب على كل من هذه العناصر الثلاثة في ازدياد مستمر، وسيتعين على الزراعة – وهي أكبر مستهلك على الكوكب للمواد من المياه العذبة، وهي تستخدم أكثر من ربع الطاقة المنتجة عالمياً بينما تشكل أحد أكبر التهديدات للتنوع الأحيائي [ويقال البيولوجي] – أن تتكيف مع أساليب الإنتاج الجديدة التي تفضي إلى إنتاج أقصى قدر من السعرات الحرارية والبروتين لكل وحدة مستخدمة من الأرض والمياه والطاقة.
ومن الواضح أن ثمة حاجة إلى تغير نفسي إلى جانب الخطوات العملية التي نتخذها لتغيير عاداتنا. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إبراز الفرص الكامنة في التحول نحو عالم أكثر مراعاة للاعتبارات البيئية بدلاً من الاكتفاء بالتركيز على المخاطر المتأتية من عدم القيام بذلك. ذلك أن معظم الرسائل بشأن تغير المناخ كانت مزيجاً من التحذيرات من الكارثة الآتية ولعبة تبادل اللوم الموجه نحو مَنْ لا يتحملون ما يكفي من المسؤولية للحيلولة دون وقوع الكارثة. وعلى مدى عقود، أدى بنا الاستهلاك الكبير الحجم إلى الميل إلى خفض أسعار السلع غير المعمِّرة، وفي الوقت نفسه استغلال العمالة الرخيصة والموارد الطبيعية. ويرتبط النمو الأخضر (أي المراعي) للاعتبارات البيئية باعتماد النهج المعاكس تماماً، بالاقتران بتدريب عمالة أكثر مهارة وبزيادة الربحية.
وفي إطار تخطّي التركيز على المزايا البيئية للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والمراعية للبيئة، لا بد من إبراز الآفاق الكبيرة للنمو الاقتصادي والتجاري العالمي. ذلك أن الخطاب البيئي كثيراً ما حكمته فرضية كاذبة مفادها أن المصلحتين البيئية والتجارية تقفان على طرفيْ نقيض. ويُستقى هذا النهج أساساً من اجتماع ضغط المصالح الاقتصادية والكسل الفكري.
بيد أن الأدلة تشير إلى أنه لدى مقارنة تكلفة احتواء العواقب الكارثية المتزايدة للاحترار العالمي بالمزايا المكتسبة من الانتقال إلى مجتمع أكثر مراعاة للاعتبارات البيئية، فإن المزايا الاقتصادية لهذا الأخير أكبر وأكثر فائدة لكوكب الأرض. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الحد من الاحترار العالمي وفي الوقت نفسه حماية مجتمعاتنا وموائلنا الطبيعية ببناء دفاعات طبيعية وإرساء أنظمة إنذار وبنى تحتية وأساليب زراعية قادرة على الصمود لتفادي فقدان البيوت وسبل العيش والأرواح، لا تقل عن 100 مليار دولار. ومن ناحية أخرى، ثمة وعي متزايد لدى الشركات بشأن المخاطر التي تواجهها بسبب تغير المناخ، وكذلك بشأن مزايا الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومراعٍ للاعتبارات البيئية.
وقد كشفت دراسة استقصائية أجراها “مشروع الكشف عن الكربون” (CDP) على 215 من أكبر الشركات في العالم أنه بينما تتوقع تلك الشركات أن تبلغ قيمة المخاطر المتأتية من أثر تغير المناخ في المستقبل القريب 1 تريليون دولار، فإنها تتوقع أن تبلغ قيمة الفرص 1.2 تريليون دولار، وأن القيمة المحتملة للفرص التجارية المستدامة تفوق بنحو سبعة أضعاف تكلفة تحقيقها. ولا تمثل الاقتصادات الحديثة والمستدامة التي تتسم بالنمو المراعي للاعتبارات البيئية تحولاً في نوع السلع التي نستهلكها فحسب، وإنما في طبيعة الاستهلاك ذاتها أيضاً، صوب نمط أقل هدراً. وثمة أخبار أفضل للمجتمعين في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ذلك أن الاستقصاءات العالمية تقطع بأن ثلثيْ المستهلكين على استعداد لدفع مبالغ أكبر مقابل الحصول على المنتجات المستدامة، وكل ما يحتاجونه هو وجود من يقود هذه المسألة والفرصة للقيام بذلك.
ولعل الأجيال القادمة – على افتراض أنها، ونحن معها، ستتجاوز أزمة تغير المناخ – ستتساءل عن الأسباب التي جعلتنا نحن البشر، بالنظر إلى التقدم الكبير الذي حققناه على كثير من الصُّعُد لدرجة أننا نضاعف معارفنا مرة كل 13 شهراً، نتجاهل العلم لكل هذه الفترة الطويلة بحيث إننا وصلنا إلى حافة الهاوية. وبالنسبة إلى قمة الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، فإن الخيار بسيط، وهو، في سياق الاحترار العالمي، اتباع المقولة الحكيمة لـ”مارتن لوثر كينغ جونيور”، الذي أطلق تحذيره قبل سنوات عدة وفي سياق مختلف بالقول “علينا أن نتعلم العيش معاً كأخوة، أو أن نفنى معاً كحمقى”.