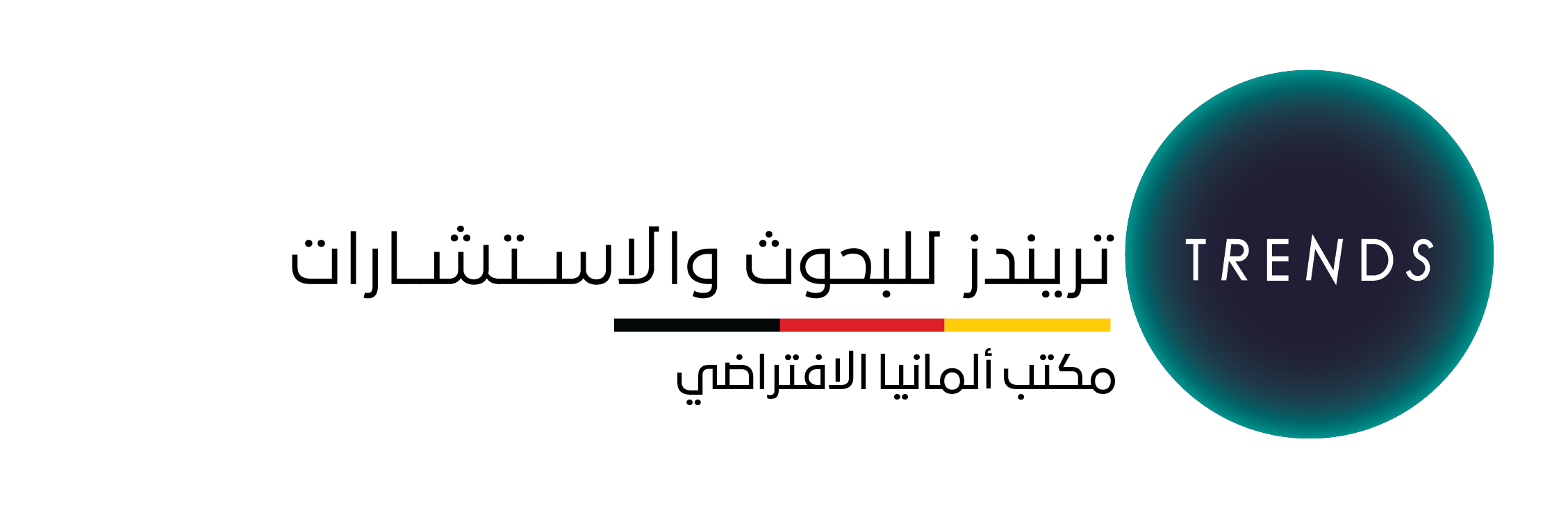يأتي تقرير ميونيخ للأمن 2025 في سياق عالمي يشهد اضطرابات متزايدة، حيث تتنامى الاتجاهات نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، ما يخلق فرصًا وتحدياتٍ في آنٍ واحد. يتناول التقرير هذه التحولات بعمق، مستعرضًا الانقسامات الداخلية في الدول الكبرى، والاستراتيجيات المتغيرة للقوى الناشئة، ومستقبل النظام العالمي في ظل تصاعد المنافسة الجيوسياسية.
من بين الموضوعات الرئيسية، التي يناقشها التقرير، تراجع الأحادية القطبية في عالم ما بعد الحرب الباردة، والصراع بين النماذج الديمقراطية والنماذج التي يصفها التقرير بـ”الاستبدادية” للحكم، بالإضافة إلى تداعيات الاستقطاب الأيديولوجي العالمي. كذلك، يسلط الضوء على دور الترابط الاقتصادي في تشكيل القرارات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أنه رغم استمرار العولمة كقوة رئيسية، فإن تفكك سلاسل التوريد، وتصاعد النزعة الاقتصادية القومية يضيفان مزيدًا من الشكوك وعدم اليقين.
ويؤدي تصاعد السياسات القومية والحمائية التجارية إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية؛ ما يجعل التعاون في مواجهة التحديات العالمية الملحة أكثر صعوبة. وفي ظل تراجع التعددية، وإضعاف المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، يصبح المشهد العالمي أكثر تعقيدًا؛ ما يستدعي مقاربات جديدة للحفاظ على الاستقرار والتعاون الدولي.
أولًا: مفهوم التعددية القطبية وتطورها
يشير التقرير إلى أن “التعددية القطبية” لم تعد مجرد نظرية، بل أصبحت واقعًا ملموسًا مع تزايد عدد الفاعلين الدوليين القادرين على التأثير في القضايا العالمية. ويتجلى ذلك في الأدوار المتنامية لقوى مثل الصين والهند والبرازيل، إلى جانب قوى إقليمية أخرى تسعى إلى تعزيز نفوذها على الساحة الدولية. ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن هذا التحول لا يسير بسلاسة؛ إذ تصاحبه صراعات على النفوذ وتوترات متزايدة بين اللاعبين الرئيسيين.
أيضًا، يؤدي صعود التعددية القطبية إلى تصاعد الصراعات الأيديولوجية بين نماذج الحكم المتنافسة؛ ما يؤثر في التعاون الدولي في قضايا حيوية، مثل تغير المناخ، والتنظيم الاقتصادي، والتحالفات الأمنية. ويرى التقرير أن هذا المشهد الجديد يعيد تشكيل التحالفات التقليدية والديناميّات الإقليمية، حيث تتم إعادة النظر في الشراكات الاستراتيجية التي استمرت عقودًا.
في هذا السياق، يشير التقرير إلى أن العديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تتبنى بشكل متزايد سياسات عدم الانحياز، وتسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من التنافس بين القوى الكبرى بدلًا من الاصطفاف الحصري مع الولايات المتحدة أو الصين. ويعكس هذا الاتجاه إعادة معايرة أوسع في الاستراتيجيات الدولية، حيث تؤكد القوى الإقليمية قدرًا أكبر من الاستقلالية في صنع قراراتها السياسية والاقتصادية والأمنية على الساحة العالمية.
ثانيًا: تأثير التعددية القطبية في الاستقرار العالمي
يقدم التقرير وجهتي نظر رئيسيتين حول تأثير التعددية القطبية في الاستقرار العالمي:
1. النظرة المتفائلة
يرى هذا المنظور أن التعددية القطبية تتيح فرصة لبناء نظام دولي أكثر شمولًا وعدالة، من خلال تقليص الهيمنة الأمريكية، وإفساح المجال أمام دول أخرى للمشاركة في صنع القرار العالمي. ويؤكد أنصار هذا الرأي أن العالم المتعدد الأقطاب يعزز التنوع الاقتصادي، ويوسّع نطاق المشاركة الدبلوماسية، ويقلل من التدخلات الأحادية، التي تمارسها القوى المهيمنة. ويشيرون، أيضًا، إلى أن زيادة المنافسة الجيوسياسية يمكن أن تؤدي إلى مفاوضات أكثر توازنًا داخل المؤسسات الدولية؛ ما يمنع أي دولة منفردة من فرض معاييرها العالمية بشكل أحادي.
2. النظرة المتشائمة
على النقيض، يرى التقرير أن التعددية القطبية قد تؤدي إلى المزيد من الفوضى والصراعات؛ ما يجعل التوصل إلى اتفاقيات دولية أمرًا أكثر تعقيدًا؛ بسبب اختلاف الأجندات الاستراتيجية بين القوى الصاعدة. وكذلك، يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها هياكل الحوكمة العالمية، مثل مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، في التكيف مع عالم أكثر تشتتًا من حيث مراكز القوة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة المتعددة الأقطاب ترفع من خطر المواجهات العسكرية، والحروب التجارية، وعدم الاستقرار الإقليمي، خاصة في مناطق حساسة، مثل أوروبا الشرقية، وبحر الصين الجنوبي، والشرق الأوسط.
مؤشر ميونيخ للأمن MSI) 2025)
يستشهد التقرير بنتائج مؤشر ميونيخ للأمن 2025، وهو مؤشر سنوي يقيس تصورات المخاطر العالمية في مختلف البلدان. ويعتمد مؤشر ميونيخ للأمن على خمسة مقاييس رئيسية: التصور العام للمخاطر، وتوقعات ما إذا كان الخطر سيزداد أم يتناقص، وشدة الضرر المتوقعة إذا تحقق الخطر، ومدى قرب التهديد، ومستوى الاستعداد في كل بلد. وتوفر النتيجة النهائية للمؤشر، التي تتراوح من 0 إلى 100، نظرة شاملة لكيفية إدراك التركيبة السكانية والدول المختلفة للمخاطر بمرور الوقت.
ويكشف المؤشر عن فجوة متزايدة الاتساع في كيفية إدراك التهديدات الجيوسياسية بين دول مجموعتَي السبع و”بريكس” (مجموعة بريكس باستثناء روسيا). وفي حين تعرب كلتا المجموعتين عن مخاوف كبيرة بشأن المخاطر غير التقليدية، مثل الهجمات الإلكترونية والأزمات الاقتصادية والتهديدات البيئية، فإن وجهات نظرهما بشأن القوى الكبرى تختلف اختلافًا كبيرًا. ومن بين دول مجموعة السبع، زادت المخاطر المتصورة التي تشكلها روسيا وإيران أكثر من غيرها منذ عام 2021، في حين ظلت المخاوف بشأن بكين مستقرة نسبيًّا. على النقيض من ذلك، يرى المستجيبون في دول مجموعة “بريكس” أن الصين تشكل تهديدًا أقل بكثير مما كانت عليه قبل أربع سنوات، حيث انخفض موقعها بمقدار 16 مركزًا في مؤشر المخاطر منذ عام 2021. في الوقت نفسه، لاتزال روسيا وإيران يُنظر إليهما على أنهما من بين أقل المخاطر تهديدًا في هذه البلدان.
ويسجل التقرير زيادة إجمالية في إدراك المخاطر، مع ارتفاع 20 مؤشرًا وانخفاض 10 وثبات مؤشرَين. والجدير بالذكر أن المخاطر التي تشكلها الولايات المتحدة ارتفعت بشكل كبير في العديد من دول مجموعة السبع، خاصة ألمانيا وكندا، وكذلك في الهند، بعد انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وفي الصين والبرازيل، ظلت تصورات واشنطن كخطر مستقرة، فيما انخفضت المخاطر التي تشكلها الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا. وفي الوقت نفسه، بعد تحسن طفيف في العام الماضي، زاد تصور روسيا كتهديد مرة أخرى في كندا وفرنسا وألمانيا والهند والمملكة المتحدة. وقد يكون هذا مرتبطًا بالمخاوف المتزايدة من الحروب التجارية والاستخدام المحتمل للأسلحة النووية. من ناحية أخرى، انخفضت المخاوف بشأن كوفيد-19 وانقطاع إمدادات الطاقة والإرهاب الديني والتطرف بشكل كبير في معظم البلدان.
تهيمن المخاطر البيئية على المخاوف العالمية، حيث تحتل الظواهر الجوية المتطرفة وحرائق الغابات وتدمير الموائل الطبيعية وتغير المناخ المرتبة الثالثة على مستوى العالم. ويتجلى هذا الاتجاه بشكل خاص في الهند والبرازيل وإيطاليا؛ حيث إن المخاطر الثلاثة الرئيسية بيئية. وتحتل الهجمات الإلكترونية المرتبة الرابعة على مستوى العالم، وهي من بين أكبر ثلاثة مخاوف في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. ويُنظر إلى روسيا على أنها التهديد الأمني الأكبر في المملكة المتحدة وكندا (متعادلة) وألمانيا (متعادلة)، وثاني أكبر مصدر للقلق في الولايات المتحدة. ومن المثير للاهتمام أنه في حين أن المخاوف بشأن بكين ظلت مستقرة بشكل عام، فإن ألمانيا والمملكة المتحدة فقط أظهرتا زيادة في تصورهما للصين كخطر.
وتستمر المنافسة الجيوسياسية الأوسع في تشكيل الرأي العام بشأن التهديدات والتحالفات الدولية. وتعتبر جميعُ دول مجموعة السبع إيران والصين وروسيا تهديدًا أكثر من كونها حليفًا. ومع ذلك، يختلف التصور، إلى حد كبير، في دول مجموعة العشرين، باستثناء الهند، التي تنظر إلى الصين على أنها تهديد، والبرازيل، التي تنظر إلى إيران على أنها مصدر قلق. والجدير بالذكر أن المستجيبين الصينيين يظلون المجموعة الوحيدة التي ترى الولايات المتحدة تهديدًا أكبر من كونها حليفًا. ومقارنةً بالعام السابق، تراجعت السمعة العالمية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا بشكل ملحوظ، في حين سجلت كوريا الجنوبية وبولندا وتركيا والمملكة المتحدة أكبر تحسن في التصورات الدولية.
يكشف الاستطلاع، أيضًا، عن اختلافات صارخة في كيفية إدراك المشاركين من دول مجموعة السبع والمجموعة الاقتصادية والتجارية لمستقبل أمنهم الوطني وازدهارهم الاقتصادي. ويتجلى الشعور السائد بالانحدار بين دول مجموعة السبع، حيث لا تعتقد أي منها، باستثناء الولايات المتحدة، أنها ستكون أكثر أمنًا وثراءً في غضون عشر سنوات. على النقيض من ذلك، فإن الأغلبية في الصين والهند متفائلة بشأن ظروفها الاقتصادية والأمنية المستقبلية، في حين تظل البرازيل وجنوب أفريقيا منقسمتين بشأن توقعاتهما.
ويعكس مؤشر ميونيخ للأمن 2025 التحولات العميقة في التصورات العالمية للمخاطر، مع تزايد القلق الجيوسياسي والبيئي والرقمي، في ظل تصاعد الاستقطاب الدولي بين الغرب والشرق.
ثالثًا: الولايات المتحدة في عالم متعدد الأقطاب
يشير التقرير إلى أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد يكون عاملًا حاسمًا في إعادة تشكيل النظام الدولي. فمن خلال تبنيه نهج “أمريكا أولًا”، قد يعمد إلى تقليص دور الولايات المتحدة كضامنة لأمن أوروبا؛ ما قد يفرض تحديات جديدة على حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأوكرانيا، ويؤدي إلى إعادة تقييم الترتيبات الأمنية في القارة الأوروبية.
ويرى التقرير أن رئاسة دونالد ترامب تشكل قطيعة حاسمة مع الإجماع، الذي ساد بعد الحرب الباردة بشأن السياسة الخارجية الأمريكية، وأعطى الأولوية للأممية الليبرالية، وتعزيز الديمقراطية، والتجارة الحرة، والتفوق العسكري. وحتى قبل انتخابه، أدت تحديات مثل صعود الصين، وصراعات الولايات المتحدة في أوكرانيا، والشرق الأوسط، وديناميّات القوة العالمية المتغيرة، إلى دعوات لتكييف الاستراتيجية الأمريكية الكبرى. ومع ذلك، فإن فوز ترامب دفن فعليًّا فكرة أن الولايات المتحدة يجب أن تظل الزعيمة التي لا مثيل لها في العالم. فهو ينظر إلى النظام الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، باعتباره عبئًا يفيد البلدان الأخرى على حساب أمريكا، ويفضل نهجه المشاركة الانتقائية والمعاملاتية القائمة بشكل صارم على المصالح الأمريكية، التي ستكون لها عواقب عالمية عميقة.
تختلف رؤية ترامب للسياسة الخارجية بشكل حاد عن أسلافه. فعلى النقيض من بايدن، الذي سعى إلى إحياء التحالفات والالتزامات الدولية، يرى ترامب أن الحلفاء يشكلون عبئًا اقتصاديًّا وأمنيًّا. وقد انتقد حلف شمال الأطلسي مرارًا وتكرارًا، وطالب الحلفاء الأوروبيين بدفع المزيد مقابل دفاعهم، واقترح أن الولايات المتحدة يمكن أن تقلل من وجودها العسكري في أوروبا. ومن الممكن أن يؤدي نهج إدارته إلى إضعاف مصداقية حلف شمال الأطلسي؛ ما يجعل أوروبا أكثر عرضة للتهديد، مع إجبارها على تحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها.
وفي إعطاء الأولوية للصين، باعتبارها المنافس الجيوسياسي الرئيسي، اقترح ترامب سياسات اقتصادية عدوانية، بما في ذلك التعريفات الجمركية، وقطع التكنولوجيا الأمريكية عن بكين. ومع ذلك، فإن هناك حالة من عدم اليقين بشأن موقفه العسكري تجاه الصين، خاصة فيما يتعلق بتايوان. وفي حين يدعو بعض الأعضاء في إدارته إلى وجود أمريكي أقوى في آسيا، كان ترامب غير ملتزم بالدفاع عن تايوان.
من المرجح أن تؤدي سياسات ترامب إلى تعميق التعددية القطبية، حيث قد يؤدي انخفاض مشاركة الولايات المتحدة في المؤسسات والتحالفات المتعددة الأطراف إلى دفع قوى أخرى ــ الصين وروسيا والجهات الفاعلة الإقليمية ــ إلى ملء الفراغ. وقد تؤدي دبلوماسيته التحويلية، خاصة مع الجنوب العالمي، إلى تفتيت النظام العالمي بشكل أكبر؛ ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأكثر عزلة ستساعد في احتواء أو تسريع عدم الاستقرار العالمي، أم لا.
رابعًا: البديل الصيني للنظام الليبرالي
تقدم الصين نفسها باعتبارها المدافع الأول عن نظام عالمي متعدد الأقطاب؛ بهدف إعادة تشكيل مؤسسات الحكم العالمية لتعكس ديناميّات القوة المتغيرة لمصلحة الدول غير الغربية. وقد أكد الرئيس شي جين بينغ أن النظام المتعدد الأقطاب من شأنه أن يسمح لجميع البلدان بلعب أدوارها الواجبة. ومع ذلك، ووفقًا للتقرير، وفي حين تدّعي بكين دعم الجنوب العالمي، ومعارضة الهيمنة الغربية، فإن سلوكها الاستراتيجي يتناقض غالبًا مع هذه المبادئ المعلنة. وتنظر العديد من الدول إلى دفع الصين نحو التعددية القطبية كوسيلة لتأمين قوتها، وتوسيع نفوذها، بدلًا من تعزيز المساواة العالمية الحقيقية.
ترتبط رؤية بكين للتعددية القطبية بأهدافها الاستراتيجية الأوسع نطاقًا، التي تشمل الحد من النفوذ الغربي، وتعزيز نماذج الحكم البديلة، وإضفاء الشرعية على نهجها الاستبدادي. ويشمل هذا إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية على الحقوق السياسية وتعزيز السيادة؛ لمنع التدخل الخارجي في مسائل الحكم. وفي حين تلقَى هذه الرسالة صدًى لدى كثيرين في الجنوب العالمي، يزعم المنتقدون أن تصرفات الصين ــ مثل انحيازها الاستراتيجي إلى روسيا وإيران وكوريا الشمالية ــ تقوّض مزاعمها بالدعوة إلى نظام دولي أكثر عدالة.
وتنظر الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشكل متزايد إلى طموحات بكين، باعتبارها تحديًا للنظام الدولي الليبرالي. وكان الدعم الاقتصادي والعسكري المكثف، الذي يُزعَم أن الصين قدمته لروسيا، عقب غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك التحايل على العقوبات الغربية والمساعدة المزعومة في التطوير العسكري، سببًا في تأجيج المخاوف بشأن أجندة بكين التعديلية. وفي الوقت نفسه، تواصل الصين توسيع نفوذها من خلال مجموعة “بريكس”، وتضعها في موقع الثِقَل الموازي لمجموعة السبع، ولكنها تقاوم الإصلاحات ذات المغزى في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، التي قد تضعف قوتها.
على الصعيد العسكري، تعمل الصين على توسيع قدراتها بسرعة، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادي؛ حيث تسعى إلى فرض هيمنتها الإقليمية مع ردع التدخل الأمريكي. ومع امتلاكها أكبر أسطول بحري في العالم، وترسانة نووية متوسعة، يرى التقرير أن التراكم العسكري الصيني يتناقض بشكل مباشر مع خطاب بكين حول التعددية القطبية السلمية؛ ما يثير المخاوف بشأن تصاعد المنافسة بين القوى العظمى.
خامسًا: الاتحاد الأوروبي بين الضغوط الداخلية والخارجية
يصور التقرير الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الكيانات الأكثر تأثرًا بالتحولات العالمية؛ فهو عالق بين تحديات داخلية، مثل تصاعد النزعة الشعبوية والانقسامات بين الدول الأعضاء، والضغوط الخارجية الناجمة عن تراجع الالتزامات الأمنية الأمريكية، وتزايد النفوذَين الصيني والروسي.
إن الرؤية الليبرالية للاتحاد الأوروبي للنظام الدولي تواجه أزمة حادة على جبهات متعددة؛ فقد أدت حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى تحطيم الإطار الأمني لأوروبا، فضلًا عن أن تسليح الترابطات الاقتصادية المتبادلة، بشكل متزايد، يهدد نموذجها الاقتصادي، وتعمل التحديات الداخلية والخارجية المتنامية على تقويض أسس الديمقراطية الليبرالية في الاتحاد الأوروبي. وتتفاقم هذه الأزمات بسبب عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار الأمن والاقتصاد والوحدة في أوروبا.
لقد دافع الاتحاد الأوروبي، منذ فترة طويلة، عن الأممية الليبرالية، ودعم الديمقراطية والتجارة الحرة والمؤسسات المتعددة الأطراف. ومن خلال نفوذه الاقتصادي والتنظيمي-الذي يُطلق عليه غالبًا “تأثير بروكسل”-عمل الاتحاد الأوروبي على تشكيل المعايير والمؤسسات العالمية. ومع ذلك، أدت التحولات المتنامية في القوة العالمية، والشعبوية القومية الصاعدة، والحمائية الاقتصادية إلى إضعاف هذا النفوذ. أيضًا، يقوّض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتفتت الداخلي، وتراجع القوة الاقتصادية، من قدرة الاتحاد الأوروبي على الترويج لنموذجه.
ويرى التقرير أن الحرب في أوكرانيا شكلت اختبارًا شديدًا للنظام الأمني في أوروبا. ففي حين زاد أعضاء الاتحاد الأوروبي من الإنفاق الدفاعي والمساعدات العسكرية المقدمة لكييف، لاتزال المخاوف قائمة بشأن الردع الطويل الأجل ضد روسيا. وتشير إدارة ترامب إلى تخفيضات محتملة في الالتزامات الأمنية الأمريكية؛ ما يضطر أوروبا إلى تحمل قدر أعظم من المسؤولية عن دفاعها. ويثير خطاب ترامب بشأن خفض دعم حلف شمال الأطلسي، والضغط على الحلفاء الأوروبيين لزيادة الإنفاق العسكري، المخاوف بشأن مصداقية حلف شمال الأطلسي، ومستقبل أوكرانيا.
على الصعيد الاقتصادي، تتعرض أجندة التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي للتهديد مع إعطاء الجهات الفاعلة العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، الأولوية للأمن القومي على الكفاءة الاقتصادية. وقد تؤدي التعريفات الجمركية، التي اقترحها ترامب على الصين، والقيود التجارية الأوسع نطاقًا، إلى التفتت الاقتصادي؛ ما يُلحق الضرر بالصناعات الأوروبية. وعلى الصعيد الداخلي، تعمل الحركات اليمينية المتطرفة المتصاعدة، والاستقطاب السياسي على إضعاف المؤسسات الديمقراطية، وتعقيد عملية صنع القرار، وتقويض مصداقية الاتحاد الأوروبي كمدافع عالمي عن “الديمقراطية”.
للتغلب على هذه الأزمات، يقترح التقرير أن يعيد الاتحاد الأوروبي تقييم علاقته بالولايات المتحدة، أو يسعى إلى تحقيق قدر أعظم من الاستقلال الاستراتيجي. ويظل السؤال مفتوحًا عما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرًا على إعادة اختراع نفسه بفعالية، أم لا.
سادسًا: روسيا ورؤية “القوى الحضارية“
يؤكد التقرير أن روسيا تواصل تحدي النظام الدولي القائم عبر الترويج لمفهوم “القوى الحضارية”، الذي تستخدمه لتبرير تدخلاتها في الدول المجاورة، مثل أوكرانيا، بدعوى حماية مصالحها التاريخية والثقافية. ومع ذلك، فإن العقوبات الغربية المستمرة، وتزايد العزلة الدولية يفرضان تحديات اقتصادية قد تؤثر في قدرة موسكو على تحقيق أهدافها الجيوسياسية.
ورغم عدوانها العسكري، ومحاولاتها فرض الهيمنة على الدول السوفيتية السابقة، تواجه روسيا قيودًا داخلية كبيرة، تشمل الركود الاقتصادي، وتراجع عدد السكان، والاعتماد المفرط على صادرات الطاقة، وهي عوامل قد تقلل من طموحاتها الاستراتيجية على المدى البعيد.
كذلك، يثير التقرير تساؤلات حول قدرة موسكوعلى مواصلة سياساتها التعديلية دون التعرض لمزيد من التداعيات الاقتصادية والسياسية. في هذا السياق، يفحص التقرير العلاقات المتنامية بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، مشيرًا إلى أنها قد تمثل عوامل موازنة محتملة للضغوط الغربية؛ ما يعيد تشكيل موازين القوى في النظام العالمي الجديد.
سابعًا: دور القوى الناشئة (الهند، واليابان، والبرازيل، وجنوب أفريقيا)
الهند: تسعى إلى تعزيز دورها العالمي، لكنها تواجه تحديات داخلية مرتبطة بكل من الاستقرار الاقتصادي والسياسي. ويعتمد نهجها في التعامل مع التعددية القطبية على تحقيق التوازن في علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب من جهة، والقوى الناشئة مثل الصين وروسيا من جهة أخرى. ومع ذلك، تظل التوترات الإقليمية مع الصين وباكستان مصدر قلق رئيسيًّا؛ ما يفرض قيودًا على طموحاتها الاستراتيجية.
اليابان: تشعر بقلق متزايد إزاء النظام العالمي المتعدد الأقطاب، وتسعى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات المحتملة. وقد رفعت إنفاقها العسكري، وعززت تحالفاتها مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين في منطقة المحيطين الهندي والهادي، في محاولة لموازنة النفوذ الصيني المتنامي، وتأمين موقعها في البيئة الأمنية المتغيرة.
البرازيل: تنظر إلى التعددية القطبية باعتبارها فرصة لإصلاح النظام العالمي وتعزيز مكانة الدول النامية. ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي الداخلي والتحديات الاقتصادية قد يعيقان تطلعاتها إلى لعب دور عالمي أكثر بروزًا؛ ما يجعل قدرتها على التأثير محدودة، مقارنة بالقوى الناشئة الأخرى.
جنوب أفريقيا: تنتقد النظام الدولي الحالي، وتسعى إلى زيادة التمثيل الأفريقي في المؤسسات العالمية، في ظل تحديات اقتصادية وسياسية محلية كبيرة. فضلًا عن ذلك، أصبحت السياسة الخارجية لجنوب أفريقيا متماشية بشكل متزايد مع الجهات الفاعلة غير الغربية؛ ما يعكس استياءً واسع النطاق من الهياكل الدولية، التي يهيمن عليها الغرب، وسعيًا لإعادة التوازن في النظام العالمي.
الخاتمة: نحو عالم أكثر استقطابًا أم تعاونًا؟
يختتم التقرير بطرح سؤال محوري: هل ستؤدي التعددية القطبية إلى نظام دولي أكثر شمولًا وتعاونًا، أم ستقود إلى مزيد من الاستقطاب والصراعات؟ ويشدد التقرير على أهمية تقليل الاستقطاب كعامل أساسي؛ لضمان الاستقرار العالمي، وتعزيز بيئة دولية أكثر توازنًا.
في نهاية المطاف، سيعتمد المسار المستقبلي للنظام العالمي على مدى قدرة القوى الناشئة والدول الكبرى على إيجاد أرضية مشتركة حول القضايا الحيوية، مثل التجارة، والأمن، والتكنولوجيا، وتغير المناخ. ويؤكد التقرير أنه رغم أن التعددية القطبية تفتح آفاقًا جديدة للحكم العالمي، فإنها تحمل أيضًا مخاطر كبيرة، يجب إدارتها عبر الدبلوماسية، والتعاون المتعدد الأطراف، والالتزام بالمعايير الدولية؛ لضمان استقرار النظام العالمي في المستقبل.