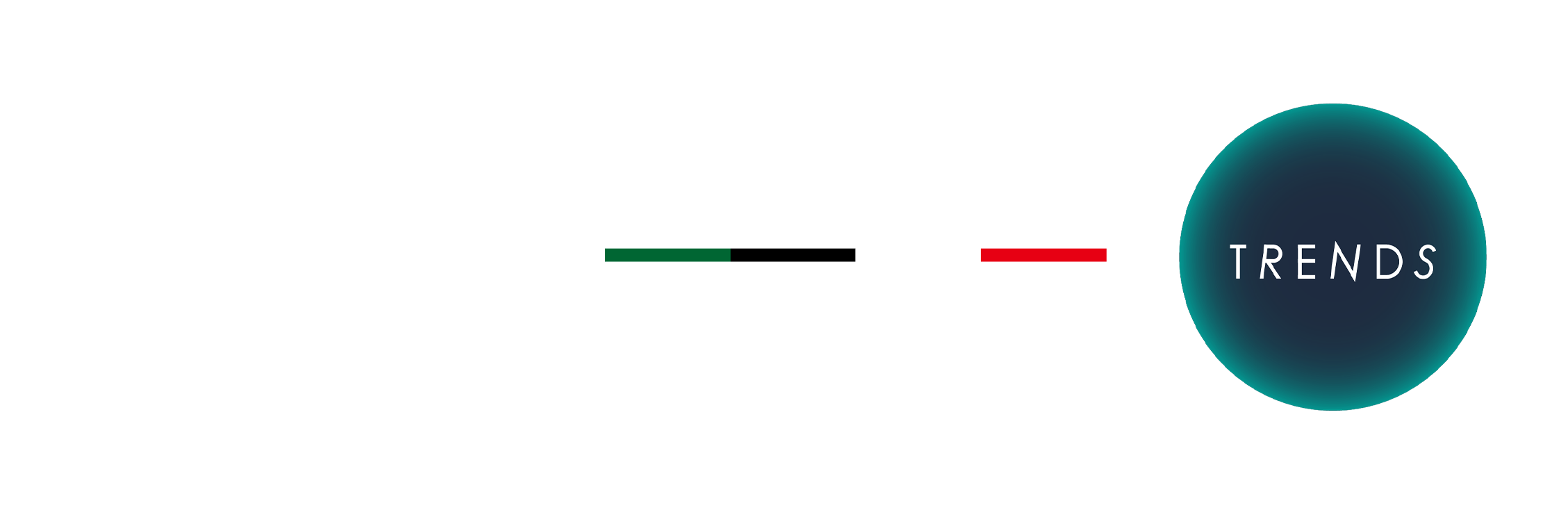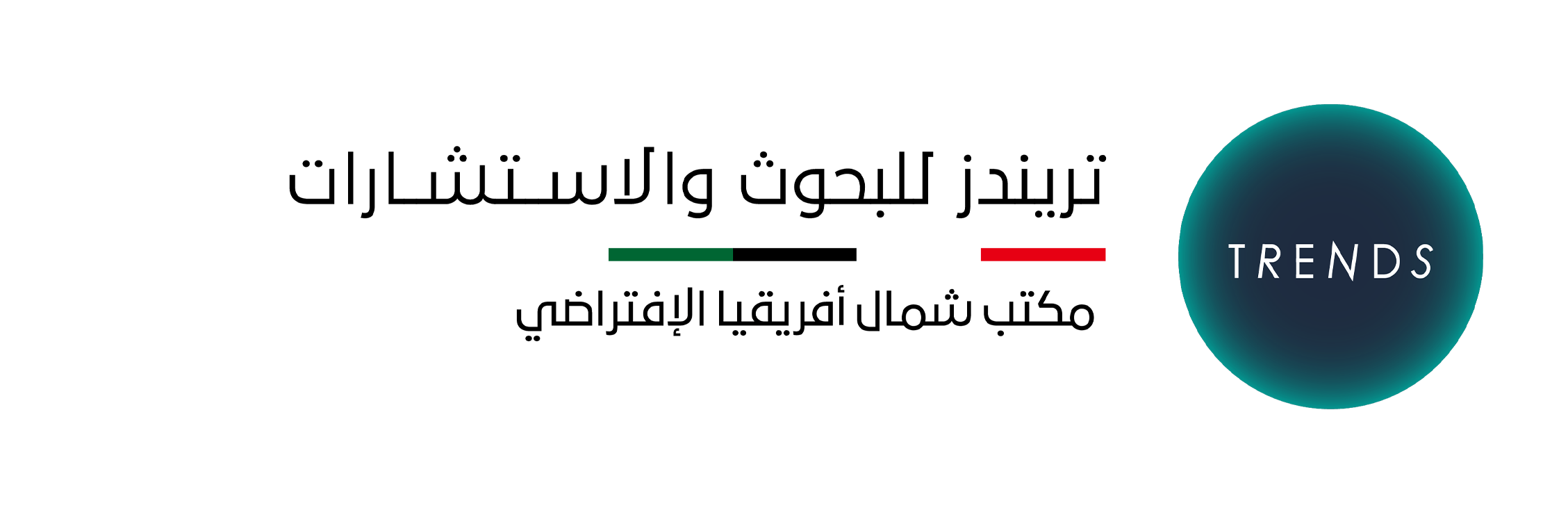الملخص: تشهد بلدان المغرب العربي تحولات متسارعة في أنماط التفاعل السياسي والاجتماعي نتيجة تنامي استخدام وسائط الميديا الاجتماعية، التي أضحت منابر بديلة لإنتاج الخطاب السياسي والنقاش العمومي؛ ولاسيما في ظل تراجع ثقة المواطنين بالإعلام الرسمي ومؤسسات الوساطة التقليدية. يسعى هذا المقال إلى تحليل رهانات هذه الوسائط من خلال رصد أشكال استخدامها السياسية والاجتماعية، وتفكيك التحديات المرتبطة بها، كحرية التعبير، والرقابة الرقمية، والاستقطاب الأيديولوجي، وانتشار الأخبار المزيّفة. ويتبنى الباحث مقاربة نقدية تدمج البعد التكنولوجي بالبنية الثقافية والسياسية للمجتمعات المغاربية، ويبرز الأثر التفاعلي لوسائط الاتصال على بنية الحقل السياسي، وأشكال التعبير الرمزي، وحدود التحوّل الديمقراطي في السياق الرقمي المغاربي.
مقدمة: شهدت بلدان المغرب العربي خلال العقدين الأخيرين تحوّلات لافتة للنظر في العلاقة بين وسائل الاتصال الجديدة والفضاء العام، إذ أصبحت وسائط الميديا الاجتماعية أكثر من مجرد منصات للتواصل والتسلية، لتتحول تدريجيًّا إلى أدوات مؤثرة في تشكيل الرأي العام وصناعة المواقف السياسية. وقد تزامن هذا التحوّل مع تراجع دور الإعلام الرسمي التقليدي، وارتفاع منسوب اللامركزية في إنتاج الخطاب السياسي والاجتماعي، في سياقات وطنية مطبوعة بالتوترات الاجتماعية والركود المؤسساتي.
يهدف هذا المقال إلى تحليل الاستخدامات السياسية والاجتماعية لوسائط التواصل في بلدان المغرب العربي، من خلال مقاربة تدمج بين تحليل البنية الرقمية لهذه الوسائط وسياقاتها الثقافية والسياسية. وينطلق من فرضية مفادها أن وسائط الميديا الاجتماعية قد أسهمت، بدرجات متفاوتة، في إعادة تعريف الفعل السياسي، من خلال إتاحة مساحات جديدة للتعبير والنقاش والمساءلة، ولكنها في الآن نفسه كرّست تحديات معقدة تتعلق بالرقابة، والاستقطاب، وانتشار الأخبار المزيّفة، وإعادة إنتاج التراتبيات الاجتماعية بصورة رقمية.
1. مراحل تطوّر استخدام الميديا الاجتماعية في المغرب العربي:
يتناول هذا المحور المراحل الثلاث التي مرت بها الميديا الاجتماعية منذ دخول الإنترنت إلى المنطقة، من الاستخدام الأكاديمي المحدود إلى الانفجار الشعبي الذي رافق أحداث “الربيع العربي”.
من نافلة القول إنّ تطور مواقع الميديا الاجتماعية في بلدان المغرب العربي (تونس، والجزائر، والمغرب( ارتبط بشكل وثيق بميلاد شبكة الإنترنت، واتساع استخدامها الاجتماعي، والذي يمكن تأريخه بثلاث مراحل بارزة: المرحلة الأولى، بدأت مع نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الحالية، إذ اقتصر استخدام الإنترنت فيها على المؤسسات الأكاديمية، وبعض الشركات العاملة في حقل الاتصالات والمعلوماتية التي استفادت من الخدمات التي توفرها آنذاك: المراسلات الرقميّة، ومنتديات النقاش. والمرحلة الثانية، بدأت في عام 2000 حتى نهاية 2010، وشهدت انطلاق فئات اجتماعيّة متزايدة؛ خاصة الشباب، في استخدام المدوّنات الإلكترونيّة، وموقعي الفيسبوك واليوتيوب وهذا نتيجة الانتشار الواسع للهاتف المتحرك. والمرحلة الثالثة والأخيرة، انطلقت مع بداية ما سمّته وسائل الإعلام الغربية بــ “الربيع العربي” في تونس في عام 2011، حين ازداد استخدام المدونات الإلكترونية، وموقعي الفيسبوك وتويتر، انتشارًا. واليوم، بعد أن تجاوزت نسبة مستخدمي شبكة الإنترنت في بلدان المغرب العربي المعدل العالمي المقدر بـ 67.9%[1] بدرجات عالية، ارتفع، بشكل متسارع، عدد مستخدمي الميديا الاجتماعية مقارنة بعدد سكان كل بلد، ليبلغ النسب الآتية: تونس58.9%، والجزائر%54.2، والمغرب55.7%[2]، وقد تزايد معها عدد مستخدمي الميديا الاجتماعية مع الانتقال إلى الجيل الرابع من أجيال الاتصالات اللاسلكية الخلويّة.
عدد مستخدمي مواقع الميديا الاجتماعية في بلدان المغرب العربي[3])بالألف)
| نسبة مستخدمي مواقع الشبكات الاجتماعية | المشتركون في تيك توك | المشتركون في إنستغرام | المشتركون إكس(تويتر) | المشتركون في اليوتيوب | المشتركون في الفيسبوك | نسبة مستخدمي الإنترنت | عدد السكان | البلد |
| 58.9% | 518 | 345 | 338 | 701.00 | 7.250 | 84.9% | 12.240 | تونس |
| 54.2% | 2100.1 | 12.000 | 100.13 | 21.001 | 25.006 | 76.9% | 46.497 | الجزائر |
| 55.7% | 410.12 | 900.11 | 1.180 | 21.200 | 20.550 | 90.7% | 37.901 | المغرب |
– عدد مستخدمي مواقع الميديا الاجتماعية في الجزائر والمغرب بالألف في يناير 2025
– عدد السكان بالألف، بحسب إحصائيات 2024، المصدر: Nations Unies: World Population Prospects.. 2024
https://desapublications.un.org/publications/world-population-prospects-2024-summary-results
تشهد خارطة مواقع الميديا الاجتماعية ديناميكية متواصلة، بعضها يتراجع أو يزول بعد أن يفقد مستخدميه، مثل “ماي سبيس” Myspace، وسكند لايفSecond life، وبعضها يتطور ويجدّد وظائفه وينوّعها في جوٍّ من التنافس المحموم، وبعضها الآخر يظهر للوجود لأول مرة. أما المستخدمون فإنهم يرحلون من موقع إلى آخر بحثًا عن ذاك الذي يلبي رغباتهم. وقد يراكمون اشتراكاتهم في أكثر من موقع. ومن كل مواقع الميديا الاجتماعية العديدة أستأثر موقع الفيسبوك- ميتا منذ 2021، واليوتيوب، وتويتر- إكس منذ 2023، وإنستغرام، وتيك توك، بأكبر حصة من عدد المشاركين في بلدان المغرب العربي، كما هو مبين في الجدول أعلاه.
2. السمات الاتصالية لمنصات التواصل الاجتماعي:
يتطرق إلى الخصائص التقنية والتفاعلية للفيسبوك، وتيك توك، ويوتيوب، وتويتر، ويوضح كيف أسهمت هذه السمات في جذب مختلف الفئات الاجتماعية، وخصوصًا الشباب.
بالطبع، لكل ميديا اجتماعية هوية مرئيّة واتصاليّة، ووظائف تميّزها، بهذا القدر أو ذاك، عن غيرها. فموقع الفيسبوك، على سبيل المثال، الأقدم في بلدان المغرب العربي، هو منصّة متعدّدة الأغراض، تسمح بتقاسم النصوص، والصور، والفيديوهات، والتواصل عبر النصوص القصيرة، وبثّ القصص مباشرة، وتتيح للمستخدم إنشاء صفحته الخاصة، وتشكيل جماعته Community التي تشاركه الاهتمامات والانشغالات والهويات. يغذيها بالنصوص والصور والملفات الصوتية والسمعية-البصرية في شكل قصص وتعليقات وتقارير عبر شريط الأخبار.
يتربع موقع فيسبوك على عرش الميديا الاجتماعية في بلدان المغرب العربي، ويزداد عدد مستخدميه من سنة إلى أخرى، إذ تشير الإحصائيات إلى أنه كسب 700 ألف مستخدم جديد خلال سنة 2024 في الجزائر. ويعود السبب في ذلك إلى أشكال التفاعل المختلفة والمتنوعة التي يتيحها، والتي تدفع إلى التركيز على المتفاعلين أكثر من الاهتمام بمحتوى المنشورات. ويأتي في المرتبة الثانية من ناحية الاستخدام، موقع التيك توك، إذ يتفوق على المنصة الأقدم: اليوتيوب، التي تعدّ الرائدة في مجال بثّ شرائط الفيديو، لكونه يتميز بسهولة الاستخدام وسرعته، إذ يمكن إنتاج شرائط فيديو قصيرة وتوزيعها على أوسع نطاق في غضون 15 ثانية فقط مصحوبة بالموسيقى. وبفضل طابعه الديناميكي والمعدي ازدادت شعبيته بإيقاع متسارع: لقد انتقل من كونه منصّة تستهوي أغلب جيلZ، الذي يهوى التحدي في مجال الغناء والرقص والحركات البهلوانية، إلى قوة جاذبة للمؤثرين ومتابعيهم والمعجبين بهم من أعمار مختلفة. ونظرًا إلى تزايد شعبية هذه المنصّة، وتهافت المستخدمين عليها قصْد رفع عدد متابعيهم، ومن ثمّ حصتهم من عائد إشهارها، وتشجيعها على ممارسة “التسول الرقمي”، سعى أعضاء البرلمان المغربي إلى حظرها خوفًا من تأثيرها على قيم المجتمع المغربي.[4] أما موقع إنستغرام، فبفضل صوره الفتوغرافية الجمالية، و”قصص” مستخدميه وحكايات يومياتهم المسجلة التي تحرّك العاطفة وتوقظ الفضول، أصبح ينافس منصة التيك توك في جذب المؤثرين والمؤسسات والشركات من أجل الترويج لمنتجاتها وخدماتها.
يحتل موقع تويتر ذيل ترتيب المواقع المدرجة في الجدول أعلاه. فعلى الرغم من الثورة التي أحدثها في الميديا التقليدية والتي جعلته منافسًا لوكالات الأنباء بتغريداته في مجال السياسة والاقتصاد، ومصدرًا إخباريًّا للصحافيين فإنه تراجع في بلدان المغرب العربي، إذ فقدَ 8.6% من مستخدميه خلال السنة الماضية في الجزائر وحدها.[5] وظل محدود الاستخدام في المغرب؛ إذ لم تتجاوز نسبة استخدامه 3.1% من نسبة السكان في سنة 2024. وهذا الأمر يدعو إلى التساؤل. هل يعبر هذا التراجع عن الخوف من الرقابة المسلطة على تداول الأخبار السياسية أكثر من تلك التي تمارس على السرديات الذاتية والشخصية في منصّات أخرى؟ هل يكشف عن الملل؟ وانطفاء الحماسة السياسية بعد خيبة الأمل في وعود أحداث تونس في مطلع 2011؟ والحراك في الجزائر في فبراير 2019؟ وهل يرجع إلى خصوصية هذه المنصّة التي توجه تركيز مشتركيها نحو محتويات الأخبار- التغريدات- أكثر من الاهتمام بأصحابها، مثلما تشجع على ذلك منصّة فيسبوك على سبيل المثال؟ وهل تعود إلى العجز عن التعبير بـ 280 كلمة أو أقل؛ أي بالحدّ المسموح به في هذه المنصّة؟
3. الفضاء الرقمي كبديل للمجال العمومي التقليدي
يناقش هذا المحور الكيفية التي تحوّلت فيها الميديا الاجتماعية إلى منصة موازية للإعلام الرسمي، ومصدر للأخبار والتعبئة السياسية، وتأثيرها على ممارسات التواصل التقليدية.
هكذا انتقلت الميديا الاجتماعية في هذه البلدان من كونها أداة بسيطة للتواصل بين الأهل والأصدقاء والمعارف عبر الرسائل النصّية القصيرة، وتبادل الصور وشرائط الفيديو وغرف الدردشة إلى وسيط فاعل في بيئة إعلاميّة معقدة ذات أبعاد مختلفة: تجاريّة، وسياسيّة، واجتماعية، وإعلاميّة؛ فلم تعد تزاحم وسائل الإعلام الرسميّة فحسب، بل تسعى لتكون مصدرًا إخباريَّا بديلًا لها، إذ تشير بعض الإحصائيات إلى أن ثلاثة أرباع (79%) من الشباب، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، يتابعون الأخبار عن طريق الميديا الاجتماعية، مسجلين بذلك زيادة تقدر بنسبة 25% عن سنة 2015.[6] وعلى الرغم من تباين استخدام مواقع الميديا الاجتماعية في هذه البلدان، وفي عدد المنصّات الرقميّة التي يشترك فيها كل فرد، فإن متوسط مدة استخدامه لها يزيد على ثلاث ساعات ونصف في اليوم.[7] وبهذا فإن الميديا الاجتماعية تستأثر بمدة زمنيّة تقترب من المدة المخصصة لمشاهدة التلفزيون أو تزيد عليها قليلًا!
4. دينامية السياسية الرقمية:
التعبئة والتنظيم والتأثير؛ يُبرز هذا القسم الأدوار التي لعبتها هذه الوسائط في أحداث سياسية مثل حراك الجزائر وثورة تونس، ويشدّد على مفهوم “التجنيد الرقمي السريع”.
لقد أصبحت الميديا الاجتماعية اليوم تمثّل مصدر تفاؤل وأمل، وقلق وتوتر، في آن واحد. ومصدر التفاؤل والأمل يكمن فيما تمنحه من بعد مرئي لحضور الفئات الاجتماعية المهمشة في الفضاء العمومي، وتحرير الكلمة[8]، وتزويد المرأة بأداة لإسماع صوتها، والدفاع عن حقوقها،[9] والتعبير عن الهويّة، وتعزيز ارتباط المهاجرين بذويهم، وببلدانهم في المغرب العربي.[10] أما القلق والتوتر فقد ولد من الجدل حول تأثير الميديا على الأمن والاستقرار السياسي، على إثر أحداث الربيع العربي في تونس، و20 فبراير/ 2011 بالمغرب، والحراك الشعبي في الجزائر في2019، إذ راهنت الكثير من البحوث والدراسات على دور مواقع الشبكات الاجتماعية في إحداث الثورات، وضخّمه الخطاب الصحفي، وعلى قدرتها الفائقة على تغيير الممارسة السياسية وبعث الحياة الديمقراطيّة في بلدان المغرب العربي، والمنطقة العربية بصفة عامة.[11]
في سياقات أخرى قريبة، تعكس وتساهم وتضخم وسائل التواصل الاجتماعي قضايا خلافية بين البلدان المغاربية. وعلى رأس هذه الخلافات النزاع القائم حول الصحراء الغربية، إذ تسود في المغرب موجة من الجدل والعاطفة في الإعلام الاجتماعي، تتنوع بين خطاب نقدي قوي ومواقف متشددة، مقابل جهود من بعض المغاربة للدعوة إلى التهدئة والحوار. وتكررت في الأشهر الأخيرة حوادث قرصنة سيبرانية، حيث استهدف ناشطون مغاربة مؤسسات جزائرية ردًّا على هجمات منها على مؤسسات مغربية، في دورة تصعيد إلكترونية واضحة. التوتر الذي تشهده العلاقات الجزائرية الفرنسية يتجلّى في طرد متبادل للدبلوماسيين، ورفع الجزائر لإلغاء اتفاقية الإعفاء من التأشيرة عام 2013، ورد فرنسا بإجراءات مماثلة، فضلًا عن نزاعات ثقافية وسياسية تحركها رموز مثل “مربّى المورديجين” التي أصبحت قضيّة سياسية رمزية[12].
بالفعل، قد يجانب الصواب من يغفل الدور الديناميكي للمواقع الآتية: فيسبوك، ويوتيوب، وتويتر في الأحداث المذكورة أعلاه في مجال بثّ المعلومات وتعميم الشعارات، وتنظيم المظاهرات والمسيرات وتنسيقها، لكن من الصعب الاستنتاج بأن “النشاط السياسي المتراخي” “slacktivism”[13] سيكون بديلًا للممارسة السياسية في أرض الواقع التي تؤسس الفعل الديمقراطي في بلدان المغرب العربي. إن هذا الاستنتاج لا ينمّ على المبالغة في الدور السياسي للميديا الاجتماعية فحسب، بل يكشف أيضًا عن رؤية تبسيطيّة لماهية الممارسة السياسية. وفي هذا الشأن يشير أستاذ الإعلام في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، نيك كولدري Nick Couldry إلى أن الشبكات الرقميّة “تعجلّ عملية التجنيد السياسي، من خلال التنسيق السريع للنشاط الجماعي. وتوفير مصادر عديدة للأخبار، ما يسمح باستجابة سياسيّة سريعة للأحداث. وهذا يؤدي إلى التزام سياسي على المدى القصير، لكنه التزام غير متواصل ودائم، ما يؤثر على تماسك الحركات السياسية واستمراريتها على المدى الطويل”.[14] وما يضعف هذه الحركات أكثر في بلدان المغرب العربي هو الدفع نحو تمييع النقاش العمومي في الميديا الاجتماعية، والوشاية، والتخوين، والنيل من حياة الأشخاص، وبثّ الشقاق في أثناء الأزمات. ليس هذا فحسب، بل إن هذا الاستنتاج يتجاهل دور خوارزميات الشبكات الرقميّة في هندسة العلاقات الاجتماعية، والطبيعة المعقدة لهذه الأخيرة في التحولات التي تعيشها البلدان. لذا فإن أي تشخيص لتحديات الميديا الاجتماعية في بلدان المغرب العربي على مختلف الصُّعد: السياسية والاجتماعية والثقافية، يتطلب الأخذ بعين الاعتبار العنصرين الآتيين:1- فهم ما تقوم به الخوارزميات في توجيه استخدام الميديا الاجتماعية، 2- الاقتناع بأن عملية التواصل عبر مواقع هذه الميديا “تتموضع داخل مجتمع معيّن، وتنفذ بأدوات المجتمع ذاته”.[15] أي أننا نجانب الصواب إن تحدثنا عن الاتصال بمنأى عن بعده الاجتماعي والثقافي، وعن الأنثروبولوجيا السياسية؛ لذا، يجب تحليل الاتصال عبر مواقع الشبكات الاجتماعية انطلاقًا من خصوصيات المجتمع في بلدان المغرب العربي. وهذا يستدعي الخوض في بعض المباحث التي لا تكتفي بتحليل خصوصية هذه الميديا، بل تبرز سياقات استخدامها، ومنها ما يأتي:
1- التحدي الأول: التوفيق بين حرية الإعلام والتعبير والأمن الوطني، والحفاظ على الخصوصية. يجري الاتصال في بلدان المغرب العربي في ظلّ التوتر الناجم عن المفارقة الآتية: إن الميديا الاجتماعية أداة لممارسة حرية التعبير، لكنها في الوقت ذاته أداة للمراقبة. وإن كانت بعض الدراسات والمنظمات غير الحكومية تركز على الرقابة التي تمارسها السلطات العمومية على الميديا الاجتماعية ما يطرح معادلة على الدول صعبة الحل: الحرص على حماية الأمن القومي من دون إعاقة حرية التعبير والنشاط السياسي، أي كيف نحمي هذه الحرية في ظلّ دكتاتورية الظهور the dictatorship of visibility، التي تجعل الفرد بمثابة سجين تراقب الكاميرا حركاته وسكناته داخل زنزانته، وتسهم رقابة اجتماعية أخرى باطنية، في ترسيخ هذا الاستبداد، لأنها تكاد تكون “مألوفة”. لقد زادتها مواقع الميديا الاجتماعية انتشارًا ورسوخًا لأنها تجسد مقولة: الجميع يراقب الجميع”. لذا أصبح الشخص المغاربي يضبط سلوكه الظاهري، على الأقل، على ضوء الرقابة الاجتماعية المتسترة التي تمارس عليه من قبل الأهل، والأقارب، والمعارف، والجيران، وأبناء الحي السكني، وفي مقرات العمل. فالحرية أصبحت مقترنة بالعيش تحت شعار “الآخر هو الجحيم”، الذي رفعه الفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر في مسرحيته: “وراء الأبواب المغلقة “A huit clos. والغريب أن الكثير يشتكون هذا الجحيم، لكنهم لا يترددون في تغذيته بمنشوراتهم. إنّهم يتبرعون، عن طيب خاطر، بنشر كل ما يتعلق بهم، وحتّى بعض التفاصيل عن حياتهم الخاصة، من باب التباهي أو تزجية الوقت أو انتزاع حق الاعتراف. ويدعون الله، في الوقت ذاته، أن يمنّ عليهم بالستر في صلواتهم! فالكثير من المناوشات والمشاحنات في الميديا الاجتماعية هي إفرازات الرقابة الاجتماعية. لذا نلاحظ أن نسبة كبيرة من مستخدمي الميديا الاجتماعية يستعملون أسماء مستعارة، خاصة الفتيات. فالاسم المستعار يمنح المستخدم الشعور بالاطمئنان والأمان في تدخله في النقاش العام حول القضايا ذات الصلة بالخصوصيّة أو المتعلقة بالشأن العام، بل يمنحه الجرأة في التعبير عما يؤمن به أو يعتقد أنه صحيح من دون خوف، ما يقلص رقعة دوامة الصمت [16]التي نَظَّرت لها عالمة الاجتماع الألمانية إليزابيث نوال نيومان Elisabeth Noelle-Neumann.[17] لكنه يجلب في الوقت ذاته نوعًا من التوتّر والتّشنّج للاتصال. وربما يتلقى من يستعمل اسمًا مستعارًا أو يتقمص هويّة مزيّفة سوء المعاملة في الميديا الاجتماعية. إذا، كيف نتواصل مع شخص مجهول لا نملك أي خلفية عنه أو بيانات تسمح لنا بتحديد سياق التواصل معه؟ سؤال لم تجب عنه نظريات الاتصال حتى الآن. إنّه سؤال مهم جدًّا نظرًا إلى مسألتين: الأولى أن العلاقات الاجتماعية تبنى على التحكم في الهوية، بينما التواصل الرقمي يجري بين العديد من مستخدمي مواقع الشبكات الاجتماعية في ظل ما أصبح يعرف بــ”الهويّة السائلة” أو الهوية المتراكمة”. لقد اندهشت سيدة جزائرية أيّما اندهاش، وهي تتابع ما ينشره زوجها على صفحته في الفيسبوك، إلى درجة القول: تمنيت أن أكون زوجته! والثانية، تنبع من الاعتقاد بمحدودية الاتصال اللفظي في بلدان المغرب العربي. فالمغاربي يتحدث في الاتصال المباشر وجهًا لوجه، بجسده: بتعابير وجهه، وحركات يديه وكتفيه، وبنظراته أكثر، أكثر من لسانه؛ بمعنى أن منسوب” الحضور الاجتماعي” في هذا النمط من الاتصال مرتفع جدًّا ويتجلى من خلال التفاعل المباشر والفوري بلغة غير لفظيّة. ويكون هذا المنسوب ضعيفًا أو مغيّبًا في التواصل عبر الميديا الاجتماعية. ولا تتمكن “الرموز التعبيرية” Emoji من تعويضه، بل من المحتمل أن تعسره إن استخدمت بشكل سيئ كالنقر على أيقونة “أحب”، Like من باب التفاعل مع منشور يتضمن خبر وفاة! أو أُوّلَت تأويلًا خطأً.[18] ولا يمكن أن ندرك حجم المخاطر التي يحدثها ضعف أو انعدام الحضور الاجتماعي في المنصّة الرقميّة من دون الأخذ بعين الاعتبار الفقر الذي تحدثه في لغة التواصل، في بيئة مغاربية تعاني تشنّجًا لغويًّا يخفي في بعض الأحيان نزاعات دفينة، وهذا نتيجة اللجوء إلى استعمال حروف تختزل الكلمات، وكلمات متراصفة تعجز عن تشكيل جمل باللغة العربية الفصحى أو العامية أو الفرنسية أو الأمازيغية أو الهجينة التي تكتب بحروف لاتينية. ولا تتمكن أن تنوب عن غياب “التقارب في الاتصال” Communication Proxemics in.[19] أو تعوض غياب محدّدات التواصل والتفاعل عبر الميديا الاجتماعية، مثل محدّد سن المتصل، الذي يحظى بالتقدير والاعتبار في البيئة المغاربية، شأنها في ذلك شأن المجتمعات التي تسود فيها الثقافة الشفاهية أو تعيش ثقافة ما قبل الكتابة.
إذًا، إنّ التواصل عبر مواقع الشبكات الاجتماعية لا يفقد مكونات التواصل غير اللفظي في السياق المغاربي فحسب، بل يسهم في إفقار اللسان بشكل يختلف عما أحدثه في السياق الغربي. لقد أفرز في هذا السياق الأخير “شكلًا من التعبير لا هو حواري ولا جدلي، ولا هو شعر ولا نثر. إنّه جملة من التغريدات والتعقيبات والتعليقات التي تمثّل لغة ثالثة، إنها لغة ببغائية psittacic”.[20]
ربما ما سبق ذكره يبرز الجانب السلبي فقط لقاعدة “الكل يراقب الكل”. ويتجاهل أنها أتاحت أيضًا لمستخدمي الميديا الاجتماعية في بلدان المغرب العربي ممارسة الرقابة على مؤسسات الدولة لتشكل أداة ضغط على السلطة التنفيذية والقضائية. وقد كُلّلت في بعض الأحيان بإقالة بعض المسؤولين، أو إيقاف بثّ بعض البرامج والمسلسلات التلفزيونية.[21] وإن كانت هذه الميديا قد استعادت دور الرقابة الذي من المفروض أن تضطلع به وسائل الإعلام الكلاسيكية فإنّ خطورتها تكمن في أن المجموعات الفيسبوكية نصبت نفسها قضاة، بعد أن كانت تكتفي بدور الملاحظ، لتدفع الدولة إلى اتخاذ القرارات من باب كسب ود الفيسبوكيين وإرضائهم[22] أو انزلقت لتقوم بدور حراسة الأخلاق لتصادر الابداع الأدبي والفني. وهذا في ظلّ غياب منابر للنقاش الحر والتداول. فــ” موجات السخط التي تجتاح العالم الرقمي تعمل على حشد الانتباه وتكثيفه بسرعة شديدة؛ لكن سيولتها وعدم استقرارها يجعلانها غير مناسبة لتشكيل خطاب أو فضاء عمومي”. [23]
2- التحدي الثاني: التوفيق بين النزعة النّرجسيّة والروح الجماعيّة.
يمكن تفسير التوتر في العلاقات الاجتماعية، الذي أحدثته الميديا الاجتماعية في بلدان المغرب العربي، بالتصادم بين متغيرين: يكمن الأول في طبيعة هذه الميديا، التي تفترض تنظيمًا اجتماعيًّا شبكيًّا ذا منحى أفقي يشجع التعبير عن الذات، بل الإفراط في النرجسية والأنانية، بدلًا من أن يشعر المستخدم بالحزن أو الكآبة، إن لم تلق منشوراته في الميديا الاجتماعية صدى يليق بها: الإعجاب والاستحسان. فيما يكمن المتغير الثاني في طبيعة العلاقات الاجتماعية في البلدان المغاربية التي تستند إلى التنظيم الاجتماعي الهرمي الذي تعود مرجعية السلوك فيه إلى القبيلة، والجماعة، والعائلة الممتدة. فحتى الأحزاب السياسية في هذه البلدان استنسخت تنظيم “الزوايا أو التكايا” التي تسري فيها ثقافة العرفان “شيخ الطريقة الصوفيّة ومريديه” بحسب قول عالم الأنثروبولوجيا المغربي، عبدالله حمودي[24]. فرأي الفرد ومواقفه من رأي الجماعة التي ينتمي إليها أو يتصورها، بل لا وجود له دونها، بدليل أن المتحدث في هذه البلدان يتحاشى قول: “أنا”، وإنْ قالها، فإنه يضيف إليها: “أعوذ بالله من كلمة أنا”، وذلك خلافًا للمجتمعات الغربية التي يمتلك فيها الفرد حريته النسبية لإبداء رأيه والتعبير عن اختلافه عن الجماعة.
قد تلجأ الأسر الفقيرة والمتوسطة في المجتمعات المغاربية، التي ترزح تحت ثقل المظاهر، إلى حشر أفرادها للعيش في غرفة واحدة أو غرفتين، وتترك الصالون نظيفًا ومرتبًا للضيوف؛ حتّى يكوّنوا انطباعًا جيدًا عن الأسرة ومستوى معيشتها. ولا يتورع فيها الأثرياء الجدّد عن إظهار كل ما يكشف عن ثرائهم، لا لشيء سوى للفت النظر إليهم، وتغيير انطباع الغير عنهم. هذه الغاية لا يسعى إليها الأشخاص فقط، الذين يصرّون على تصويرهم وهم يصلون، أو يؤدون مناسك الحج والعمرة، بل تشمل حتى الأحزاب وهيئات المجتمع المدني؛ إذ يذكر أحد الصحفيين أنه سأل مسؤول إحدى الجمعيات الخيرية: لماذا اختار الحي الراقي في إحدى المدن الجزائرية لتوزيع الكمامات في أثناء جائحة كوفيد-19، وترك الأحياء الفقيرة التي لا يستطيع قاطنوها شراء هذه الكمامات، فكانت إجابته صادمة: إن هذا الحي مغطى بشبكة الإنترنت تغطية جيّدة تسمح لجمعيتنا بتسجيل عملنا الخيري، ونقله مباشرة عبر الميديا الاجتماعية!
إن العيش تحت نظر ومراقبة الغير يدفع المرء في بلدان المغرب العربي إلى الحذر، والتظاهر، والادعاء، وحتّى الكذب في بعض الأحيان، فالكذب يصبح مطلوبًا ومبرّرًا في مواقع الشبكات الاجتماعية، وفق ما ذهبت إليه لورل أندرسن Laurel Anderson ودبورا برون مككبDeborah Brown McCabe[25].
ففي بلدان المغرب العربي، لا غرو أنْ سردَ الكثير من مستخدمي موقع “الفيس بوك” أو “الإنستغرام” ذواتهم باستعراض رخاء نمط معيشتهم، وما حقّقوه من نجاح، سواء كان هذا الأمر فعليًّا أو مفتعلًا؛ أي أن ما قيل أو صُوّر من باب التباهي والافتخار. وقد يجرّ هذا الاستعراض أعدادًا كبيرة ممن يعانون شظف العيش؛ نتيجة البطالة، وأزمة السكن والمواصلات والإخفاق في التعليم، إلى المقارنة بين ما يعيشونه يوميًّا من حرمان وبين حياة غيرهم كما يسردونها في المواقع المذكورة؛ فيزداد إحباطهم ويأسهم وحتى حقدهم عليهم، وهذا ليس عن وعي بعدم المساواة في توزيع الدخل في المجتمع، بل لاعتقادهم بأن النجاح والثراء لا يكونان دائمًا نتيجة الكدّ والعمل في ظلّ نظام تغيب فيه المساواة في فرص العمل والنجاح تحت سقف واحد من المنافسة الشريفة والشفافة. فالثراء والنجاح، في نظرهم، يأتيان عن طريق المحسوبية والكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ. ويزداد هذا الإحباط إنْ اكتنفه التعسف في استعمال السلطة ضدهم. وقد يمثّل هذا الإحباط مدخلًا لفهم العنف اللفظي والكراهية والعنصرية التي تتسم بها المنشورات والتعليقات في مواقع الميديا الاجتماعية، فضلًا عن أن هذه المواقع، مثل الفيسبوك، تبدو كفضاء من الانسجام والمجاملات؛ لأن الصداقة تسود الجميع، لكنها تخفي توترات مكظومة تنفجر في أي لحظة في شكل شجب واستنكار وقدح في العِرض، أو تثريب أو تخوين واتهام بالعمالة، وحتى بالكفر بمجرد أن يعبّر مستخدم الفيسبوك مثلًا عن وجهة نظر مغايرة في موضوعات مختلفة، مثل أصل سكان بلدان المغرب العربي، واللغة، وتاريخ المنطقة القديم والحديث، والحدود الجغرافية الموروثة عن الاستعمار، والمِلل والنِّحل في الحضارة العربية الإسلامية، وحقوق المرأة، ومفهوم الحداثة. وقد يتعداه هذا الاتهام ليشمل العائلة والقبيلة والمنطقة وحتّى البلد!
3– التحدي الثالث: الواقع وما بعد الحقيقة
تشترك العديد من البحوث الأجنبية في تأكيد أن أكبر تحدٍّ تطرحه الميديا الاجتماعية على السلطات العمومية وعلى الشعوب يتمثل في الأخبار المزيّفة[26]. فعلى الرغم من أن وجود هذه الأخبار قد سبق ظهور الميديا الاجتماعية، فإنها ازدادت انتشارًا عبرها. ولا يمكن اختزال خطورة هذه الأخبار في كونها خاطئة عن قصد مبيّت، وملفقة، ومضلّلة أو مجزأة، وذلك لكونها توحي بتقديم معرفة عن الأحداث والمواقف والتصريحات والأشخاص، وهي بعيدة عن كل معرفة[27].
اكتسبت الأخبار المزيّفة مشروعيّة الاستخدام في الخطاب الصحفي والعلمي بعد انتشار المثلث المفاهيمي التالي: الأحداث البديلة Alternative facts””، و”إعادة الإعلام” Reinformation”“، و”ما بعد الحقيقة” Post-Truth . فالمفهوم الأول نحته سين سبسر، الناطق الرسمي السابق باسم البيت الأبيض الأمريكي، لتبرير المواقف السياسية للإدارة الأمريكية بالقول إنه يمكن للمرء ألا يتفق مع الأحداث في بعض الأحيان. وقد انتقدت الصحافة الأمريكية هذا المفهوم، ورأت فيه استراتيجية لإضعاف وسائل الإعلام، باعتبارها سلطة مضادة، ويشكل مصدر قلق على مستقبل الديمقراطية.[28] وظهر المفهوم الثاني في الأوساط اليمينية المتطرفة، ولا يُقصد به التنكر للأحداث أو نفيها، مثلما يفعل المفهوم الأول، بل يعمل على إحداث انقلاب في القيم، وتقديم قراءة مغايرة للأحداث عن تلك التي تسوقها وسائل الإعلام المهيمنة. وبهذا، يعدّ هذا المفهوم نوعًا من “التضليل الحاذق”.[29] أما مفهوم “ما بعد الحقيقة”، فيقصد به” الظروف التي يكون فيها للوقائع الموضوعية تأثير على تشكيل الرأي العام أقل من العواطف والمعتقدات الشخصيّة”[30].
وهناك العديد من العوامل التي ساعدت الميديا الاجتماعية على نشر الأخبار المزيّفة، بعضها كامن في طبيعة هذه الميديا ذاتها، وذلك لكونها تعتمد أساسًا على ما ينشره أو يبثّه مستخدموها، والذي يجسد حالة من العدوى: ينشر أحد المستخدمين خبرًا في موقع من مواقع الشبكات الاجتماعية، وليكن موقع الفيسبوك، فينقله عنه أصدقاؤه، ومعارفه الذين يوزعونه بدورهم على غيرهم، وهكذا تتسع دائرة انتشاره. ويعود بعضها الآخر للتأثير الذي أحدثته الميديا الاجتماعية في عالم الصحافة. ففي السابق، كانت وسائل الإعلام لا تنشر الأخبار إلا إذا تأكدت من صحتها، وكانت واثقة بمصادرها. أما اليوم، فإنها تحاول أن تحذو حذو مواقع الشبكات الاجتماعية من باب منافستها: تنشر الخبر أولًا، ثمّ تتأكد من مصداقيته، أو تتملص من مسؤولية التحري عن مصداقيته، تاركةً الحرية للمستخدم: يصدق الخبر أو لا يصدقه؛ وذلك بغية الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور؛ من أجل رفع عائدها من الإعلان.
وهناك عوامل مرتبطة بالمستخدم، ومعاناته مع متلازمة الإنهاك المعلوماتي، التي صاغها عالم النفس البريطاني ديفيد لويس، ويقصد بها حالة الإجهاد، وعدم التركيز في سيل من المعلومات والأخبار المتدفقة الذي يضعف قدرته على تحليلها ومحْصها. فالوقت الطويل، الذي يقضيه المرء في متابعة ما هو غير مفيد، يجعل هذا الأخير مفيدًا[31]، فتضيع منه الأخبار التي تتطلب قدرًا من التفكير والتأمل لأهميتها. إن قدرة المرء على الانتباه محدودة، لكن الأخبار التي تثير عاطفته وتخاطب أحاسيسه تستأثر باهتمامه أكثر؛ أي تدفعه لتبنّي منطق “ما بعد الحقيقة”، فضلًا عن أن تعتيم وسائل الإعلام الرسميّة على بعض الأحداث والقضايا يفتح المجال لانتشار الأخبار الملفقة عبر الميديا الاجتماعية.
خلافًا للاتجاه السائد لدى بعض النخب السياسية في البلدان الغربية، الذي حوَّل الكثير من الوقائع والمعطيات إلى وجهة نظر، بما فيها العلمية، مثل اللقاح ضد جائحة كوفيد-19، والاحتباس الحراري، يعتقد الكثير من أبناء بلدان المغرب العربي أن وجهات النظر هي حقائق ومعطيات موضوعية؛ أي أنهم لا يستطيعون التّمييز بين الحدث Fact والرأي Opinion. وقد تتحمل وسائل الإعلام القسط الأكبر من المسؤولية في ذلك؛ فصوغ الأخبار في هذه البلدان لا يفصل بوضوح الرأي عن الوقائع. وقد استشرى هذا الأمر في الأخبار المتداولة في مواقع الشبكات الاجتماعية بشكل مُعدٍ. وجلّ الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام في هذه البلدان تُسند إلى مصدر واحد ووحيد، هو في الغالب مصدر رسمي، وقد تُنشر خاليةً من أي مصدر، وبهذا تقترب من الشائعة. ولا تشذ الأخبار المتداولة في مواقع الشبكات الاجتماعية عن القاعدة. ويكمن الاختلاف في أن مستخدميها لم يتعودوا على السؤال عن مصدر الخبر قصدَ التحري في صحّته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى؛ لأن نسبة تصديق هذه الأخبار في مواقع الشبكات الاجتماعية تكون في الغالب مرتفعة، وذلك لسببين: الأول، أن عدد متابعيها قد يتجاوز الآلاف، بل أكثر من مليون في بعض الأحيان. وبهذا، أضحى الحكم على مصداقية الخبر يقاس بعدد متابعيه، وليس بمصادره ونوعيتها. ثانيًا، إن مروجي هذه الأخبار في هذه المواقع أشخاص معروفون: أهل، وأصدقاء، وزملاء، ومعارف يحظون بثقة المستخدمين. إن كل هذه العوامل تعزّز حضور الأخبار المزيّفة في حياة أبناء المغرب العربي.
تبدو وسائل الإعلام الرسمية في بلدان المغرب العربي منشغلة بالتبليغ عن نشاطات الدولة ومؤسساتها ومسؤوليها، وهذا على حساب المجتمع. إنها لا تُظْهِر أبناءه على ما هم عليه، بل على ما يجب أن يكونوا عليه، أي انطلاقًا من تصور الخطاب الرسمي لهم؛ لذا تراجعت الثقة بها. وهذا ما يثبته المثال الآتي: على الرغم من تأكيد وسائل الإعلام التونسيّة المختلفة أن الشرطية، فايدة حمدي، لم تصفع محمد البوعزيزي، الذي أضرم النار في جسده لتنطلق شرارة الأحداث في تونس يوم 17 ديسمبر 2010، كما أثبتت المحكمة ذلك[32]، فإن أحدًا لم يصدقها. فالمدمن على تجنب قول الحقيقة لا يجد من يصدقه عندما ينطق بها.
أمام تراجع الثقة بوسائل الإعلام الرسميّة، انفتحت الأبواب أمام مستخدمي الميديا الاجتماعية لممارسة “إعادة الإعلام”؛ أي تأويل الأخبار انطلاقًا من منطقهم، وتقييمها بشكل يختلف عن الخطاب الرسمي، بل يعارضه، ربما بشكل غريب.
التحدي الرابع: الاستقطاب السياسي والأيديولوجي والعيش المشترك
تلتقي الكثير من البحوث الأجنبية [33]في تأكيدها أن مواقع الشبكات الاجتماعية تعزّز ظاهرة الاستقطاب في صفوف مستخدميها، التي يصعب فهمها من دون تفكيك مفهومين أساسيين، هما: “فقاعة الغربلة”، و”غرفة الصدى”. فالمفهوم الأول يعبر عن العُدّة التي تشخصن المحتويات المتداولة في شبكة الإنترنت، وتعمل على عزل “الإنترنتيّين” ثقافيًّا، وانغلاقهم على ذواتهم؛ ما يحدّ من إمكانية تغيير رؤيتهم أو موقفهم، ويقلص مجال تنوع الأخبار والمعلومات التي يتعرضون لها[34]، ويفتح المجال لتداول القصص العاطفية وانتشارها، وتلك التي تستثير المشاعر القويّة: القلق، والخوف، والغضب، والفرح. أما المفهوم الآخر، فقد استُعمل من باب الاستعارة للإشارة إلى أن مواقع الشبكات الاجتماعية تشبه إلى حد بعيد القاعة التي تُرجع صدى أصواتنا؛ أي أننا لا نسمع فيها إلا صوتنا. ويُحمّل الكثير من الباحثين خوارزميات مواقع الشبكات مسؤولية وجود الفقاعات المذكورة، فيما يشكك بعضهم في هذا الأمر؛ لاعتقادهم أن هذا التحميل يبسّط جدًّا ظاهرة الاستقطاب السياسيّ المعقدة في المجتمع، ويدعون إلى ضرورة الفهم الدقيق لسلوك الأشخاص في تفاعلهم مع الميديا.[35] بالفعل، إن ظاهرة الاستقطاب الأيديولوجيّ والسياسيّ ظاهرة مركبة في المجتمع. والمرء، خاصة في بلدان المغرب العربي، مبرمج على الاستقطاب الناتج عن عملية التنشئة التي تشارك فيها العديد من المؤسسات الاجتماعية والسياسية والثقافية. فعلى الرغم من أن الكثير من المؤسسات الإعلامية، خاصة الصحافة التي تدّعي في هذه البلدان أنها موجهة لكلّ أبناء المجتمع، فإنها تسعى عمليًّا إلى إسماع صوت الطيف الأيديولوجي والسياسي الذي تنتمي إليه أو يمولها، وتُقصي غيره من الأصوات عملًا بمقولة: “من ليس معنا فهو ضدنا”. لذا، نلاحظ تراجع التعليقات والتعقيبات على المواد الإعلامية التي تنشرها الصحف في موقعها في شبكة الإنترنت، بل نلاحظ كذلك اختفاءها نهائيًّا؛ لأنها حادت عما ترسمه لها التوصية التالية: “إن لم تؤيد ما تضمنته هذه المواد الإعلامية، فأنت بالضرورة معارض”.
إنّ النقاش حول “فقاعة الغربلة” يجب ألا يخفي الدور المحوري للهموفيلياhomophily في إحداث الاستقطاب الأيديولوجي والسياسي. ويُقصد بالهموفيليا ذلك “الاتجاه الذي يدفع إلى تفضيل إقامة علاقات مع الأشخاص الذين يشبهوننا”. إنّها مؤشر إلى تكتل داخل البنى الاجتماعية[36]، وتترجم عمليًّا في موقع الشبكات الاجتماعية بالميل إلى مصادقة مَن نتفق معهم في الرؤى والتصورات، ويجمعنا بهم قاسم مشترك أو أكثر، تمثله اللغة، أو الدين، أو الهوية، أو الهواية، أو الانتماء إلى منطقة معينة، فنشاطرهم الأخبار والمنشورات. وتتسم ظاهرة الاستقطاب السياسي والأيديولوجي بالطابع الديناميكي؛ نتيجة تزايد عدد المنشورات والصور والفيديوهات التي تغذّي هذا القاسم المشترك وتعزّزه.
بالفعل، إن الاستقطاب الأيديولوجي والسياسي ظاهرة موجودة قبل وجود مواقع الميديا الاجتماعية، وهو نتاج مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية، ويعبر عن إرادة الفرد واختياراته، لكن خوارزميات مواقع هذه الميديا تعزّز اصطفاف هذه الاختيارات وتنميها، بل تعمل على تضخيم هذه الظاهرة. فيكفي أن تكون جماعة صغيرة ناشطة في أحد مواقع هذه الميديا، وتداوم على نشر محتوياتها المكرّرة بإيقاع منتظم خلال فترة ممتدة، لتوحي بأنّها أكثر عددًا وأوسع انتشارًا.
وبعيدًا عن الفكر المؤامراتي، الذي يؤمن بالقوى التي تعمل في الخفاء على تنشيط الاستقطاب في الميديا الاجتماعية لتغذية النزعات وزرع الفرقة، يمكن تشخيص مخاطر هذا الاستقطاب في سياق بلدان المغرب العربي فيما يأتي:
أ-الكثير من الأشخاص لم يسبق لهم الاهتمام بالأخبار السياسية ذات العلاقة بالشأن العام إلا من خلال الميديا الاجتماعية، وعبر منشورات أصدقائهم وزملائهم ومعارفهم ذوي الخبرة في النشاط السياسي، فيقعون تحت تأثيرهم ويشاطرونهم الأفكار ذاتها، ويصبحون من أتباعهم.
ب-أمام انغلاق الحياة السياسية، وتفريغ الفعل السياسي المؤسساتي من مضمونه، والقضاء على استقلالية هيئات المجتمع المدني، وتحريف نشاطها، لم يجد الكثير من المواطنين من ملاذ سوى الميديا الاجتماعية التي تستقطبهم. فالاستقطاب في هذه الحالة لا يرمي إلى تجسيد حرية التعبير فقط، بل يمنح أيضًا الفرصة لهم لتبني اقتناعات معينة، وتجديد الانتماء إلى فكر معين وجماعة معينة، وتقديم الولاء لروادها في الميديا الاجتماعية.
ج-إن وجود منابر عديدة في البلدان الغربية، التي تسمح بالنقاش الحر والحوار في شتى الموضوعات، بهذا القدر أو ذاك، يقلّل من أضرار الاستقطاب السياسي والأيديولوجي، برغم تحذيرات الباحثين في حقل العلوم الاجتماعية والسياسيين من مخاطره على الحياة الديمقراطية، لكن أضراره في بلدان المغرب العربي لم تقيّم بعد. فغنيّ عن القول إن الاستقطاب لا ينفي الحوار الذي يُعد شرطًا من شروط الوجود الاجتماعي فحسب، بل يشجع السجال Polemic، الذي يعدّ لغة ناجعة للانقضاض على الخصم، فيتعامل معه كعدو وليس غريمًا يجب إقناعه بالحجة والبراهين، بل يجب سحقه بشتى السبل: الشتم والقدح والقذف والنيل من شرفه وشرف أهله. فالسجال لا يؤمن بالاختلاف الذي يشكل قاعدة العيش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد.
د. تتسم الميديا الاجتماعية بخاصية الحظر، فالكثير من مستخدميها في بلدان المغرب العربي، والجزائر تحديدًا، يتباهون بأنهم مارسوا الحظر على مَن علّقوا على منشوراتهم بأفكار لم تنل إعجابهم أو تتعارض مع ما يعتقدون أنه جادة الصواب، أو أنهم طهّروا قائمة أصدقائهم الافتراضيين، وألغوا صداقة الذين لا ينسجمون مع آرائهم. إن سهولة استخدام هذا الحظر في العالم الافتراضي قد تتحول إلى ممارسة في الحياة اليومية، وفي الواقع العيني، لتصبح سلوكًا عدوانيًّا يشنّج العلاقات الاجتماعية، ويُضعف قدرات المجتمع على التفاوض، بل يلغيها. فالكثير من النزاعات والخلافات كادت تستفحل وتتحول إلى معضلة لولا التفاوض والوساطة اللذان استطاعا أن يقضيا عليها؛ لذا ليس غريبًا أن ترى شجارًا تُستعمل فيه قوّة العضلات بين أنصار فريقَي ريال مدريد وبرشلونة، وهم يتابعون المباراة التي تجمع هذين الفريقين في مقهى بإحدى مدن البلدان المغاربية بمجرد التفوه بتعليق أزعج أنصار الفريق المنهزم. هذا مثال بسيط على تداعيات الاستقطاب، الذي يمكن أن تنفخ فيه الميديا الاجتماعية، على التعايش مع الاختلاف، والوئام الاجتماعي؛ ما يكشف عن وهم الانفتاح والتفاهم والتسامح الذي يبشر به أيديولوجيو الإنترنت والميديا الاجتماعية. فتجارب التاريخ المعاصر تؤكد أن شبكة الإنترنت والميديا الاجتماعية لم تستطيعا أن تغيرا جوهر الأنظمة السياسية حتّى في بلدان أوروبا الشرقية، التي عاشت ثورة مخمليّة في انتقالها نحو الليبرالية. فالأنظمة استطاعت أن تتحكم في الحركات الاجتماعية في الميديا وعبرها، مثلما يؤكد ذلك الباحث إيفجني مروزوف.[37] فأمام زوال الوهم في الطاقة الثورية للميديا الاجتماعية، لم يبق أمام أبناء المغرب العربي سوى ممارسة ما يسميه عالم الاجتماع، آصف بيات، “اللاحركات الاجتماعية”[38]، التي يقول عنها إنّها تعمّق سياسات الشارع، الذي لم يعد فضاءً لتنظيم مظاهر الاحتجاج، بل ساحة يعيد المهمشون وطبقات الدنيا من الناس إنتاج حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها في نزاع وتحدٍّ للسلطات العمومية، ويشكلون فيها هوايتهم الجماعية، ويوسعون دائرة تضامنهم خارج إطار العائلة.
خاتمة: أظهر التحليل أن وسائط التواصل الاجتماعي في بلدان المغرب العربي قد تجاوزت دورها التقليدي كأدوات ترفيهية لتصبح ساحة مركزية للفعل السياسي غير الرسمي، وفضاءً موازيًا للخطاب المؤسسي، خصوصًا لدى الفئات الشبابية والمهمّشة. وبرغم ما أتاحته هذه الوسائط من فرص جديدة لتوسيع المجال العمومي، وتعزيز أشكال التعبير والمساءلة، فإنها طرحت في المقابل تحديات عميقة تتعلق بموثوقية الخطاب الرقمي، وانفجار الأخبار المزيّفة، وارتفاع وتيرة الاستقطاب الأيديولوجي؛ ما جعل من الفعل السياسي الرقمي فعلًا هشًّا، تحكمه في كثير من الأحيان خوارزميات الانكفاء والانغلاق داخل “فقاعات الغربلة” و”غرف الصدى”.
كما بيّن المقال أن هذه الوسائط، وإنْ مكّنت من تسريع عمليات التجنيد السياسي والمشاركة اللحظية، فإنها لم تنجح بعد في تأسيس فعل ديمقراطي متماسك طويل المدى، بل كشفت في أحيان كثيرة عن أزمة التعبير والتمثيل في السياق المغاربي؛ ما يوجب على الباحثين صوغ أدوات تحليلية جديدة تضع في الحسبان البعد الأنثروبولوجي للاتصال، ومحدودية الترجمة الرقمية للقيم الثقافية والسياسية في مجتمعات ذات طابع شفهي وجمعي.
في ضوء ما تقدم، تبرز الحاجة الملحّة إلى مقاربات متعددة الاختصاصات؛ لفهم التحولات الجارية في المشهد الإعلامي والسياسي المغاربي؛ خصوصًا في ظل تصاعد دور الفاعلين غير التقليديين في توجيه النقاش العام، واحتدام الجدل حول الحرية، والرقابة، وشرعية التمثيل في الفضاءات الرقمية.
المراجع:
[1] – بحسب إحصائيات يناير 2025 – انظر:
https://fr.statista.com/statistiques/570641/taux-de-penetration-dinternet-dans-le-monde-par-region
[2] . المرجع السابق
[3] Simon Kemp: Digital 2025: Algeria, 3 March 2025
https://datareportal.com/reports/digital-2025-algeria
Simon Kemp: Digital 2025: Morocco, 3 March2025
https://datareportal.com/reports/digital-2025-morocco
Simon Kemp: Digital 2025: Tunisia, 3 March2025.https://datareportal.com/reports/digital-2025-tunisia
Simon Kemp: Digital 2025: Algeria, 3 March 2025.https://datareportal.com/reports/digital-2025-algeria
Simon Kemp: Digital 2025: Morocco, 3 March2025.https://datareportal.com/reports/digital-2025-morocco
Simon Kemp: Digital 2025: Tunisia, 3 March2025.https://datareportal.com/reports/digital-2025-tunisia
[4] – بي بي سي عربي: برلمان المغرب يناقش حظر منصة تيك توك.. فما الأسباب؟ يناير/ 2024. https://www.bbc.com/arabic/tv-and-radio-67876534
[5] – Simon Kemp: Digital 2025: Algeria, op cité
[6] -Damian Radcliffe, social media trends in the Middle East — 20 must know statistics, Mar 15, 2021. https://medium.com/damian-radcliffe/social-media-trends-in-the-middle-east-20-must-know-statistics-from-2020-388a63597f35
[7] – Idem
[8] – انظر على سبيل المثال:
– Mokhtar BEN HENDA: Médias sociaux et liberté d’expression au fil du printemps arabe in Yves Théorêt et Philippe Viallon ( sous dir) : Facebook comme agora des extrêmes in La liberté d’expression à l’ère numérique De l’infox à l’intelligence artificielle, les éditions de l’immatériel , France, 2020, p 95-123
Bouziane Zaid : Internet and democracy in Morocco: A force for change and an instrument for repression, Global Media and Communication, · January 2016, p 1-18. DOI: 10.1177/1742766515626826
[9] – انظر على سبيل المثال:
Hassan ATIFI, Zeineb TOUATI : Nouvelles revendications féministes et médias numériques. Contournement des interdits sociaux et religieux en Tunisie et Maroc, ESSACHESS. Journal for Communication Studies , vol. 13, no 1(25)/ 2020 : 179-208
[10] – انظر على سبيل المثال:
Évelyne Barthou : La migration sans rupture. Le rôle des réseaux sociaux numériques dans la construction identitaire de jeunes migrants marocains. Revue Socio-anthropologie, Vol N40, N01, 2019 ; pp163-179. https://doi.org/10.4000/socio-anthropologie.6163
[11] – انظر على سبيل المثال:
– Ethan Zuckerman, The First Twitter Revolution? January 14, 2011
https://foreignpolicy.com/2011/01/14/the-first-twitter-revolution/
– Ahmad M. Shehabat :Arab 2.0 Revolutions: Investigating Social Media Networks during waves of the Egyptian political uprisings occurred in 2011, 2012 and 2013. Master- Humanities and Communication Arts, University of Western Sydney, 2013
-Marie Bénilde La révolution arabe, fille de l’Internet ?15 février 2011
http://blog.mondediplo.net/2011-02-15-La-revolution-arabe-fille-de-l-Internet
-Gilad Lotan and all The Revolutions Were Tweeted: Information Flows During the 2011 Tunisian and Egyptian Revolutions, International Journal of Communication 5 (2011), p 1375- 1405
– Tourya Guaaybess : Blogs, réseaux sociaux et « révolutions arabes » : du fantasme à la réalité, in Arnaud Mercier- La communication politique, CNRS Éditions, 2017, p. 203-222
[12] . reuters.comAP Newstheguardian.comefe.comnewyorker.com.
[13] – مصطلح مركب من كلمتين: slacker الكسول، والنشاط activism، ويقصد به المساندة للقضايا السياسية والإنسانية والمطالب النقابية عبر مواقع الميديا الاجتماعية، من خلال النقر على أيقونة أحب، أو إعادة توزيع عريضة المطالب، أو إضافة الاسم إلى قائمة الموقعين عليها، إلخ
[14] – Nick Couldry (2015) The myth of ‘us’: digital networks, political change and the production of collectivity, Information, Communication & Society, 18:6, 608-626, DOI: 10.1080/1369118X.2014.979216
[15] – جان مارك فيري، ترجمة وتقديم عمر مهيبل، الدار العربية للعلوم، منشورات الاختلاف، 2006، ص 9
[16] – Greg Goldberg Antisocial media: Digital dystopianism as a normative project, new media & society 2016, Vol. 18(5) 784 –799 © DOI: 10.1177/1461444814547165
[17] – صاغت هذه النظرية في أطروحتها الجامعية في 1974 انطلاقًا من ملاحظتها على سلوك مواطنيها الذين يلتزمون الصمت ولا يعبرون على آرائهم المعارضة خوفًا من العزلة في وسطهم الاجتماعي.
[18] – انظر على سبيل المثال:
Daantje Derks, Arjan E. R. Bos, Jإعادةasper von Grumbkow: Emoticons and Online Message Interpretation, Social Science Computer Review, Vol 26 N0 3, August 2008, pp379-388 doi:10.1177/0894439307311611
[19]– يقصد به الباحث الأمريكي إدوارد هول في مجال الأنثربولوجيا، في كتابه الاتصال الصامت، بأنه ضرب من الاتصال غير اللفظي يتخذ فيه الحيز المكاني أهمية حاسمة. فعلى الرغم من أن تقدير المسافة بين المتصلين يجري بمقياس موحد في كل البلدان إلا أن إدراكها تصقله الثقافات المختلفة. وقد ترجم هذا الإدراك في المجتمع الأمريكي، على النحو التالي: اتصال حميمي ما بين 15-45 سنتيمترًا، واتصال ما بين الأشخاص ما بين 45 سنتميترًا – 1.20 متر، والاتصال الاجتماعي، ما بين 1.20 -3.5 أمتار والاتصال العام، أزيد من 3.5 أمتار.
Virginie Graziani : La proxémie : l’espace dans le non verbal, Apostrof, https://urls.fr/m5cjEE
[20] – Matthew: ‘Free Speech’ is Harming Society: What is the Answer? Medium Revue, 6/1/2025, https://medium.com/free-factor/free-speech-is-harming-society-what-is-the-answer-178f79f7dec9
[21] – يمكن أن نذكر على سبيل المثال الصور التي تداولها الفيسبوكيون عن تجفيف أرضية ملعب الرباط الذي غمرته المياه بوسائل بدائية في مارس 2018، التي أدى انتشارها إلى إقالة وزير الرياضة، وإقالة والي محافظة المسيلة بعد إدانة نشطاء الفيسبوك لتقاعس السلطات العمومية عن إنقاذ حياة شاب سقط في بئر ارتوازي في 19 يناير 2019. وقد لفتت سلطة ضبط السمعي-البصري في الجزائر نظر بعض القنوات التلفزيونية بعد أن أثارت استنكار نشطاء الفيسبوك كبعض البرامج، مثل “خط أحمر” “وما وراء الجدران” أو المسلسلات التلفزيونية التي تبثها، مثل مسلسل “الدامة”.
[22] – انظر على سبيل المثال: هدى طرابلسي: محاكمات شعبية على “فيسبوك” تؤثر في القرار الرسمي بتونس، إندبندنت عربية، السبت 19 فبراير 2022
[23] – بيونغ- شول هان: من داخل السرب، ترجمة بدر الدين مصطفى، آفاق رقمية، دار معنى للنشر والتوزيع،2021، ص2
[24] – انظر عبدالله حمودي: الشيخ والمريد، ترجمة: عبدالمجيد جحفة، دار طوبقال للنشر، الطبعة الرابعة، 2010.
[25] – ترى هاتان الباحثتان أن الكذب معيار مقبول في الميديا الاجتماعية، فالمراهقون ينشرون معلومات كاذبة عن سنهم، وعن جنسهم -ذكورًا أو إناثًا- وعن مظهرهم الفيزيائي وغير ذلك. فالكذب يغدو سلاحًا للحفاظ على الهوية المجهولة، والسلوك الذي يعبرون عنه في هذه الميديا يختلف عن سلوكهم في يومياتهم. ففي الفضاء الافتراضي، يكونون أكثر فظاظة وعنفًا.
Anderson, L., & Brown McCabe, D.: A Co -constructed World: Adolescent Self- Socialization on the Internet. Journal of Public Policy & Marketing, Vol 31, N02, 2012, pp240-253. doi:10.1509/jppm.08.043
[26] – انظر على سبيل المثال الدراسة التحليلية للبحوث عن الأخبار المزيّفة والتضليل في الميديا الاجتماعية، التي شملت الفترة الممتدة من 2009 إلى 2019:
Esma Aïmeur, Sabrine Amri, Gilles Brassard: Fake news, disinformation and misinformation in social media: a review. Social Network Analysis and Mining Revue, Vol 13, N30, February 2023 https://doi.org/10.1007/s13278-023-01028-5
[27] – Neil Postman Amusing Ourselves to Death ; public discourses in the show business; penguin books; 2006, p83
[28] – William Audureau: Faits alternatifs, fake news, post-vérité… petit lexique de la crise de l’information, Le Monde 25.01.2017
[29] – Stéphanie Lukasik, Alexandra Salou. Actes de colloque. Enjeux communicationnels de la désinformation. Nouvelles formes- nouveaux défis. Quand la réinformation reconfigure les pratiques journalistiques. Une analyse comparative de trois pays francophones. Académie des controverses et de la communication sensible, 2024. urlr.me/sQanSA
[30] – Lee C. McIntyre Post-truth Massachusetts Institute of Technology; 2018, p4
[31] – بيونغ- شول هان، مرجع سابق، ص 84.
[32] – د.ب.أ: تبرئة الشرطية المتهمة بصفع “مفجّر الثورة التونسية“ صحيفة الإمارات اليوم، 20 أبريل 2011.
[33] – انظر على سبيل المثال:
Joshua Tucker and All: Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature, SSRN Electronic Journal, January 2018, DOI: 10.2139/ssrn.3144139
[34] – Eli Pariser, quoted by Aurélien Brest: Bulles de filtre et chambres d’écho, fondation Descartes, https://www.fondationdescartes.org/wp-content/uploads/2020/07/Synthese-Bulles-Filtre-Chambres-decho-Fondation-Descartes.pdf
[35] – انظر على سبيل المثال:
Axel Bruns: It’s not the technology, stupid: “How the ‘Echo Chamber’ and ‘Filter Bubble’ metaphors have failed us.” In International Association for Media and Communication Research, 2019- 07-07. https://snurb.info/files/2019/It%E2%80%99s%20Not%20the%20Technology,%20Stupid.pdf
[36] – Claire Bidart: «Étudier les réseaux. Apports et perspectives pour les sciences sociales », Informations sociales, 2008/3 (n° 147), p. 34-45
[37] – انظر على سبيل المثال:
-Evgeny Morozov: Net Delusion, The Dark Side of Internet Freedom, PublicAffairs, 2011, 409 pages
[38] – آصف بيات: ثورة بدون ثوار: كيف نفهم الربيع العربي، ترجمة: فكتور سحاب، مركز دراسات الوحدة العربية، 2022 ص 152-153.